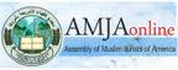بحث مقدم إلى مجمع فقهاء الشريعة عام 1436 هـ 2015 م
المحتوى
المطلب الأول: ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات.. 5
1- إن كان الواقف غير جائز التصرف أو تعلق بالموقوف حق للغير أو كان مشاعًا غير مفرز ولا قابل للقسمة. 6
2- إن كان الموقوف مستأجرًا غير مملوك فهل يصح وقفه مسجدًا؟. 6
4. إن كانت الأرض فضاءً أو لم يكن بناء يقي الناس من الحر والبرد، فهل تعطى أحكام المسجد بوقفها 11
5. إن كان ثم بناية تحت المكان الموقوف مسجدًا أو فوقه. 13
6. إن كانت للمسجد مرافق متصلة ببنائه أو منفصلة عنه فهل لها أحكامه 15
الفرع الثاني: الفرق بين المصلى والمسجد؟ وهل لهذا الفرق أثر من الناحية العملية ؟. 20
فائدة: هل المسجدية شرط لصحة الجمعة؟. 21
فائدة: هل المسجدية شرط لصحة الاعتكاف؟. 21
المطلب الثاني: إبدال المساجد 23
الحالة الأولى: المساجد التي خربت وتعطلت منافعها 23
الحالة الثانية: المساجد التي لم تتعطل منافعها 25
المطلب الثالث: تسجيل ملكية المساجد ورهنها 29
الفرع الأول: حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع. 29
الفرع الثاني: وهل يجوز الموافقة على ارتهان المسجد إذا لم يسدد ثمنه بالكامل؟. 29
المطلب الرابع: تمويل بناء المساجد 32
الفرع الأول: ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟. 32
فائدة: وقف الكافر على المسجد 36
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهﷺ، أما بعد:
فقد طلبت مني إدارة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كتابة بحثين عن أحكام المساجد لتقديمهما إلى دورة المجمع لعام 1436 هـ 2015 م. وموضوع البحث الأول هو ثبوت المسجدية ومسائل أخرى ذات تعلق ببناء المساجد ووقفها، وموضوع البحث الثاني هو نوازل خطبة الجمعة.
وهذه الورقات تتناول الموضوع الأول عن ثبوت المسجدية. وقد طلب مني الإجابة عن الأسئلة الآتية تحديدًا:
- بما تثبت المسجدية؟ وما الفرق بين المصلى والمسجد؟ وهل لهذا الفرق أثر من الناحية العملية؟
- المسجد وقف، فهل يجوز نقل هذا الوقف واستبداله للمصلحة؟ كالانتقال إلى مسجد أوسع، أو أنسب موقعا، أو أيسر في مرافقه كسعة المواقف ونحوه؟
- هل يجوز تحويل المسجد القديم إلى صالة متعددة الأنشطة تابعة للمسجد بسبب إقامة مسجد جديد في نفس المنطقة أو قريب منها؟
- هل يجوز استئجار عقار ليكون مسجدا إذا لم يتيسر التملك؟ أو إذا كان خطوة على طريق التملك؟
- ما حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع بالمبنى ليكون مسجدا لكنه يريد بقاء اسمه لضمان ألا تسيء إدارة المسجد التصرف فيه؟
- هل يجوز الموافقة على ارتهان المسجد إذا لم يسدد ثمنه بالكامل؟ وما حكم رهن المسجد لدى شركات التمويل من أجل الحصول على تمويل لشراء مسجد أوسع علما بأن المسجد القديم يظل مفتوحا للصلاة فيه فقط، وتضمن شركة التمويل ألا يتم بيعه حتى سداد قيمة المسجد الجديد؟
- ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟
- ما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مركز إسلامي عند تعين الحاجة وشح الجالية؟ وما حكم أخذ قرض ربوي أو قرض حسن لعمل مشروع استثماري لصالح المركز مع ضمان المركز مقابل هذا القرض؟
- ما حكم الاقتراض الربوي لاستكمال شراء المسجد عند الخوف من ضياع المشروع بالكلية؟
وقد قسمت البحث إلى مطالب بحسب ورود الأسئلة، فأجبت عن السؤال الرابع في ثنايا المطلب الأول، وضممت السؤالين الثاني والثالث في مطلب واحد، والخامس والسادس في مطلب، والثلاثة الأخيرة في مطلب، فكانت المطالب أربعة:
- ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات
بما تثبت المسجدية؟ وهل يجوز استئجار عقار ليكون مسجدا إذا لم يتيسر التملك؟ أو إذا كان خطوة على طريق التملك؟ وما الفرق بين المصلى والمسجد؟ وهل لهذا الفرق أثر من الناحية العملية؟
- إبدال المساجد وتحويل الغرض منها
المسجد وقف، فهل يجوز نقل هذا الوقف واستبداله للمصلحة؟ كالانتقال إلى مسجد أوسع، أو أنسب موقعا، أو أيسر في مرافقه كسعة المواقف ونحوه؟ وهل يجوز تحويل المسجد القديم إلى صالة متعددة الأنشطة تابعة للمسجد بسبب إقامة مسجد جديد في نفس المنطقة أو قريب منها؟
- تسجيل ملكية المساجد ورهنها
ما حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع بالمبنى ليكون مسجدا لكنه يريد بقاء اسمه لضمان ألا تسيء إدارة المسجد التصرف فيه؟ وهل يجوز الموافقة على ارتهان المسجد إذا لم يسدد ثمنه بالكامل؟ وما حكم رهن المسجد لدى شركات التمويل من أجل الحصول على تمويل لشراء مسجد أوسع علما بأن المسجد القديم يظل مفتوحا للصلاة فيه فقط، وتضمن شركة التمويل ألا يتم بيعه حتى سداد قيمة المسجد الجديد؟
- تمويل بناء المساجد وعمارتها
ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟ وما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مركز إسلامي عند تعين الحاجة وشح الجالية؟ وما حكم أخذ قرض ربوي أو قرض حسن لعمل مشروع استثماري لصالح المركز مع ضمان المركز مقابل هذا القرض؟ وما حكم الاقتراض الربوي لاستكمال شراء المسجد عند الخوف من ضياع المشروع بالكلية؟
وقد نقلت أكثر نصوص العلماء إلى الهوامش، ليجدها طالبها هناك، واكتفيت في صلب البحث بذكر ممضامينها بعبارة مختصرة، تيسيرًا على القارئ، وحتى لا يطول البحث جدًا. وعمومًا لقد اجتهدت في الاختصار قدر الطاقة حتى لا يزيد البحث عن ثلاثين صفحة، ولكنني عجزت عن الالتزام بهذا المعيار لكثرة الموضوعات المطلوب بحثها وتشعبها.
وأبدأ بالتوطئة بذكر تعريف المساجد وأنواعها.
تعريف المساجد وأنواعها
أولًا: المسجد في اللغة
السجود يأتي في اللغة على معاني الانحناء والتطامن إلى الأرض والذل والخضوع. والمسجد يأتي مصدرا بفتح الجيم واسم مكان بكسرها في المشتهر، وربما فتحت.[1]
ثانيًا: المسجد في الشرع
جاء ذكر المسجد في الوحيين على معان مختلفة، منها:
- كل مكان صالح للسجود والعبادة، وهي الأرض كلها – سوى ما استثني – كما في قوله r: “وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.”[2]
- وبمعنى المكان الذي يخصص للصلاة، وإلم يوقف مسجدًا لعموم الناس، ومنه مسجد البيت، فعن بلال t: “أنه جاء إلى النبي r يؤذنه بالصلاة فوجده يتسحر في مسجد بيته”[3]. قال ابن رجب w: “وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها.”[4]
- ومنها تلك الدور المخصوصة والمهيأة لإقامة الجمع والجماعات وأنواع العبادات والموقوفة لذلك الغرض، وهي التي تختص بأحكام المساجد المعروفة. يقول الزركشي w في إعلام الساجد: “وأما المسجد شرعا فكل موضع من الأرض، لقوله r: “جعلت لي الأرض مسجدا” … ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتقّ اسم المكان منه، فقيل: مسجد، ولم يقولوا: مركع. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيَّأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المُصَلَّى المجتمع فيه للأعياد، ونحوها فلا يعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنما هيئت لغير ذلك.”[5]
والكلام عن ثبوت المسجدية وأحكام بنائها ووقفها إنما يتعلق بالمسجد المخصوص، فإنه يستحيل أن تكون الأرض كلها مرادة بأحكام المساجد كعدم لبث الجنب ووجوب التحية وغيرها. أما مساجد البيوت، فجماهير أهل العلم لا يجعلون لها أحكام المساجد، وهو الصحيح. قال ابن رجب w: “ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عندَ جمهور العلماء، فلا يمنع الجنب والحائض منها، خلافاً لإسحاق في ذَلِك”.[6] وقد عللوا لذلك بأشياء، قال بدر الدين العيني w في البناية: “(لأنه لم يأخذ حكم المسجد) ش: لبقائه في ملكه، حتى له أن يبيعه ويهبه ويورث عنه، فكان حكمه حكم غيره من المنزل المملوك، فلا يكره المجامعة والبول في جوفه فضلا عن سطحه، وتسميته مسجدا لا يفيد حكم المساجد”[7] ومثلها – في رأي الباحث – الغرف المخصصة للصلاة في الشركات والمصانع والأماكن العامة من غير وقف مؤبد، أي تحرير لها من ملك الخلق. وفي البناية كذلك: “فإن قلت: ما حكم المساجد التي عند السواقي وعند الحياض. قلت: قال بعضهم حكمها حكم المسجد، والأصح أنها ليس لها حرمة المسجد.” [8]
المطلب الأول: ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات
أجيب في هذا المطلب عن الأسئلة الآتية:
بما تثبت المسجدية؟ وهل يجوز استئجار عقار ليكون مسجدا إذا لم يتيسر التملك؟ أو إذا كان خطوة على طريق التملك؟ وما الفرق بين المصلى والمسجد؟ وهل لهذا الفرق أثر من الناحية العملية ؟
أقسم الكلام في هذا المطلب على فرعين:
- الأول عن ثبوت المسجدية، وفيه الجواب عن السؤال الرابع وهو: هل يجوز استئجار عقار ليكون مسجدا إذا لم يتيسر التملك؟ أو إذا كان خطوة على طريق التملك؟
- والثاني عن الفرق بين المصلى والمسجد وآثار التفريق من الناحية العملية.
الفرع الأول: ثبوت المسجدية
تثبت المسجدية باتفاق الفقهاء إذا صرح مالك جائز التصرف بوقف بنايته التي لم يتعلق بها حق للغير أو جزء مفرز منها مسجدًا وقفًا مؤبدًا ومنجزًا ولم يكن فوقها أو تحتها بناء وأقام المسلمون فيها الصلوات الخمس.
وفي عبارة نقل الاتفاق احتراز عن مواضع الخلاف التي اختل فيها أحد أركان الوقف أو شروطه أو شروط المسجدية، عند بعضهم، وأهمها:
- إن كان الواقف غير جائز التصرف أو تعلق بالموقوف حق للغير أو كان مشاعًا غير مفرز ولا قابل للقسمة
- إن كان الوقف مستأجرًا غير مملوك فهل يصح وقفه
- إلم يصرح بالوقف بأن كنى أو فعل ما يدل عليه عرفًا، أو صرح بوقف المحل للصلاة وغيرها من أعمال الخير ولم يصرح بوقفه مسجدًا، أو كان المحل لا يمنع الناس فيه من الصلوات ولكن لم تقم فيه الصلوات الخمس أبدًا
- إن كانت الأرض فضاءً أو لم يكن بناء يقي الناس من الحر والبرد، فهل تعطى أحكام المسجد بوقفها
- إن كان ثم بناية تحت المكان الموقوف مسجدًا أو فوقه
- إن كانت للمسجد مرافق متصلة ببنائه أو منفصلة عنه فهل لها أحكامه
تمهيد
أركان الوقف أربعة: واقف ومحل وموقوف عليه وصيغة، وشروطه (على خلاف بين أهل العلم): التأبيد والتنجيز وتعيين المستحق والإلزام. ولعل الركن الثالث وهو الموقوف عليه والشرطين الأخيرين وهما التعيين والإلزام لا حاجة لإطالة النفس في مناقشتها لأن الصحيح أن وقف المساجد – (وعلى خلاف آلتها) – لا يفتقر إلى قبول من أحد لأنه تحرير من ملك صاحبه من غير إدخال في ملك الغير، ولهم كلام في الموقوف عليه وتعيين المستحق نضرب عنه صفحًا لأنه إنما يناسب، على الصحيح، في الربط والمدارس دون المساجد.
وفي السطور القادمة نناقش إن شاء الله الاحترازات الواردة في التعريف ونرجح ما يظهر من أقوال أهل العلم لننتهي إلى جواب السؤال المطروح عن ثبوت المسجدية.
1- إن كان الواقف غير جائز التصرف أو تعلق بالموقوف حق للغير أو كان مشاعًا غير مفرز ولا قابل للقسمة
فلا يجوز وقف الصبي والمجنون والمحجور عليه والمكره لأنهم ليسوا من أهل التصرف. وإذا تعلقت بالعين الموقوفة حقوق للغير، كأن يكون على الواقف دين يستغرق ماله أو يكون قد أوقف في مرض موته، فهنا يحتاج في نفاذ الوقف، وإن صح، إلى إذن الغرماء أو الورثة. قال ابن الهمام w في فتح القدير: “لَوْ اشْتَرَى دَارًا لَهَا شَفِيعٌ فَجَعَلَهَا مَسْجِدًا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ”.[9]
وهناك مسألة أخرى، وهي إن كان الموقوف مشاعًا غير مفرز ولا قابل للقسمة، فلا يصح جعل الوقف عندها مسجدا أو مقبرة، لوجوب خلوصهما للغرض منهما.
والكلام يطول في هذا الباب ولكن أحببنا الإشارة إليه للتنبيه عليه ولم يناسب الاستقصاء في بحثه لأنه يطول والحاجة أمس إلى التفصيل في غيره من المسائل التي تعرض كثيرًا للجاليات المسلمة في الغرب، فنقول اختصارًا إن الوقف لا يصح إلا من جائز التصرف، تام الملك، فإن كان غير ذلك، فلا يصح وقفه، وإن تعلق به حق للغير لم ينفذ إلا بإذنه، وإلم يكن الموقوف مفرزًا كأن يكون مشاعًا غير قابل للقسمة فلا يصح وقفه مسجدًا أو مقبرة خصوصًا.
2- إن كان الموقوف مستأجرًا غير مملوك فهل يصح وقفه مسجدًا؟
أولًا هل يصح اتخاذ المسلمين لمكان مستأجر يصلون فيه الجماعة ويتخذونه مسجدًا بمعنى المكان المهيأ للصلوات؟
ذهب الجمهور إلى الجواز. قال ابن قدامة w في المغني: “وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَارٍ يَتَّخِذُهَا مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ.”[10]
ومنع من استئجار دار للصلاة الحنفية، ففي الحاشية يقول ابن عابدين w: “وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْتًا يَجْعَلُهُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا.”[11]
وفي المدونة أن ابن القاسم w كره لمالك الدار أن يكريها لمن يصلي فيها، وخالفه أشهب w،[12] واعتمد المالكية قوله وعللوا قول ابن القاسم w بأنه قصد به من يدفع بيته إلى الناس وقت الصلاة فقط.[13]
الأدلة والترجيح
دليل الحنفية كما ذكره ابن عابدين w هو”أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى مَا هُوَ طَاعَةٌ لَا يَجُوزُ.”[14] ودليل الجمهور كما ذكره ابن قدامة w هو أن بناء المساجد غير إقامة الصلاة، قال: “وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ، يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا، فَجَازَ اسْتِئْجَارُ الْعَيْنِ لَهَا، كَالسُّكْنَى، وَيُفَارِقُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، بِخِلَافِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ.”[15]
وحجة الجمهور أظهر فالإجارة إنما تقع على شغل البيت لا فعل الصلاة. والخروج من خلاف الأحناف يكون بعدم ذكر الصلاة في عقد الإجارة، وإنما يذكر غير ذلك من المنافع.
ثانيا هل تثبت أحكام المسجد الخاصة لهذا المحل؟
أما ثبوت أحكام المسجد لهذه الدار فهو مترتب على اشتراط التأبيد في الوقف، لأن المسجد الذي تثبت له أحكام المساجد لا بد أن يكون موقوفًا، وتأبيد الوقف شرط لصحته عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، فلو وقف ووقت لبطل التوقيت عند الحنفية ما لم يصرح برجوع الوقف إليه بعدها، فعندها يبطل الوقف،[16] وعند الشافعية يبطل التوقيت ويصح الوقف،[17] وعند الحنابلة يبطل الوقف في المعتمد.[18]
إلا أن الشافعية أجازوا وقف البناء على أرض مستأجرة[19] مع منعهم الاعتكاف داخل هذا البناء حتى يثبت في تلك الأرض مسطبة أو نحوها ويقفها مسجدًا لأن الأرض غير الموقوفة لا تصلح للاعتكاف عليها إذ لا يصح إلا في مسجد، والأرض المستأجرة ليست مسجدًا، نعم أجازوا الاعتكاف فوق سقف البنيان الموقوف.[20] وإلى جواز وقف البناء على الأرض المستأجرة ذهب ابن تيمية w فقد سئل عمن استأجر أرضًا وعمر فيها مسجدًا، فأجاب: “يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْبِنَاءَ الَّذِي بَنَاهُ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَة، سَوَاءٌ وَقَفَهُ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ، وَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ حَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.”[21]
وخالف في شرط التأبيد المالكية فأجازوا الوقف المؤقت. قال الدرير w: “(وَلَا) يُشْتَرَطُ (التَّأْبِيدُ) فَيَصِحُّ مُدَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ مِلْكًا.”[22] وصرحوا بأن التوقيت يجوز في وقف المساجد أيضًا فقالوا: “ولا بأس أن يكري أرضه على أن تُتخذ مسجداً عشر سنين، فإذا انقضت كان النقض للذي بناه ورجعت الأرض إلى ربها.”[23]
الأدلة والترجيح
أولا في جواز توقيت الوقف عمومًا
مما يستدل به لمن منع التوقيت قوله r لعمر: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها” ولا يكون تحبيسًا إلا بالتأبيد. وفهم ذلك عمر t، قال الراوي: قال: “فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول”[24] ولم يرد أن الصحابة وقتوا مدة لشيء من أوقافهم، وقد أخرج الواقف الموقوف من ملكه إلى ملك الله فلا يعود فيه كما لا يعود في صدقته، ولأنه إزالة الملك لا إلى أحد فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق.[25]
والراجح هو جواز توقيت الأوقاف، فإن رسول الله r قال لعمر في الحديث السابق: “إن شئت”، ولم يبدأه بالأمر حتى سأله عمر. وعمل عمر والصحابة بالتأبيد لا يعني منع التوقيت، فإن تصدق أحد بمنفعة مدة فلا يقال له بل تفعل ذلك أبدًا أو لا يكون وقفًا، والأصل في التبرعات المسامحة وعدم الإلزام. وليس التوقيت رجوعًا في التبرع لأنه إنما تبرع بالمنفعة لمدة معلومة ابتداءً. وقياسهم على العتق غير صحيح لتشوف الشارع إلى الأخير، ولأن العتيق يصير حرًا فلا يعود إلى الرق إلا بسبب جديد. نعم لا يستوي من وقت ومن أبد في الأجر، ولكن هذا التفاوت في الأجر لا يمنع من صحة التوقيت.
ثانيًا في جواز توقيت وقف المسجد خصوصًا
الذي يظهر للباحث عدم جواز توقيت وقف المسجد والمقابر خصوصًا وعدم جواز وقف المستأجر من الدور مساجد مراعاة لحرمة بيوت الله، وحتى لا يكون لغير الله ملك عليها، سيما في البلاد التي لا تحكم فيها الشريعة إذ لا يتمكن من مراعاة جميع أحكام المساجد من ظهور سلطان المسلمين عليها وعدم نقضها إلا إذا انتقض بناؤها أو تحتم إبدالها (على خلاف في الإبدال)، وانظر إلى قول ابن تيمية w وهو ممن أجاز وقف المسجد المعمور على أرض مستأجرة، ولكنه قال: “.. وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.”[26] فأوجب على الواقف دفع أجرة المثل للمؤجر ما لم ينهدم بناء المسجد.
والتفريق بين وقف المساجد وغيرها هو ما ذهب إليه القانون المصري، وذهبت إليه دار الإفتاء المصرية، حيث قالوا: “جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا.”[27]
إن الذي يظهر – والله أعلم – هو جواز استئجار الدور واتخاذها مساجد بمعنى المكان المهيأ للصلوات، وذلك لاجتماع المسلمين فيها وإقامة الجمع والجماعات (على الأصح من عدم اشتراط المسجدية للأولى)، ولكن لا تأخذ تلك الدور أحكام المساجد كاملة، وإنما يفتى المسلمون بمراعاة آداب المساجد فيها حتى لا تنشأ ناشئة لا يعرفون تلك الآداب، والتفريق في أحكام المساجد مما درج عليه أهل العلم، ففي حاشية ابن عابدين: “قَالَ فِي أَوَاخِرِ شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَالْمَسَاجِدُ الَّتِي عَلَى قَوَارِعِ الطُّرُقِ لَيْسَ لَهَا جَمَاعَةٌ رَاتِبَةٌ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ، لَكِنْ لَا يَعْتَكِفُ فِيهَا.”[28]
3. إلم يصرح بالوقف بأن كنى أو فعل ما يدل عليه عرفًا أو صرح بوقف المحل للصلاة وغيرها من أعمال الخير ولم يصرح بوقفه مسجدًا أو كان المحل لا يمنع الناس فيه من الصلوات ولكن لم تكن تقام فيه الصلوات الخمس أبدًا
أضيق المذاهب في هذه المسألة (وربما قلت أوسعها للناس) هم الشافعية، فهم يشترطون لثبوت المسجدية – في غير أرض الموات[29] – أمرًا من ثلاثة:
- التصريح بجعل المحل مسجدًا،[30] وإلم ينو[31]
- أو الكناية مع النية[32]
- أو وقفه للاعتكاف[33] أو الإذن بالاعتكاف فيه[34]
ولكن ابن حجر w قد نقل عن السبكي w “أَنَّنَا إذَا رَأَيْنَا صُورَةَ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ حَكَمْنَا بِوَقْفِيَّتِهِ.”[35] وجوز الشافعية التعليق في وقف المساجد على خلاف الأصل من اشتراط التنجيز في الأوقاف لأن وقفها تحرير للأرض من ملك العبد لا إلى غيره.[36] ورغم اشتراطهم التأبيد في الأوقاف إلا أنهم أمضوا الوقف المؤقت وأوقعوه مؤبدًا.[37] وصرحوا كذلك بأنه لو جمع مالا من الناس لبناء مسجد صار كذلك بمجرد بنائه ولم يفتقر إلى تصريح بالوقف.[38]
أما الجمهور فيكتفون بالعرف في ثبوت المسجدية، فالمالكية لا يشترطون سوى بناء المسجد بصورته والإذن للناس بالصلاة فيه. يقول الدردير w: “(قَوْلُهُ: بِحَبَسْتُ وَوَقَفْتُ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا كَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ كَمَسْجِدٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا فَرْضًا دُونَ نَفْلٍ فَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ فِيهِ لِلنَّاسِ فَذَلِكَ كَالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ وَقْفٌ.”[39]
والحنفية اختلفوا فالطرفان يضيفان لشروط المالكية حصول الصلاة[40] أو تسلم المتولي[41] للمسجد. وعند أبي يوسف يزول الملك بذلك أو بمجرد قول المالك لملكه جعلته مسجدًا.[42] والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف w.[43]
وعند الحنابلة تكفي صورة المسجد أو التسمية لثبوت المسجدية. في مطالب أولي النهى ” .. (وَوَقَفَهَا) أَيْ الْأَرْضَ (مَسَاجِدَ؛ يَكْتَفِي فِي) ثُبُوتِ وَقْفِهِ لَهَا بِنَاءَ (الْمَسْجِدِيَّةِ بِالصُّورَةِ) أَيْ صُورَةِ الْمَسْجِدِ كَبِنَاءِ مِحْرَابٍ أَوْ مِنْبَرٍ، (وَ) يَكْتَفِي بِذَلِكَ أَيْضًا (بِالِاسْمِيَّةِ) أَيْ: بِتَسْمِيَتِهِ مَسْجِدًا”.[44]
الأدلة والترجيح
لعل الراجح في زماننا هذا هو قول الشافعية، فيلتزم بتصريح الواقفين بالمسجدية، وتعيين الموضع الموقوف مسجدًا، وإفرازه عن باقي ملك صاحبه، إذ قد تبنى البنايات على هيئة مشابهة للمساجد دون أن يراد بها ذلك، وقد أورد ذلك المعنى ابن عرفة المالكي على من اكتفى بالهيئة من المالكية فقال: “ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجدا لنفسه.”[45] وعلى العكس، فقد لا تكون البنايات التي توقف مساجد على الهيئة المعروفة لها، وقد تكون هناك قاعات متعددة يجعل بعضها مسجدًا ويخصص بعضها لأغراض أخرى، كما سيأتي الحديث عنه في الكلام عن مرافق المسجد. ويتوقف الباحث فيما لو أذن المالك في ملكه بما هو من خصائص المسجد كالاعتكاف، وكانوا قد أقاموا فيه الصلوات الخمس، فإن ثبت الإجماع في هذه الحالة، فهو كذلك، وإلا اشترطنا التصريح دون سائر الأفعال والكنايات لقلة العلم وشيوع الجهل. لكن إذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على أرض ما، صار الجزء المخصص منه عرفًا بالصلوات مسجدًا بتمام بنائه.
4. إن كانت الأرض فضاءً أو لم يكن بناء يقي الناس من الحر والبرد، فهل تعطى أحكام المسجد بوقفها
ليس من السهل تحرير أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن ثبوت الوقفية شيء وثبوت المسجدية شيء آخر، وكذلك فإن إثباتهم بعض أحكام تعظيم المساجد كمنع الجنب منها مثلًا لا يتوقف على كمال المسجدية الذي يشترط عندهم لوجوب التحية وصحة الجمعة (عند القائل به) والاعتكاف.
أما الأحناف، فقد وجدت عسرًا في تحرير قولهم في هذه المسألة. يقول ابن مازة الحنفي w: “وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» …: رجل له أرض ساحة لا بناء فيها، أمر قومًا أن يصلوا فيها بجماعة، فهذا على ثلاثة أوجه: أما إن أمرهم بالصلاة فيها أبداً نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً أو أمرهم مطلقاً ونوى الأبد وفي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لا يورث عنه…”[46] وظاهر هذا الكلام، وهو المفتى به عند متأخري الحنفية، ثبوت المسجدية لتلك الساحة، إلا أن يكون المقصود ثبوت الوقفية دون المسجدية، ولكن يشكل على الظاهر أن الأحناف يجوزون بناء بيت للإمام فوق المسجد قبل تمام مسجديته. [47] ولعل الفرق بين ذلك وكلام الصدر الشهيد w هو أنه صرح بوقف الأرض في كلام الصدر، ولكن يشكل أيضًا أنه لو جعل على هذه الأرض بيت شعر، فإنهم لن يحكموا له بالمسجدية لاشتراطهم البنيان. [48]
وأما المالكية، فكلامهم أقطع في عدم ثبوت المسجدية للأرض الفضاء في المعتمد عندهم. قال الدردير w في الكلام عن شروط الجمعة: “… (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ فِي بَرَاحِ حَجَرٍ) أَيْ أُحِيطَ بِأَحْجَارٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى مَسْجِدًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَقَرَّرُ مُسَمَّى الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ ذَا بِنَاءٍ وَسَقْفٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ”.[49] ووجدت لهم تصريحًا عن سقوط أحكام المسجدية عما خرب منها،[50] وهو قوي في دلالته على المقصود فإنه من باب أولى لا يعطى الفضاء حكم المسجد قبل بنائه.
وأما الشافعية فيصرحون بإعطاء الفضاء الموقوف لبناء مسجد أحكام المساجد من منع الجنب من المكث فيها وغيرها من أحكام التعظيم.[51] وفي فتاوى ابن الصلاح: “مَسْأَلَة رجل مَالك لربع أَرض مشَاعا فَقَالَ وقفت ملكي هَذَا مَسْجِدا لله تَعَالَى هَل يَصح هَذَا الْوَقْف أم لَا وَكَذَا يتنجز وَهل إِن صَحَّ مُنجزا يحرم على كل جنب أَن يدْخل إِلَى الأَرْض أَو الى بعض أَجْزَائِهَا وَيمْكث فِيهَا … ؟ أجَاب رَضِي الله عَنهُ نعم يَصح وَقفه ذَلِك مَسْجِدا ويتنجز وقفيته وَيثبت فِي الْحَال تَحْرِيم الْمكْث فِي جَمِيع الأَرْض على الْجنب تَغْلِيبًا للْمَنْع”.[52]
ولعل الحنابلة لا يعطون الأرض الموقوفة حكم المسجد ففي كشاف القناع: “(وَوَقَفَهَا) – أَيْ: الْأَرْضَ – (مَسَاجِدَ؛ يَكْتَفِي فِي) ثُبُوتِ وَقْفِهِ لَهَا بِنَاءَ (الْمَسْجِدِيَّةِ بِالصُّورَةِ) أَيْ: صُورَةِ الْمَسْجِدِ – كَبِنَاءِ مِحْرَابٍ أَوْ مِنْبَرٍ، (وَ) يَكْتَفِي بِذَلِكَ أَيْضًا (بِالِاسْمِيَّةِ) أَيْ: بِتَسْمِيَتِهِ مَسْجِدًا، (فَإِذَا زَالَتْ) تِلْكَ الصُّورَةُ بِانْهِدَامِهَا، وَتَعَطُّلِ مَنَافِعِهَا؛ (عَادَتْ الْأَرْضُ إلَى حُكْمِهَا) الْأَصْلِيِّ، (مِنْ جَوَازِ لُبْثِ جُنُبٍ) فِيهَا، (وَعَدَمِ صِحَّةِ اعْتِكَافٍ) لِزَوَالِ حُكْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ عَنْهَا”.[53] لاحظ أنهم يثبتون المسجدية بالبنيان على صورة المسجد ويقطعونها بتهدمه وخرابه، ويشكل عليه ما جاء في كشاف القناع نفسه: “(فَلَوْ وَقَفَهُ) أَيْ: الْمُشَاعَ (مَسْجِدًا ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الْحَالِ) عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالْوَقْفِ (فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْجُنُبُ)… وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.”[54] إلا أن يكون المقصود بالمشاع هنا البنيان لا كما صرح ابن الصلاح الشافعي المشار إليه بأنها الأرض (انظر كلامه في حكاية قول الشافعية).
الأدلة والترجيح
الذي يظهر للباحث هو رجحان قول المالكية والحنابلة بعدم ثبوت أحكام المسجد للأرض الموقوفة له قبل بنائه، وإن ثبتت الوقفية، وهو الموافق للعرف والمعقول وليس ثم نص على خلافه، وهو كذلك الأرفق بالناس فحمل الناس على مراعاة أحكام وآداب المسجد في الأرض الفضاء متعذر. لكن إن اقترب بناؤه من هيئة المساجد، فينبغي أن يلزموا بذلك قدر الطاقة.[55]
5. إن كان ثم بناية تحت المكان الموقوف مسجدًا أو فوقه
اختلف أهل العلم في جواز وقف دار مسجدًا إن كان تحتها أو فوقها بناء ليس منه، فذهب البعض إلى جواز ذلك في الوجهين، ومنهم الحنابلة[56] وأبو يوسف من الأحناف[57]، وذهب بعضهم إلى المنع فيهما، وهو المعتمد عند الأحناف[58] وقول ابن حزم[59]، وجوز بعضهم أن يكون المسجد في العلو دون السفل، وهو قول المالكية[60]، وقول محمد من الحنفية[61]، وجوز آخرون العكس بأن يكون المسجد في السفل دون العلو، وهو قول الشافعية[62] ورواية عن أبي حنيفة[63]. ويفرق الحنفية[64] والشافعية[65] في صحيح المذهبين في حكم الأبنية قبل الوقف وبعده، فهم يأذنون في وقف السفل دون العلو قبل الوقف. أما بعده، فيجعلون للهواء حكم الأصل[66].
الأدلة والترجيح
ودليل من منع أن يكون فوق المسجد خصوصًا دار للسكنى أو الاستغلال أن لهواء المسجد حكمه، فلا يجوز مكث الجنب فيه والجماع وغير ذلك مما لا يجوز في المساجد، ولأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل تعذر تعظيمه.[67] وقال مالك: “وقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إمَامَ هُدًى وَقَدْ كَانَ يَبِيتُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَلَا تَقْرَبُهُ فِيهِ امْرَأَةٌ، وَهَذَا إذَا بُنِيَ فَوْقَهُ صَارَ مَسْكَنًا يُجَامِعُ فِيهِ وَيَأْكُلُ فِيهِ.”[68]
ودليل من منع أن يكون تحت المسجد خصوصًا دار للسكنى أو الاستغلال أن المسجد يتأبد، وذلك يتحقق في السفل دون العلو.[69]
وقد انتصر ابن حزم للمانعين من الوجهين بقوة عارضته وحسن بيانه فقال:
“… بُرْهَانُ ذَلِكَ [المنع من مسجد تحته أو فوقه بناية ليست منه] أَنَّ الْهَوَاءَ لَا يُتَمَلَّكُ، لِأَنَّهُ لَا يُضْبَطُ وَلَا يَسْتَقِرُّ؟ وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18] فَلَا يَكُونُ مَسْجِدًا إلَّا خَارِجًا عَنْ مِلْكِ كُلِّ أَحَدٍ دُونَ اللَّهِ[70] … وَكَذَلِكَ إذَا بَنِي عَلَى الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَشَرَطَ الْهَوَاءَ لَهُ يَعْمَلُ فِيهِ مَا شَاءَ: فَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِشَرْطٍ فَاسِدٍ … وَأَيْضًا: فَإِذَا عَمِلَ مَسْجِدًا عَلَى الْأَرْضِ وَأَبْقَى الْهَوَاءَ لِنَفْسِهِ: فَإِنْ كَانَ السَّقْفُ لَهُ؟ فَهَذَا مَسْجِدٌ لَا سَقْفَ لَهُ، وَلَا يَكُونُ بِنَاءٌ بِلَا سَقْفٍ أَصْلًا. وَإِنْ كَانَ السَّقْفُ لِلْمَسْجِدِ؟ فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ. وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ فِي الْعُلْوِ وَالسَّقْفُ لِلْمَسْجِدِ: – فَهَذَا مَسْجِدٌ لَا أَرْضَ لَهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ. فَإِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، فَإِنَّمَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ بَيْتًا بِلَا سَقْفٍ، وَهَذَا مُحَالٌ؟ وَأَيْضًا: فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ سُفْلًا؟ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى رُءُوسِ حِيطَانِهِ شَيْئًا، وَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ عُلْوًا، فَلَهُ هَدْمُ حِيطَانِهِ مَتَى شَاءَ، وَفِي ذَلِكَ هَدْمُ الْمَسْجِدِ وَانْكِفَاؤُهُ.”[71]
ونحن نقر بأنه إن تم الوقف، فلا يجوز بناء بيت تحت المسجد أو فوقه يتملكه أحد الناس، فقد ثبتت الوقفية على المسجد وهوائه، ولكن إن خص الواقفون دارًا بعينها للصلاة على التأبيد وكان تحتها أو فوقها دار ليست منها فلا يظهر وجه للمنع من ذلك، ولا يظهر للباحث المنع من وقفهم السفل من بناية لم تكتمل مسجدًا، على أن يبنوا فوقها مرافق للمسجد متى تيسر ذلك، وقد أجاب ابن قدامة عن مسألة الخلوص لله، فقال في الدار توقف يكون تحتها أو فوقها دار: “… وَلَنَا أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا، كَذَلِكَ يَصِحُّ وَقْفُهُ، كَالدَّارِ جَمِيعِهَا، وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ إلَى مَنْ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِقْرَارِ وَالتَّصَرُّفِ.”[72] وليس ثم نص يمنع من ذلك، وما ذكروه من التعليلات فليس صريحًا، وفعل عمر بن عبد العزيز لا يدل على المنع، وهو كذلك في حكم هواء المسجد بعد وقفه، وما قاله ابن حزم عن حق من في السفل أن يهدم حيطانه منتقض بما عليه سكان العمائر في زماننا هذا، بل الصحيح أنه يمنع من الضرر بمن فوقه وهو أمر متقرر في الشريعة. ثم إن المانعين قد اختلفوا في تعليلاتهم، وجوز الأحناف والشافعية قبل تمام المسجدية بناء دار فوق المسجد للإمام تمكث فيها امرأته وهي حائض ويجامعها فيها.[73] إن مثال هذه المسألة هو ما نقل من اتفاق المتقدمين من الأحناف على منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن ثم اتفاق المتأخرين منهم على جوازه. لقد أرادوا تعظيم كتاب الله حتى إذا خافوا عليه الضياع أذنوا في أخذ الأجرة على تعليمه. والمانعون لوقف الدور مساجد إن كان تحتها أو فوقها أبنية ليست منها، إنما أرادوا تعظيم شعائر الله ومن أعظمها المساجد، ولكنهم لو أدركوا زماننا لقدموا مصلحة الصلاة والذكر على ما أرادوه، فما جعلت المساجد إلا لذلك، وإننا إن منعنا المساجد في العمائر الضخمة في مدننا الحديثة لضاعت صلاة الجماعة وكثير من أعمال الخير، وانظر إلى ما رواه ابن الهمام عن الصاحبين: “(وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلَيْنِ [الْوَجْهَيْنِ أي وفوقها أو تحتها دور للسكنى أو الاستغلال] لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ الْأَمَاكِنِ وَ) كَذَا (عَنْ مُحَمَّدٍ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ) وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ بِالضَّرُورَةِ.”[74] فلو رأوا مدننا، ماذا يقولون؟ وأخيرًا، فإن تجويز اتخاذ المساجد في العمائر لا ينفي أفضلية أن تكون هناك في كل الأحياء مساجد مستقلة البنيان إظهارًا لشعائر الإسلام وتعظيمًا لها.
6. إن كانت للمسجد مرافق متصلة ببنائه أو منفصلة عنه فهل لها أحكامه
لم تكن لمسجد رسول الله r مرافق ملحقة به، ولكن مع تطور العمران صار للمساجد مرافق متصلة به أو منفصلة عنه، ومن أهمها في الأزمنة الماضية: المنارة والرحبة والمقصورة والخلوات وسكن الإمام. وفي زماننا هذا كثرت تلك المرافق فشملت دورات المياه وغرف تجهيز الموتى والمكتبات، وقاعات الدرس، وصالات اللعب والاجتماعات، والمكاتب الإدارية ومواقف السيارات، إلخ.
ويرد هنا سؤال وهو هل تثبت لهذه المرافق أحكام المسجد إن كانت متصلة به؟
وأبدأ بتوطئة مختصرة للجواب بعرض سريع لاتجاهات الفقهاء بشأن المرافق في أزمنتهم، ونخص منها المتصلة بالمسجد فإن القول بإعطاء حكم المسجدية للمرافق المنفصلة عنه أضعف ومختص بما هو من شعار المسجد كالمنارة، ومع ذلك فالجمهور فيها على خلافه.
في البداية نبدأ بتقرير اتفاق الفقهاء على أن لسطح المسجد حرمة المسجد، وقد نقل ابن قدامة الإجماع عليه في المغني[75]، وهل له كل أحكامه بحيث تجوز الجمعة فيه والاعتكاف؟ جمهورهم (الحنفية[76] والشافعية[77] والحنابلة[78]) على ذلك، وخالف المالكية في المعتمد عندهم فلم يجيزوا الجمعة على السطح ولا الاعتكاف[79] مع موافقتهم للجمهور في إعطائه حرمة المسجد. قال ابن رشد (الجد): “لا اختلاف في أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد.”[80] ولكن الحنفية والشافعية والحنابلة – كما ذكرنا في المطلب السابق – يجيزون اتخاذ سكن للإمام على السطح متى قرروا ذلك قبل تمام المسجدية، فتكون العبرة هنا بما يقرره الواقفون، فإن رأوا تخصيص المسجدية بداخل البنيان دون هوائه، فلهم ذلك وإلا لما جاز أن يسكن الإمام مع أهله فوق المسجد.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المقصورة التي كان الأمراء يصلون فيها لحماية أنفسهم من العامة، فذهب البعض إلى كونها من المسجد، وذهب آخرون إلى أنها ليست منه، بينما توسط البعض فاعتبروها من المسجد إذا أبيحت للعامة. قال ابن رشد (الجد): “… فإن كانت ممنوعة تفتح أحيانا وتغلق أحيانا فالصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بها، وإن كانت مباحة غير ممنوعة فالصف الأول هو اللاصق بجدار القبلة في داخلها.”[81] وقد يفهم من كلام بعضهم عن المقصورة أن المسجدية لا تثبت عندهم لحجرة داخل بنيان المسجد الأصلي إن كانت غير مباحة لصلاة عموم الناس فيها، ولكنهم لم يصرحوا بأنها لا تأخذ حكم المسجد، ويحتمل أن من نهى عن الصلاة فيها إنما أراد عدم مجاورة الظلمة ومن جعل الصف الأول من خارجها، وإن كانت تلي القبلة، فإنما أراد ألا يحرم العامة فضيلته.
أما المنارة، فجمهورهم يعطيها أحكام المسجد إن كانت متصلة به وبابها ينفذ فيه، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وخالفهم في ذلك المالكية،[82] وعلل المالكية لقولهم بأن لها اسما تختص به عن المسجد، ولأنها موضع متخذ لغير الصلاة. وعلل الجمهور لقولهم بأنها من شعار المسجد ومبنية لمصلحته مع اتصالها به.[83] قال النووي: “لَوْ دَخَلَ الْمُؤَذِّنُ الْمُعْتَكِفُ إلَى حُجْرَةٍ مُهَيَّأَةٍ لِلسُّكْنَى بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ وَبَابُهَا إلَى الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ وَإِنَّمَا قُلْنَا مَا قُلْنَا فِي الْمَنَارَةِ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لِإِقَامَةِ شِعَارِ الْمَسْجِدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ”[84] انظر إلى تفريقه بين ما بني لإقامة شعار المسجد وما بني لغير ذلك مما هو متصل به وينفذ إليه.
وأما رحبة المسجد فلها معنيان: أحدهما (ساحته وفناؤه) وما كان خارج المسجد محجرا عليه لأجله والآخر: صحنه. والرحبة بالمعنى الثاني من المسجد قطعًا، وبالمعنى الأول تأخذ أحكام المسجد عند الشافعية[85] وبعض المالكية وقول عند الحنابلة، ولا تأخذ أحكامه عند الحنفية[86] والمعتمد عند المالكية[87] والحنابلة[88]، ودليل الجمهور حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ” كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله r بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن”[89] واحتج به المخالف على العكس إذ لم يأمرهن بالعودة إلى البيوت وجعلهن يكملن اعتكافهن في الرحبة، واحتجاج الفريقين فيه وجاهة إن ثبت الحديث، والأرجح عدم ثبوته. واحتج الجمهور أيضا بنهي أبي هريرة عن صلاة الجمعة في الرحبة، وهي فتوى صحابي، ولكن الأثر لا يصح، وبإخراج عمر من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوته إلى الرحبة. وقال البخاري w: “وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد”[90] ودليل الشافعية مع ما تقدم أنها زيادة في المسجد لأجله، والزيادة تأخذ حكم المزيد.
وأما الخلوات، فهي أبنية تحيط بالمسجد وقد تنفذ إليه يستأجرها أحيانًا آحاد الناس للسكنى أو الاستغلال، وقد منع منها بعض أهل العلم كابن عابدين w لمنعهم تأجير بعض أجزاء وقف المسجد ولو للنفقة عليه، ولما تؤدي إليه من تقذير المكان.[91] والذي يترجح أن للخلوات حكم المقصورة إن كانت متصلة ببناء المسجد وتنفذ إليه.
يظهر من ذلك العرض السريع لبعض اتجاهات الفقهاء، أن المرافق المتصلة بالمسجد لا تأخذ حكمه عند الجمهور إلم تخصص للصلاة على التأبيد ولم تكن من شعاره كالمنارة، سيما إن استثنيت من وقف المسجد عند انعقاده، وإن كانت موقوفة على مصالحه أو مصالح أهله.
وفي بيان جواز اتخاذ هذه المرافق من ريع الوقف إن كانت لمصلحته، يقول ابن تيمية: “مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَنًا لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ. يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ بِمَصْلَحَتِهِ.”[92]
ولكن هذه المسألة من مواضع الخلاف وفيها تفصيل يطول، إن كانت لمصلحة أهله لا لمصلحته، فينصح القائمون على هذه الأوقاف بالتزام الشفافية التامة في جمع التبرعات وإنفاقها على تلك المرافق إبراء للذمة وقطعا لمادة النزاع.
وهذا الذي ظهر للباحث من عدم جريان أحكام المساجد على المرافق المتصلة بها هو ما رجحته اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية. وأذكر السؤال وجوابهم عليه تتميمًا للفائدة:
“س 1: إن المساجد في البلاد الغير إسلامية، تعتبر مراكز للدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ رسالة الإسلام، فهي لا تقتصر على إقامة الصلوات أو إقامة الدروس والمحاضرات فقط ثم تغلق، وإنما إطلاق مسمى المسجد غالبا في البلاد الغير إسلامية يطلق على المبنى الذي يقسم من الداخل إلى عدة أقسام: … وتكون هذه الأقسام متداخلة، ويكون مدخل المبنى واحدا، ولكن من الداخل، فقسم القاعات والغرف على الأقسام السالفة الذكر. وكذلك قد يستفاد من بعضها للبعض الآخر، مثلا: قد تمتلئ قاعات الصلاة فيصلي المصلون في الممرات، أو في بعض الغرف المجاورة، أو في المكتبة، أو المركز، وكذلك قد يستفاد من قاعات الصلاة للمدرسة. كذلك يقام في هذه المساجد ولائم العرس والعقيقة والأعياد … وسؤالنا بالخصوص: – هل يجوز بيع الأشرطة الإسلامية والكتب، وتأجير أشرطة الفيديو وغيرها في الأماكن المخصصة للمركز أو الأروقة التي حول قاعات الصلاة، مع الامتناع عن البيع أو الإعلان عن بيع داخل قاعات الصلاة (المسجد) ؟ – هل يجوز دخول الكافرين أو الكافرات إلى المركز أو المسجد؟ – هل يجوز دخول الحائض إلى المركز؟ … – تقوم بعض عوائل المسلمين بصنع أطباق طعام مختلفة، أو إحضار ما زاد عن حاجتهم من ملابس أو أدوات منزلية؛ لكي يقام معرض خيري تباع فيه هذه الأشياء لصالح المسجد ومرافقه، أو لدعم المسلمين في أنحاء العالم، مثلا: البوسنة والهرسك والصومال. . إلخ. فما رأيكم في إقامة هذه المعارض في قاعات الصلاة؛ لعدم سعة الأماكن الأخرى…؟
ج 1: اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة، بحيث يصبح وقفا لهذا الغرض، وما عدا هذا المكان من المرافق التي هي داخل المبنى العام يجوز فيها البيع والشراء وسائر الأعمال المباحة، من طبخ وأكل وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.”[93]
وخلاصة الكلام عن الفرع الأول حول ثبوت المسجدية أنها تثبت على الراجح بتصريح المالك جائز التصرف (أو كنايته مع النية) بالوقف المؤبد لبنيان أو جزء منه مفرز مسجدًا، ولا يدخل في ذلك ما استثني أو ما جرى العرف على عدم تخصيصه للصلاة، وإن اتصلت ببنيان المسجد ونفذت إليه.
الفرع الثاني: الفرق بين المصلى والمسجد؟ وهل لهذا الفرق أثر من الناحية العملية ؟
المصليات هي أماكن خصصت للصلاة ولكنها لم تكتمل فيها شروط المسجدية، ومنها تأبيد الوقف. ومن أمثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة – من غير وقف مؤبد – في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها. وفي حكمها مساجد البيوت أيضًا. وجمهور العلماء لا يجعلون لها أحكام المساجد. قال بدر الدين العيني w في البناية: “فإن قلت: ما حكم المساجد التي عند السواقي وعند الحياض. قلت: قال بعضهم حكمها حكم المسجد، والأصح أنها ليس لها حرمة المسجد.” [94] وقال ابن رجب w: “ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عندَ جمهور العلماء، فلا يمنع الجنب والحائض منها، خلافاً لإسحاق في ذَلِك”.[95] وعلل العيني w لذلك في مساجد البيوت فقال: “(لأنه لم يأخذ حكم المسجد) ش: لبقائه في ملكه، حتى له أن يبيعه ويهبه ويورث عنه، فكان حكمه حكم غيره من المنزل المملوك، فلا يكره المجامعة والبول في جوفه فضلا عن سطحه، وتسميته مسجدا لا يفيد حكم المساجد”[96] ومثل المساجد عند الحياض والسواقي – في رأي الباحث – تلك الغرف المخصصة للصلاة في الشركات والمصانع والأماكن العامة من غير وقف مؤبد، أي تحرير لها من ملك الخلق. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: المسجد: البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة، والموقوفة لذلك، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما، ولم يوقف للصلوات الخمس، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى…”[97] ولهم فتوى أخرى أذنوا فيها للقائمين على مشفى بتحويل الغرض من مصلى فيها.[98]
ولهذه المصليات إن كانت أوقفت على الصلاة وقفًا موقتًا حكم الأوقاف في هذه المدة دون حكم المساجد. وآثار القول بعدم إجراء أحكام المساجد على تلك المصليات كثيرة، فأحكام المساجد قد أفرد لها بالتأليف جماعة من أهل العلم، ومنها المتفق عليه والمختلف فيه، ومن أهم الآثار العملية لعدم ثبوت المسجدية لتلك المصليات أنه لا يصح الاعتكاف فيها ولا تجب التحية ولا يمنع فيها لبث الجنب ولا الحائض (عند الجمهور المانعين مكثها فيها) ولا يحرم البيع والشراء فيها ولا إنشاد الضالة، ولا يزول عنها ملك مالكها ويجوز له تحويلها لتستعمل في أغراض أخرى. لكن، إذا كان مسجد الناحية أو المدينة مصلى لم تكتمل له شروط المسجدية، فقد يفتى المسلمون بمراعاة آداب المساجد فيها حتى لا تنشأ ناشئة لا يعرفون تلك الآداب.
فائدة: هل المسجدية شرط لصحة الجمعة؟
قال بذلك المالكية. قال الشيخ الدردير w في الكلام عن شروط الجمعة: “… (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ فِي بَرَاحِ حَجَرٍ) أَيْ أُحِيطَ بِأَحْجَارٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى مَسْجِدًا”.[99] والجمهور لا يشترط المسجد لصحة الجمعة. قال ابن قدامة w: “وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ إقَامَتُهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَيَجُوزُ إقَامَتُهَا فِيمَا قَارَبَهُ مِنْ الصَّحْرَاءِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْبُنْيَانِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمِصْرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَأَشْبَهَ الْبَعِيدَ. وَلَنَا، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَمَّعَ بِالْأَنْصَارِ فِي هَزْمِ النَّبِيتِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ، وَالنَّقِيعُ: بَطْنٌ مِنْ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً، فَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ نَبَتَ الْكَلَأُ. وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، فَجَازَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ، كَالْجَامِعِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ عِيدٍ، فَجَازَتْ فِي الْمُصَلَّى كَصَلَاةِ الْأَضْحَى، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَلَا نَصَّ فِي اشْتِرَاطِهِ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ، فَلَا يُشْتَرَطُ.”[100]
وما ذكره عن الشافعية إنما يخص اشتراطهم أن تقام الجمعة في قرية، فهم أيضًا لا يشترطون المسجد. قال النووي w: “قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ إقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَجُوزُ فِي سَاحَةٍ مَكْشُوفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلْدَةِ مَعْدُودَةً مِنْ خُطَّتِهَا فَلَوْ صَلَّوْهَا خَارِجَ الْبَلَدِ لَمْ تَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ”[101]
وقول الجمهور هو الأظهر عند الباحث، لما ثبت من أنهم جمعوا في المدينة قبل بناء المسجد، ولأن الأصل عدم وجود الشرط، ولا نص عليه ولا معنى نص، كما ذكر ابن قدامة w.
فائدة: هل المسجدية شرط لصحة الاعتكاف؟
أما بالنسبة للرجال، فقد اتفقوا على ذلك، وأما النساء فالجمهور على اشتراط المسجدية لاعتكافهن، خلافًا للأحناف الذين استحبوا لها الاعتكاف في مسجد بيتها.[102]
ودليل الاشتراط للرجال والنساء قوله تعالى: “وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ” وعن عائشة – رضي الله عنها -: “السُّنَّةُ على المعتَكفِ أن لا يعودَ مريضًا ولا يشهدَ جنازةً ولا يمسَّ امرأةً ولا يباشرَها ولا يخرجَ لحاجةٍ إلَّا لما لا بدَّ منهُ ولا اعتِكافَ إلَّا بصومٍ ولا اعتِكافَ إلَّا في مسجدٍ جامِعٍ…”[103]
المطلب الثاني: إبدال المساجد
أجيب في هذا المطلب عن الأسئلة الآتية:
المسجد وقف، فهل يجوز نقل هذا الوقف واستبداله للمصلحة؟ كالانتقال إلى مسجد أوسع، أو أنسب موقعا، أو أيسر في مرافقه كسعة المواقف ونحوه؟ وهل يجوز تحويل المسجد القديم إلى صالة متعددة الأنشطة تابعة للمسجد بسبب إقامة مسجد جديد في نفس المنطقة أو قريب منها؟
قبل الشروع في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، ينبغي أن نؤكد على أن كلامنا هنا يتعلق بما ثبتت له المسجدية بأن أوقفه القائمون عليه مسجدًا وقفًا مؤبدًا، أما ما يطلق عليه اسم مسجد من غير أن تكتمل له شروط المسجدية بمعناها الخاص كما ذكرنا في المطلب السابق، فلا بأس إن رأى أكثر القائمين عليه مصلحة الجالية في نقله أن ينقلوه، ولكن يشترط أن يكون النقل إلى مكان قريب من الأول ليناسب الجالية ذاتها التي تبرعت للأول وأقيم لمنفعتها. ثم ينبغي أن نفرق بين استبدال المساجد التي خربت وتعطلت منافعها وتلك التي لم تتعطل منافعها ولكن يرجى أن تبدل بما هو أصلح منها لحاجات أهلها، كأن تكون أوسع أو ذات مرافق أو لها مواقف سيارات تفي بحاجة عمارها، إلخ. وأذكر عند عرض مذاهب العلماء ما ذكروا بشأن التحويل اليسير لمكان المسجد لأجيب هنا أيضًا عن جواز تحويل المسجد القديم إلى صالة متعددة الأنشطة تابعة للمسجد بسبب إقامة مسجد جديد في نفس المنطقة أو قريب منها؟
الحالة الأولى: المساجد التي خربت وتعطلت منافعها
المساجد التي خربت وتعطلت منافعها كأن يكون بنيانها قد تساقط ويعسر إعادة عمارتها أو تبين وجود مواد ضارة بأساسها أو بعض مرافقها، أو رحل المسلمون من جوارها.
ذهب الأحناف[104] والمالكية[105] والشافعية[106] إلى أن المسجد لا ينقل وإن خرب وتعطلت منافعه، ووقع بعض الخلاف داخل هذه المذاهب ولكن القول بعدم نقل المسجد هو المعتمد عندهم بلا شك. وقال محمد بن الحسن من الحنفية إن المسجد إذا خرب عاد إلى ملك الواقف.[107]
أما الحنابلة، فذهبوا إلى جواز إبدال المسجد الذي خرب وتعطلت منافعه بغيره. قال ابن قدامةw: “وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْفَ إذَا خَرِبَ، وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ، كَدَارٍ انْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضٍ خَرِبَتْ، وَعَادَتْ مَوَاتًا، وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهَا، أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ، وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ، أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ، جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، بِيعَ جَمِيعُهُ… وَقَالَ [أَحْمَدُ] فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: يُحَوَّلُ الْمَسْجِدُ خَوْفًا مِنْ اللُّصُوصِ، وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ قَذِرًا. قَالَ الْقَاضِي: يَعْنِي إذَا كَانَ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ…”[108] وقال الرحيبانيw: “… (فَإِذَا زَالَتْ) تِلْكَ الصُّورَةُ [صُورَةِ الْمَسْجِدِ] بِانْهِدَامِهَا، وَتَعَطُّلِ مَنَافِعِهَا؛ (عَادَتْ الْأَرْضُ إلَى حُكْمِهَا) الْأَصْلِيِّ، (مِنْ جَوَازِ لُبْثِ جُنُبٍ) فِيهَا، (وَعَدَمِ صِحَّةِ اعْتِكَافٍ)؛ لِزَوَالِ حُكْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ عَنْهَا …”[109]
وقد وقفت للسادة الحنفية والحنابلة على كلام نفيس يفيدنا في جواب السؤال عن تحويل المسجد القديم إلى صالة متعددة الأنشطة تابعة للمسجد إذا كانا متجاورين كأن يشتري الناس أرضًا ملاصقة للمسجد القديم ليقيموا عليها آخر أكبر منه ويستعملوا القديم في أغراض أخرى. ففي حاشية ابن عابدين: ” … فِي التَّتَارْخَانِيَّة سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْمَسْجِدَ رَحْبَةً وَالرَّحْبَةَ مَسْجِدًا أَوْ يَتَّخِذُوا لَهُ بَابًا أَوْ يُحَوِّلُوا بَابَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَأَبَى الْبَعْضُ ذَلِكَ قَالَ إذَا اجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ لَيْسَ لِلْأَقَلِّ مَنْعُهُ. اهـ. قُلْت وَرَحْبَةُ الْمَسْجِدِ سَاحَتُهُ، فَهَذَا إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ جَعْلَ بَعْضِهِ رَحْبَةً فَلَا إشْكَالَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جَعْلَ كُلِّهِ فَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْوِيلُهُ بِجَعْلِ الرَّحْبَةِ مَسْجِدًا بَدَلَهُ.”[110] لاحظ أن الرحبة ليس لها أحكام المسجد عند الحنفية، ففي تجويز جعل الرحبة مسجدًا والمسجد رحبة ما يفيدنا في مسألتنا. واختلف الحنابلة في التحويل اليسير لموضع المسجد لحاجة الناس ودون تعطل منافعه ففي الشرح الكبير: “)فصل) قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك ينظر إلى قول أكثرهم واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل، وسماه مسجداً قبل بنائه تجوزا لأن مآله إليه، أما بعد بنائه لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك والأول أصح وأولى … وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.”[111] لاحظ أن المنارة لها أحكام المسجد عند أحمد إن كانت متصلة به، فتجويزه نقضها لتحصين المسجد دلالة على جواز التصرف اليسير في بنيان المسجد.
الحالة الثانية: المساجد التي لم تتعطل منافعها
الحالة الثانية: المساجد التي لم تتعطل منافعها ولكن يرجى أن تبدل بما هو أصلح منها لحاجات أهلها، كأن تكون أوسع أو ذات مرافق أو لها مواقف سيارات تفي بحاجة عمارها، إلخ.
لعله لا حاجة لنا هنا لذكر كلام الجمهور، فمن لم يأذن في نقل المساجد وإبدالها إن خربت، فلن يأذن فيه دون خرابها من باب أولى. ولكن يتجه أن ننظر فيما إذا كان الحنابلة يأذنون في إبدال المساجد التي لم تخرب بالكلية أم لا.
اختلف الحنابلة في تحويل عرصة المسجد للمصلحة الراجحة، ففي الشرح الكبير: “فإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل الوقف لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع ما يضيع المقصود وإن قل اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاً فيكون وجوده كالعدم.”[112]
ولكن ابن تيمية ناقش المانعين فقال: “فَيَجُوزُ تَغْيِيرُ بِنَاءِ الْوَقْفِ مِنْ صُورَةٍ إلَى صُورَةٍ؛ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. وَأَمَّا إبْدَالُ الْعَرْصَةِ بِعَرْصَةِ أُخْرَى: فَهَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِهِ اتِّبَاعًا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ r حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرَ وَاشْتُهِرَتْ الْقَضِيَّةُ وَلَمْ تُنْكَرْ… وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ اللَّاصِقَ بِأَرْضِ إذَا رَفَعُوهُ وَبَنَوْا تَحْتَهُ سِقَايَةً وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْجِيرَانُ: فُعِلَ ذَلِكَ. لَكِنْ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ مَنْعِ إبْدَالِ الْمَسْجِدِ وَالْهَدْيِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لَكِنَّ النُّصُوصَ وَالْآثَارَ وَالْقِيَاسَ تَقْتَضِي جَوَازَ الْإِبْدَالِ لِلْمَصْلَحَةِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.”[113] ولعل النص المشار إليه عن أحمد، هو ما نقله أبو يعقوب المروزي في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: “قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟ قال [أحمد]: أليس مسجد الكوفة حول حين نقب بيت المال؟ قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.”[114]
الأدلة
أدلة المانعين من نقل المساجد وإبدالها:
- قوله تعالى: “وأن المساجد لله” وقد أخرج الواقف الموقوف من ملكه إلى ملك الله فلا يعود فيه كما لا يعود في صدقته، ولأنه إزالة الملك لا إلى أحد فلا تحتمل إلا التأبيد، فليس لأحد عليها سلطان. وقد يجاب عن ذلك أنها ملك لله قد رصد لانتفاع عباده فيبتغى ما هو أصلح لهم إن تعطلت منافعه أو كان لا يفي بحاجات أهله، ولعله يشترط لذلك كما اشترط البعض أن يكون بإذن السلطان أو من يحل محله في البلاد غير الإسلامية.
- قوله r لعمر: ” إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها” ولا يكون تحبيسًا إلا بالتأبيد وفهم ذلك عمر t، قال الراوي: قال: “فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث…”[115] ولم يرد أن الصحابة وقتوا مدة لشيء من أوقافهم أو استردوا شيئًا منها. والجواب على ذلك بأن الأمر جاء بعد سؤال فهو أمر إرشاد وعمل عمر والصحابة لا يفيد المنع من غيره، ويجاب بأن محل النزاع ليس في الاسترداد فلم يقل به أحد سوى محمد بن الحسن w ولكن في الإبدال بما يتحقق به نفع المسلمين.
- ولأنها السنة الجارية من صدر الأمة. في المدونة: “أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَجُوزُ فِيهَا مَا أَغْفَلَهُ مَنْ مَضَى، وَلَكِنْ بَقَاؤُهُ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. وَبِحَسْبِكَ حُجَّةٌ فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَ مُتَقَادِمًا بِأَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا جَرَى الْأَمْرُ عَلَيْهِ.”[116] ويجاب عليه بوقوع الخلاف فيه كما سيأتي.
- ولأنه يستحيل أن تنعدم منفعته بالكلية: “وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَصَلَاةٍ وَاعْتِكَافٍ فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ وَطَبْخِ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ لَهُ بِحُصُرِهِ وَجُذُوعِهِ.”[117]
- وإن عجز الناس في وقت عن الانتفاع به، فيمكن لمن بعدهم ذلك فينبغي أن يترك مَا يَكُونُ عَلَمًا لَهُ لِئَلَّا يُدْرَسَ أَثَرُهُ.”[118]
أدلة المجوزين لنقل المساجد إن خربت وإبدالها:
أجابوا عن أدلة المانعين بما ذكرنا أعلاه، ولهم:
- ما اشتهر عنْ عمرٍ رضي الله عنه أنَّه كتبَ إلى سعدٍ لما بلغهُ أنَّه قدْ نُقِبَ بيتُ المالِ الذي بالكوفةِ : “أنْ انقل المسجدَ الذي بالتمارين، واجعلْ بيتَ المالِ في قبلةِ المسجدَ، فإنه لن يزالَ بالمسجدِ مصلٍ.” قال الزركشي الحنبلي: “وهذا بمحضر من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فيكون إجماعا”[119] وهذا الدليل حجة للقائل بالإبدال للمصلحة الراجحة أيضًا. ولكن الأثر موقوف على القاسم حفيد عبد الله بن مسعود، فقد رواه الطبراني فقال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ بَنَى سَعْدٌ الْقَصْرَ، وَاتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ، فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا وَلِيَ عَبْدُ اللهِ بَيْتَ الْمَالِ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ لَا تَقْطَعْهُ، وَانْقُلِ الْمَسْجِدَ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي»[120] قال الهيثمي في مجمع الزوائد: “القاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح.”[121] أقول: هو من رواية الحفيد الثقة عن جده، ومثله يشتهر بين، فلا بأس أن يعتضد به في الاستدلال.
- ومن المعقول أنه “تجب المحافظة على صورة الوقف ومعناه، فلما تعذر إبقاء صورته، وجبت المحافظة على معناه.”[122]
الترجيح
الذي يظهر للباحث هو رجحان قول الحنابلة بأن المسجد إن خرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره ليفي بحاجات الناس، فليس هناك دليل ظاهر على المنع، وهو الموافق للمعقول، والشريعة مبناها على المصلحة في المعاش والمعاد والعاجل والآجل، وقد اشتهرت قصة نقل عمر لمسجد التمارين ولم تنكر، على ما في سندها من مقال يجعلها مما لا يستدل به استقلالًا. والجواب عليها بأنه إنما أمر بنقل بيت المال لا يظهر.
وهناك أحوال لا ينبغي أن يختلف عليها في الغرب، كما لو هجر المسلمون قرية، فلا يسوغ أبدًا أن يتركوا مساجدهم يستولي عليها غيرهم، أو تصير خرابات يتأذى منها الناس أو تكلفهم أعباء رعايتها دون أن ينتفع بها أحد. وممن جوز بيعها في تلك الأحوال من يقول من حيث الأصل بقول الجمهور كفضيلة الشيخ القاضي محمد تقي العثماني، فقد وجه إليه المسلمون بمنطقة واشنطن سؤالا عن بيع المساجد وإبدالها، فناقش أقوال أهل العلم ورجح رأي الجمهور إلا أنه قال: “ولكن المسألة لما كانت مجتهدا فيها، وفي كلا الجانبين دلائل من الكتاب والسنة، فلو خيف الاستيلاء من قبل الكفار على مسجد ارتحل عن جواره أهله، ولم يرج عود المسلمين إلى ذلك المكان، ففي مثل هذه الضرورة الشديدة، يبدو أنه لا بأس بالأخذ بقول الإمام أحمد أو محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى…”[123]
أما إبداله بما هو خير منه، فيرجع الأمر إلى وفاء المسجد الأول بحاجة أهله التي من أجلها أوقفوه، وعدم وجود الحاجة الماسة كما في أثر مسجد التمارين، على ما في سند القصة من مقال يجعل التوسع في معارضة الأصل بها غير رشيد، فإن وفى المسجد فلا يبدل بغيره، وهو قول الجماهير ولم يخالف فيه إلا بعض الحنابلة، فإن الأصل تأبيد أوقاف المساجد في محالها، وحتى تبقى للمساجد حرمتها، ولقطع مادة النزاع فلن يخلو الأمر من فريق من الناس يكون الأول أحب إليهم من الثاني. وهناك ملحظ آخر مهم، وهو أن المسلمين في الغرب ينتقلون إلى جوار المساجد ليتيسر لهم التردد عليها، فإن علم أنها لا قرار لها، فقد يزهد في ذلك الناس ويكون من ذلك ضرر عظيم. فإن كان المسجد لا يفي بحاجة أهله، أو يشق عليهم جدًا الإبقاء عليه لتهاوي بنيانه، فقد يبدلونه بمسجد قريب منه حفاظًا على مقصود الواقفين من جعل المسجد في تلك الناحية.
أما الإبدال بمعنى شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين، فلا بأس به كما تقدم عند الحنفية والحنابلة، ولعله الصواب لسلامته من المحاذير المتوقعة عند نقل عرصته إلى مكان آخر.
ويشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس وتطيب به نفوس أكثرهم، فإن اعتبار الكثرة هنا هو الموافق لقاعدة الشورى التي أمر الله بها ولا يتم العدل ولا تنهض الأمم بغيرها، وهو مما قرره علماؤنا – رحمهم الله. قال ابن عابدين w: “فِي التَّتَارْخَانِيَّة سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْمَسْجِدَ رَحْبَةً وَالرَّحْبَةَ مَسْجِدًا أَوْ يَتَّخِذُوا لَهُ بَابًا أَوْ يُحَوِّلُوا بَابَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَأَبَى الْبَعْضُ ذَلِكَ قَالَ إذَا اجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ لَيْسَ لِلْأَقَلِّ مَنْعُهُ.”[124] وفي الشرح الكبير على متن المقنع: “)فصل) قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك ينظر إلى قول أكثرهم.”[125]
كما يشترط عند النقل ألا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرط في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: “… يبقى المسجد القائم على وضعه كما هو، ولا يجوز أن يتعرض له بهدم أو غيره حتى يتم بناء مسجد بدلا منه في الأرض الحكومية المجاورة للمسجد المقترحة لبناء المسجد فيها لكبرها، وبقية أرض المسجد القائمة حاليا تكون بعد هدمه تابعة للمسجد الجديد.”[126]
المطلب الثالث: تسجيل ملكية المساجد ورهنها
أجيب في هذا المطلب عن الأسئلة الآتية:
ما حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع بالمبنى ليكون مسجدا لكنه يريد بقاء اسمه لضمان ألا تسيء إدارة المسجد التصرف فيه؟ وهل يجوز الموافقة على ارتهان المسجد إذا لم يسدد ثمنه بالكامل؟ وما حكم رهن المسجد لدى شركات التمويل من أجل الحصول على تمويل لشراء مسجد أوسع علما بأن المسجد القديم يظل مفتوحا للصلاة فيه فقط، وتضمن شركة التمويل ألا يتم بيعه حتى سداد قيمة المسجد الجديد؟
الفرع الأول: حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع
ما حكم تسجيل ملكية المسجد لدى الجهات الرسمية باسم الشخص المتبرع بالمبنى ليكون مسجدا لكنه يريد بقاء اسمه لضمان ألا تسيء إدارة المسجد التصرف فيه؟
قال الله تعالى: “وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا” فمن شروط المسجدية خلوص الملكية لله تعالى، ولذلك لا تتم الوقفية إلا بإفراز العين عن ملك صاحبها وتحريرها منه بالكلية. وتسجيل العين باسم المتبرع ينافي ما ذكرنا، ولكن إن كان له غرض صالح، جاز أن يشترط عند الوقف أن يكون ناظره، فيسجل ذلك عند الجهات الرسمية بأن يجعل نفسه المسؤول الوحيد أمامها عن الجمعية المتصرفة في العين الموقوفة، وهذا هو الأصل فإن الولاية على الوقف تثبت للواقف ما دام حيا، ولمن يعينه نيابة عنه، وقد روى أبو داود والبيهقي أن عمر t أوصى بأن “تكون الولاية على أرضه الموقوفة بخيبر إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من آل عمر”. ولكن لا بد أن يعلم أن هذا المنحى، وإن صح لبعض الناس الذين يتكفلون ببناء المساجد وإعمارها، فإنه سيزهد عموم الناس عن التبرع لتلك المساجد.
الفرع الثاني: وهل يجوز الموافقة على ارتهان المسجد إذا لم يسدد ثمنه بالكامل؟
قد يكون السؤال هنا عن وقف المرهون أو رهن الموقوف، وأظنه عن وقف المرهون، وأجيب في السؤال التالي – إن شاء الله – عن رهن الموقوف. وتصور المسألة هو تلك الحالة التي يشترى فيها المبنى المنتظر وقفه مسجدًا بالتقسيط، فيندر ألا يشترط البائع رهن المبنى أو ما يكافئه حتى ينتهي المشتري من سداد الأقساط، وفي هذه الحالة يضطر المسلمون إلى ذلك، فلا بأس من شرائهم للمبنى مع هذا الشرط، ولكن هل يجوز لهم وقفه مسجدًا قبل سداد الأقساط وفك الرهن؟ قال الحنفية[127]: نعم يصح للراهن وقف المرهون، وقال المالكية[128] والشافعية[129] والحنابلة[130]: لا يصح.
وحجة الأحناف أن المرهون ملك للراهن فجاز له وقفه، وقال الجمهور بأنه تعلق به حق للغير فليس الملك باتًا ليصح وقفه، وأجاب الأحناف بأن حق المرتهن محفوظ، فإن كان الراهن موسرًا ألزم بسداد باقي الأقساط من ماله دون إبطال الوقف، وإن كان معسرًا أبطل الوقف وبيع ليقضى ما على الراهن للمرتهن.[131]
والراجح عند الباحث هو قول الجمهور، فإن المساجد يشترط – على الأصح – التأبيد في وقفها، فلا ينبغي فعل ذلك مع وجود الاحتمال بعدم القدرة على فك الرهن، والمقصود من وقفها تحريرها من ملك كل الخلق وتخليصها لله على التأبيد، فكيف يحررها ويخلصها من لم تخلص له بعد؟ فالذي أراه ألا يضيق المسلمون على أنفسهم بوقف ما لم يتم لهم ملكه من غير تعلق حقوق للغير به، ولهم أن يصلوا فيه ما شاؤوا وأن يجمعوا – كما سبق – ولكن لا يوقفونه مسجدًا حتى ينتهوا من دفع أقساطه.
الفرع الثالث: وما حكم رهن المسجد لدى شركات التمويل من أجل الحصول على تمويل لشراء مسجد أوسع علما بأن المسجد القديم يظل مفتوحا للصلاة فيه فقط، وتضمن شركة التمويل ألا يتم بيعه حتى سداد قيمة المسجد الجديد؟
هذه المسألة عكس سابقتها، فالسؤال هنا عن مسجد موقوف يراد رهنه لتأمين شراء مبنى آخر أفضل منه ليكون مسجدًا بدلا من الأول أو بالإضافة إليه. والتكييف الفقهي لهذه المسألة هو رهن الموقوف. وقد اتفق العلماء من المذاهب الأربعة (الحنفية[132] والمالكية[133] والشافعية[134] والحنابلة[135]) على عدم جواز رهن الموقوف، وصرح الشافعية بتفسيق من يفعله[136]، ولم أقف لأحد الأئمة المجتهدين على التصريح بخلافه.
ودليل المنع أن الرهن توثقة دينٍ بعين يستوفى الحقُ منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، والرهن قد يبطل لانشغال المحل بالوقف فيضيع حق المرتهن أو يؤول إلى تضييع العين الموقوفة وهو غير جائز. والملاحظ أنهم في الغالب يراعون في المنع حق المرتهن لأنهم سيبطلون الرهن ويبقون الوقف، أما في البلاد التي لا يوجد فيها قضاء إسلامي، فالذي ينبغي أن يمنع رهن الموقوف لأجله هو حق الوقف، لأن القضاء سيحكم بالمرهون للمرتهن إن عجز الراهن عن سداد ما عليه، ولن يردهم عن ذلك أن المرهون مسجد. بقي أننا لو أجزنا الإبدال حينما يخرب المسجد الأول أو لا يفي بحاجة أهله – بشروطه التي ذكرناها في المطلب السابق – فعندها نجوز بيعه، فيجوز رهنه من باب أولى لمصلحة شراء بدله، وذلك عند ضمان بقاء أحدهما وقفًا، فأنت ترى تعليلهم للمنع من الرهن بعدم جواز بيع الموقوف، فمن أجاز بيعه عند عدم وفائه بحاجة أهله أجاز رهنه لمصلحة شراء بدله.
المطلب الرابع: تمويل بناء المساجد
أجيب في هذا المطلب عن الأسئلة الآتية:
ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟ وما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مركز إسلامي عند تعين الحاجة وشح الجالية؟ وما حكم أخذ قرض ربوي أو قرض حسن لعمل مشروع استثماري لصالح المركز مع ضمان المركز مقابل هذا القرض؟ وما حكم الاقتراض الربوي لاستكمال شراء المسجد عند الخوف من ضياع المشروع بالكلية؟
سأقسم هذا المطلب إن شاء الله على ثلاثة أفرع، فأجعل جواب كل سؤال في فرع إلا أنني سأضم السؤال الرابع إلى الفرع الثاني لتعلقه به. فتكون الفروع كالآتي:
الفرع الأول: ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟
الفرع الثاني: ما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مركز إسلامي عند تعين الحاجة وشح الجالية؟ وما حكم الاقتراض الربوي لاستكمال شراء المسجد عند الخوف من ضياع المشروع بالكلية؟
الفرع الثالث: ما حكم أخذ قرض ربوي أو قرض حسن لعمل مشروع استثماري لصالح المركز مع ضمان المركز مقابل هذا القرض؟
الفرع الأول: ما حكم قبول التبرعات لبناء المساجد من أصحاب المكاسب المختلطة أو المحرمة؟
المساجد بيوت الله في الأرض وخير بقاعها، وقد مدح الله عمارها فقال: “إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ”. التوبة:18، ووعدهم بالجزاء العظيم الوافر من خزائنه التي لا تنفد، فعن رسول الله r: “مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ”.[137] وعمارة المساجد تدخل في الصدقة الجارية، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ”.[138]
ولا شك أن الأصل في عمارة المساجد أن تكون بأطيب الأموال تشريفًا لبيوت الله وتعظيمًا لها، ولكن هل يحرم قبول تبرعات أصحاب المكاسب المختلطة والمحرمة في بنائها؟
أولا: الكلام هنا ينصرف إلى ما تملكه صاحبه بعقد محرم أو معاملة محرمة، ككسب المغنية وثمن الخمر، أو الذي لم يدخل في ملكه كالمال المغصوب والمسروق إذا ما استحال رده إلى صاحبه أو ورثته. أما ما أمكن رده إلى أصحابه من الصنف الأخير، فسبيل الخروج منه هو رده إليهم، وذلك بلا خلاف.
ثانيًا: اعلم أنه بخلاف قول للشافعية في إمساك المال المغصوب والمأخوذ ظلمًا وعدم التصرف فيه حتى يرد إلى صاحبه، فإن العلماء متفقون على مشروعية التخلص من هذه الأموال في أوجه البر، إن عجز عن ردها إلى أصحابها، على تفصيل في مصارفها، ولهم في حل بناء المساجد منها مذهبان: قال الجمهور بإباحة ذلك، ولم يفرقوا بين المسجد وسائر أوجه البر، وهذا قول لبعض الأحناف والشافعية والمالكية وهو المذهب عند متأخري الحنابلة، وقال بعض أهل العلم بعدم جواز جعل شيء من هذه الأموال في بناء المساجد وعمارتها تنزيهًا لها عن المال الخبيث، وهو قول ابن القاسم ومن تابعه من المالكية وبعض أتباع المذاهب الأخرى، ومن المعاصرين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية. [139] وخلافًا لطريقتي في نقل نصوص أهل العلم إلى الهوامش مراعاة للاختصار، أوردها هنا لتأمل القارئ لأن الخلاف فيها داخل المذاهب، مما يصعب من تحرير المعتمد في كل مذهب.
قول السادة الحنفية
قال ابن عابدين w: “لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ اهـ”[140] ولم أجد التفريق بين المساجد وغيرها من مصارف الصدقة فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية، لذا فالظاهر هو تجويزهم التخلص من المال بصرفه في وجوه الصدقة، ولكن ينبغي ألا يفهم من قولهم “التصدق” أنهم يعدون التخلص نوعًا من الصدقة، ولكنهم أرادوا بيان مصرف المال، فإنهم قد شددوا في عدم عده من الصدقة حتى كفروا من رجا ثواب الصدقة بالمال الحرام، ففي الحاشية أيضًا: “وَفِيهِ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الظَّهِيرِيَّةِ: رَجُلٌ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مِنْ الْمَالِ الْحَرَامِ شَيْئًا يَرْجُو بِهِ الثَّوَابَ يَكْفُرُ، وَلَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُ وَأَمَّنَ الْمُعْطِيَ كَفَرَا جَمِيعًا. وَنَظَمَهُ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَفِي شَرْحِهَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ أَجْنَبِيًّا غَيْرَ الْمُعْطِي وَالْقَابِضِ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ وَمِنْ الْجُهَّالِ فِيهِ وَاقِعُونَ. اهـ. قُلْت: الدَّفْعُ إلَى الْفَقِيرِ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ بَنَى مِنْ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ مَسْجِدًا وَنَحْوَهُ مِمَّا يَرْجُو بِهِ التَّقَرُّبَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ رَجَاءُ الثَّوَابِ فِيمَا فِيهِ الْعِقَابُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِاعْتِقَادِ حِلِّهِ.”[141]
قول السادة المالكية
قال ابن رشد (الجد) w: “وقد قيل إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين، فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال الحرام المجهول أصله.”[142] ولكنه لم يقطع بذلك القول، وروى في نفس الكتاب خلافه عن ابن القاسم، فقال: “وذكر أن ابن القاسم كان في جواره مسجد بني من الأموال الحرام، فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى أبعد منه ولا يراه واسعا لمن صلى فيه. والصلاة عظم الدين، وهذا أحق ما احتيط فيه.”[143] وقد ذكر القرطبي في تفسيره ما يشعر بأن المالكية يجوزون بناء المساجد من تبرعات أصحاب الأموال المحرمة، فقال: “… فَإِنْ أَحَاطَتِ الْمَظَالِمُ بِذِمَّتِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُطِيقُ أَدَاءَهُ أَبَدًا لِكَثْرَتِهِ فَتَوْبَتُهُ أَنْ يُزِيلَ مَا بِيَدِهِ أَجْمَعَ إِمَّا إِلَى الْمَسَاكِينِ وَإِمَّا إلى ما فيه صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ”[144]
قول السادة الشافعية
قال النووي w في المجموع: “قَالَ الْغَزَالِيُّ إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ … وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ … وهذا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ ونقله الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ “[145]
قول السادة الحنابلة
قال ابن تيمية w في السياسة الشرعية: “… إذْ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ – إذَا لَمْ يُمْكِنْ معرفة أصحابها وردها عَلَيْهِمْ، وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِمْ – أَنْ يَصْرِفَهَا – مَعَ التَّوْبَةِ إنْ كَانَ هُوَ الظَّالِمَ – إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.”[146] وقال ابن مفلح في الفروع: “وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ عَجَزَ دَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ”.[147] فالحنابلة يجعلون مصرف هذا المال كمصرف الفيء وأوجه البر ولم أقف على من منع منهم الإنفاق منه على عمارة المساجد.
الأدلة والترجيح
مما استدل به المانعون ويستدل به لهم ما يأتي:
- استدلوا بمجموعة من الآيات والأحاديث في الزجر عن المال الحرام وعدم تقبل الله إلا للطيب، ومنها: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ…” [البقرة: 267] وقوله: “إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ” [المائدة: 27] وقوله r: “إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب “[148] وقوله r: “من جمع مالًا حرامًا، ثم تصدَّقَ به، لم يكن له فيه أجرٌ، وكان إِصرُه عليه”[149].. ولن نطيل النفس في عرض هذه الأدلة، فلا يتسع المقام لذلك، ولا نزاع فيها ولكنها ليست صريحة على المطلوب، فنحن بصدد مال اكتسبه صاحبه بالفعل من الحرام ويريد أن يتخلص منه أو من بعضه دون أن يكون له ثواب الصدقة. ولكن من ظن أنه يتصدق بمال حرام فيعفيه ذلك من التوبة، فلا بد أن يذكر بهذه النصوص، ولا بد من إشاعة العلم بها في الناس.
- واستدلوا بأن المساجد بيوت الله، أضافها إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف فقال: “إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ” وما أضيف الي الله لا يكون إلا طيبا، والمال الحرام خبيث ليس بطيب، فلا ينبغي إدخاله في بناء بيوت الله. والجواب أن الحرام لكسبه يكون خبيثًا فقط لمكتسبه من الحرام.
- واستدلوا بأن العرب في جاهليتها حرصوا على ألا يدخل في بناء الكعبة درهم حرام، ففي سيرة ابن هشام أن أبا وهب قال: “يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا تدخلوا فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس.”[150] والجواب أن فعلهم ليس حجة، وإن كان المقصود أن المسلمين أولى منهم بتعظيم الشعائر، فيقال إن طرق التعظيم تثبت بالشرع، وقد يقال أيضًا إن الكعبة والمساجد الثلاثة لا كغيرها من المساجد فقد يتشدد فيها أكثر.
- وقالوا إنه ليس كل ما جاز صرفه للمساكين جاز للمساجد، فبيوت الله في غنى عن المال الخبيث. والتفريق في مصارف المال حسب طيبه وخبثه قد ورد في السنة فعن رجل من الأنصار، قال: “خَرجنا معَ رسولِ اللَّهِ r في جَنازةٍ … فلمَّا رجعَ استقبلَهُ داعي امرأةٍ فجاءَ وجيءَ بالطَّعامِ فوضعَ يدَهُ، ثمَّ وضعَ القومُ، فأَكَلوا، فنظرَ آباؤُنا رَسولَ اللَّهِ r يَلوكُ لُقمةً في فمِهِ، ثمَّ قالَ: أجِدُ لَحمَ شاةٍ أُخِذَت بغَيرِ إذنِ أَهْلِها، فأرسلَتِ المرأةُ، قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَرسلتُ إلى البقيعِ يشتري لي شاةً، فلم أجد فأرسلتُ إلى جارٍ لي قدِ اشترى شاةً، أن أرسل إليَّ بِها بثمنِها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأتِهِ فأرسلت إليَّ بِها، فقالَ رسولُ اللَّهِ r: أطعِميهِ الأُسارَى.”[151]
واستدل المجيزون بالآتي:
قال النووي w في معرض الاستدلال للجواز: إن المال يكون حرامًا على مكتسبه من حرام “وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا”[152]
وقال w كذلك في تعليل صرف المال في المصالح: ” لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ”[153]
والذي يترجح عندي هو جواز أخذ هذه الأموال وإنفاقها على المساجد من حيث الأصل، فإن المال غير المحرم لعينه يكون محرمًا لكسبه فتكون الحرمة على من اكتسبه من حرام، ولا تتعدى الحرمة إلى ذمة من انتقل إليه المال بعد ذلك بسبيل مباح كالبيع والإجارة والهبة والوقف. ألا ترى أن النبي قد بايع اليهود وأموالهم فيها الربا والسحت. إذا تقرر هذا الأصل في الأموال المحرمة، فقد نغلب أحيانًا مصلحة الزجر عن أكل الحرام، فنمتنع من قبولها، سيما إن خشي أن يعتقد بعض العوام أن لهم في الصدقة ببعض أموالهم مندوحة عن التوبة والانزجار عن أكل الحرام، وقد نغلب مصلحة التأليف سيما إن كان المتصدق غير مكابر ورجيت توبته بقبول صدقته أو خشيت فتنته عن الدين بالكلية بردها، فالمسألة إذًا – بعد تقرير أصلها – من مسائل السياسة الشرعية التي تحتاج إلى بصيرة لضبط المصحة الراجحة فيها.
فائدة: وقف الكافر على المسجد
أناقش هذه المسألة وإلم ترد في السؤال لأنها مما تمس الحاجة في هذه البلاد إلى تحرير القول فيه.
اعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في قبول وقف الكافر على المساجد على قولين.
- القول الأول: يصح وقف الكافر للمسجد، وبهذا قال الشافعية[154] والحنابلة[155].
- القول الثاني: لا يصح وقف الكافر للمسجد، وبه قال الحنفية (إلا للأقصى) [156] وبعض المالكية[157].
الأدلة والترجيح
استدل المانعون بأن الوقف عبادة لأن الواقف إنما يرجو الثواب، والكافر لا تقبل منه هذه العبادة مع كفره بالله تعالى. وبأن الله قال: “إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ” وأجيب بأنها في المسجد الحرام خاصة ولكنه قبلة المسلمين فعبر عنه بالجمع، والأقوى أن يقال إن العمارة المقصودة هنا ليست فقط بالبناء، ولكن بالصلاة فيه وذكر الله، والممنوع أن يكون للكافر سلطان على المسجد.
واستدل المجيزون على قولهم بأن الوقف صدر ممن يصح تبرعه وبيعه وشراؤه فوقفه كذلك. وليس الوقف قربة محضة. وذكروا أن الكافر يثاب على صدقاته في الدنيا، فقد أخرج مسلم عن أنس t قال: قال رسول الله r: “… وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا “
والخلاصة أن الكافر قد يريد بوقف المسجد أن يكون له عليه سلطان أو تدخل في شؤونه، فإن كان كذلك رد الوقف، وإلا فالأصح قبوله منه. وهذا الخلاف إنما وقع في الوقف، ولكن تبرع الكافر للمسلمين أو لبعضهم غير وقفه، فهذا لا يعدو أن يكون هدية لهم، وقد قبل رسول الله هدايا الكفار وقال الإمام البخاري w في صحيحه: “باب قبول الهدية من المشركين”. وإن كان في الباب ما يخالفه كحديث عياض بن حماد وغيره، فهو محمول على سوء قصد المهدي وادعي نسخه،[158] وأحاديث قبول الهدايا من الكفار أكثر وأسند، وهي الأصل، وسواها يحمل على بعض الأحوال التي يترجح فيها رد هديتهم.
الفرع الثاني: ما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مركز إسلامي عند تعين الحاجة وشح الجالية؟ وما حكم الاقتراض الربوي لاستكمال شراء المسجد عند الخوف من ضياع المشروع بالكلية؟
لقد اتفقت الأمة على حرمة الربا وكونه من كبائر الذنوب. وجاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: “والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي (الاستغلالي)، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة.”[159] ولا تتخيل الضرورة في مسألتنا هذه حتى نبيح للناس الاقتراض بالربا من أجل بناء المساجد. أما عند الخوف من ضياع المشروع وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه وانسداد كل السبل أمام الجالية بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى، فقد يحتمل الأمر تجويز الاقتراض بالربا، ولكن الباحث يتوقف في ذلك ولا يبت فيه وينصح بعرض هذه النوازل على أهل العلم حال حدوثها.
الفرع الثالث: ما حكم أخذ قرض ربوي أو قرض حسن لعمل مشروع استثماري لصالح المركز مع ضمان المركز مقابل هذا القرض؟
أما أخذ القرض الربوي، فقد سبق بيان المنع من ذلك في الفرع السابق، وإن كان لحاجة بناء المسجد نفسه. وأما القرض الحسن، فقد يكون مع رهن المسجد ومن غير ذلك، فإن اقتضى الرهن فقد سبق الكلام عن رهن المساجد في المطلب السابق، وإن كان الاقتراض من غير رهن الوقف فتكييف المسألة هو الاستدانة للوقف مع استرداد القرض من غلته. وقد اختلف العلماء فيه، فأوسع المذاهب في تجويزه للناظر والقيم مذهبا المالكية[160] والحنابلة[161] فقد جوزوه للمصلحة ولم يشترطوا له إذن القاضي أو شرط الواقف. والشافعية يشترطون إذن القاضي أو شرط الواقف،[162] والحنفية يشترطون مع ذلك وجود الضرورة أو الحاجة[163].
الأدلة والترجيح
استدل الحنفية على منع الاستدانة للوقف بأن “الْوَقْفُ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَالْفُقَرَاءُ [الموقوف عليهم]، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ لَكِنْ لِكَثْرَتِهِمْ لَا تُتَصَوَّرُ مُطَالَبَتُهُمْ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا عَلَى الْقَيِّمِ، وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ قَضَاءًه مِنْ غَلَّةٍ لِلْفُقَرَاءِ”[164] واستدلوا لهم وللشافعية على وجوب إذن الحاكم بأن “ولاية الحكم أعم في مصالح المسلمين من ولايته، فيكون أنفى لشبهة عدم ثبوت الدين.”[165]
الذي يظهر رجحانه هو قول المالكية والحنابلة، وليس في الاستدانة لأجل الوقف تعريض له للخطر إذا لم يرهن، ودليل الحنفية على المنع من نوع القياس القوي في مبناه الضعيف في معناه، والذي علمنا فقهاؤهم تركه للاستحسان، وتجويز الاقتراض للوقف من أجل مصلحته ثم استرداد القرض من غلته أو تبرعات الجالية هو المحقق لمصلحة الوقف، ومن ثم مقصود الشرع. ولو عرضت أحوالنا على الحنفية والشافعية الذين يشترطون إذن القاضي أو شرط الواقف لجوزوا للناظر الاستدانة للمصلحة من غير إذن. قال ابن مازة الحنفي في الناظر يكون بعيدًا عن الحاكم: “… إلا (أن) يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه الحضور، فلا بأس بأن يستدين بنفسه.”[166] أقول: لكن إن قدر الله للمسلمين في المستقبل أن تكون لهم مرجعيات تقوم فيهم مقام القضاة في بلاد الإسلام، فنستحسن عندها رفع تلك الأمور أو ما عظم منها إليهم. وأخيرًا أذكر بأن الكلام هنا عن الاستقراض للوقف من غير رهنه. أما مع الرهن، فيراجع المنع منه في المطلب السابق.
مشروع قرار
أولًا: ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات
جاء ذكر المسجد في الوحيين على معان مختلفة، منها: كل مكان صالح للسجود والعبادة، وهي الأرض كلها سوى ما استثني؛ ومنها المكان الذي يخصص للصلاة، وإلم يوقف مسجدًا لعموم الناس، كمسجد البيت وتلك الغرف المخصصة للصلاة في الشركات والمصانع والأماكن العامة، وجماهير أهل العلم لا يجعلون لها أحكام المساجد؛ ومنها تلك الدور المخصوصة والمهيأة لإقامة الجمع والجماعات وأنواع العبادات والموقوفة لذلك الغرض. والكلام عن ثبوت المسجدية وأحكام بنائها ووقفها إنما يتعلق بهذا النوع الثالث.
تثبت المسجدية على الراجح بتصريح المالك جائز التصرف (أو كنايته مع النية) بالوقف المؤبد لبنيان أو جزء مفرز منه مسجدًا، ولا يدخل في ذلك ما استثني أو ما جرى العرف على عدم تخصيصه للصلاة، وإن اتصل ببناء المسجد ونفذ إليه. وتفصيل ذلك فيما يأتي من بنود:
- الوقف لا يصح إلا من جائز التصرف، تام الملك، فإن كان غير ذلك، فلا يصح وقفه، وإن تعلق به حق للغير لم ينفذ إلا بإذنه، وإلم يكن الموقوف مفرزًا كأن يكون مشاعًا غير قابل للقسمة فلا يصح وقفه مسجدًا أو مقبرة خصوصًا.
- يجب التأبيد في وقف المساجد، وقد يجوز التوقيت في غيرها من الأوقاف.
- يجوز استئجار الدور واتخاذها مساجد بمعنى المكان المهيأ للصلوات، وذلك لاجتماع المسلمين فيها وإقامة الجمع والجماعات (على الأصح من عدم اشتراط المسجدية للأولى)، ولكن لا تأخذ تلك الدور أحكام المساجد.
- يشترط لثبوت الوقفية أن يصرح المالك بذلك، ويعين المحل الموقوف ويفرزه عن ملكه[167]. لكن إذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على أرض ما، صار الجزء المخصص منه عرفًا بالصلوات مسجدًا بتمام بنائه.
- لا تثبت أحكام المسجد للأرض الموقوفة له قبل بنائه، وإن ثبتت الوقفية. لكن إن اقترب بناؤه من هيئة المساجد، يحض الناس على مراعاة أحكام وآداب المسجد فيه.
- يجوز أن يخص الواقفون دارًا بعينها للصلاة على التأبيد وإن كان تحتها أو فوقها دار ليست منها، ويجوز وقفهم السفل من بناية مسجدًا، على أن يبنوا فوقها مرافق له متى تيسر ذلك.
- المرافق المتصلة بالمسجد لا تأخذ حكمه عند الجمهور إلم تخصص للصلاة على التأبيد ولم تكن من شعاره كالمنارة، سيما إن استثنيت من وقف المسجد عند انعقاده، وإن كانت موقوفة على مصالحه أو مصالح أهله. ويجوز بناء تلك المرافق من ريع المسجد، لكن المسألة من مواضع الخلاف إن كانت لمصلحة أهله لا لمصلحته، فينصح القائمون على هذه الأوقاف بالتزام الشفافية التامة في جمع التبرعات وإنفاقها على تلك المرافق إبراء للذمة وقطعا لمادة النزاع.
المصليات هي أماكن خصصت للصلاة ولكنها لم تكتمل فيها شروط المسجدية، ومنها تأبيد الوقف. ومن أمثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة – من غير وقف مؤبد – في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها. وفي حكمها مساجد البيوت أيضًا. وهذه المصليات لا تجري عليها أحكام المساجد.
من أهم الآثار العملية لعدم ثبوت المسجدية للمصليات أنه لا يصح الاعتكاف فيها (ولا الجمعة عند البعض خلافًا للراجح) ولا تجب التحية ولا يمنع فيها لبث الجنب ولا الحائض (عند الجمهور المانعين لمكثها فيه) ولا يحرم البيع والشراء فيها ولا إنشاد الضالة، ولا يزول عنها ملك مالكها ويجوز له تحويلها لتستعمل في أغراض أخرى.
لا يشترط الجمهور المسجد لصحة الجمعة، فكل ما لم تثبت له المسجدية الكاملة من المصليات يمكن للمسلمين أن يؤدوا فيها سائر عباداتهم التي يؤدونها في المساجد سوى الاعتكاف، فلا يصح للرجال إلا في المسجد اتفاقًا، وكذلك للنساء على الصحيح.
إذا كان مسجد الناحية أو المدينة مصلى لم تكتمل له شروط المسجدية، ومنها تأبيد الوقف، فقد يفتى المسلمون بمراعاة آداب المساجد فيه حتى لا تنشأ ناشئة لا يعرفون تلك الآداب.
ثانيًا: إبدال المساجد
المسجد إن خرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره قريب منه ليفي بحاجات الناس، وهناك أحوال لا ينبغي أن يختلف عليها في الغرب، كما لو هجر المسلمون قرية، فلا يسوغ أبدًا أن يتركوا مساجدهم يستولي عليها غيرهم، أو تصير خرابات يتأذى منها الناس أو تكلفهم أعباء رعايتها دون أن ينتفع بها أحد.
ويشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس وتطيب به نفوس أكثرهم، كما يشترط عند النقل ألا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرط في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني.
لا يجوز إبدال المسجد بما هو خير منه، ما كان يفي بحاجة أهله التي من أجلها أوقفوه ولم تكن لهم بالإبدال حاجة ماسة. أما الإبدال بمعنى شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين، فلا بأس به لسلامته من المحاذير المتوقعة عند نقل عرصته إلى مكان آخر.
ثالثًا: تسجيل ملكية المساجد ورهنها
لا يجوز تسجيل العين الموقوفة باسم الواقف، فإن الوقفية لا تتم إلا بإفراز العين عن ملك صاحبها وتحريرها منه بالكلية. ولكن إن كان له غرض صالح، جاز أن يشترط عند الوقف أن يكون ناظره، فيجعل نفسه المسؤول الوحيد أمام الجهات الرسمية عن الجمعية المتصرفة في العين الموقوفة. ولكن هذا المنحى، وإن صح لبعض الناس الذين يتكفلون ببناء المساجد وإعمارها، فإنه سيزهد عموم الناس عن التبرع لتلك المساجد.
لا ينبغي أن يضيق المسلمون على أنفسهم بوقف ما لم يتم لهم ملكه من غير تعلق حقوق للغير به، كالمرهون الذي لم ينتهوا من سداد أقساطه، ولهم أن يصلوا فيه ما شاؤوا وأن يجمعوا.
لا يجوز رهن الوقف اتفاقًا مراعاة لحق الوقف وحق المرتهن، وفي البلاد التي لا يوجد فيها قضاء إسلامي، فالمنع يكون غالبًا لحق الوقف، ومن ثم فلو أجزنا الإبدال حينما يخرب المسجد الأول أو لا يفي بحاجة أهله – بشروطه التي ذكرناها في موضعها – فعندها نجوز رهنه من باب أولى لمصلحة شراء بدله، وذلك عند ضمان بقاء أحدهما وقفًا.
رابعًا: تمويل بناء المساجد
الأصل في عمارة المساجد أن يبذل لها الناس أطيب أموالهم تشريفًا لبيوت الله وتعظيمًا لها، ولكن يجوز أخذ الأموال المختلطة والمحرمة على أصحابها وإنفاقها عليها، فإن حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه، ولا تتعدى إلى ذمة من انتقل إليه بعد ذلك بسبيل مباح. وقد نغلب مصلحة الزجر عن أكل الحرام، فنمتنع من قبولها، وقد نغلب مصلحة التأليف سيما إن كان المتصدق غير مكابر ورجيت توبته بقبول صدقته أو خشيت فتنته عن الدين بالكلية بردها، فالمسألة إذًا – بعد تقرير أصلها – من مسائل السياسة الشرعية التي تحتاج إلى بصيرة لضبط المصحة الراجحة فيها.
يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون أن يكون له عليه سلطان أو تدخل في شؤونه، فإن ظن أنه أراد شيئًا من ذلك رد وقفه وتبرعه.
لا يحل الاقتراض بالربا لبناء المسجد أو لشيء من مصالحه، فقد اتفقت الأمة على حرمة الربا وكونه من كبائر الذنوب، ولا يرتفع إثم الاقتراض به إلا إذا دعت إليه ضرورة، ولا تتخيل هنا. أما عند الخوف من ضياع المشروع وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه وانسداد كل السبل أمام الجالية بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى، فقد يحتمل الأمر الجواز، ولكن ينبغي أن يراجع القائمون على المشروع أهل العلم ويستفتوهم.
لا يحل القرض الحسن لمصلحة الوقف إن اشترط رهن الوقف لأجله، فإن كان من غير رهن جاز.
فهرس المراجع
تنبيهات:
ليس في الفهرس مراجع كتب الحديث لسهولة الوصول إلى الأحاديث المذكورة في البحث.
تم ترتيب الكتب حسب الاسم المذكور في هوامش البحث، وأضيفت الأسماء الكاملة للكتب بين أقواس بعد ذلك.
تم الاطلاع على أكثر هذه المصادر من خلال مكتبة الشاملة الإلكترونية، جزى الله القائمين عليها خيرًا.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
إعلام الساجد بأحكام المساجد
المؤلف: بدر الدين الزركشي
الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، القاهرة
الطبعة: 1431 هـ 2010 م.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي
المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: الثانية – بدون تاريخ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
الطبعة: الثانية – بدون تاريخ
بحوث في قضايا فقهية معاصرة
المؤلف: القاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع
دار النشر: دار القلم – دمشق
الطبعة: الثانية، 1424هـ – 2003 م
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م
البناية شرح الهداية
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان
الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م
البيان والتحصيل (البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة)
المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون
الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان
الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م
التاج والإكليل لمختصر خليل
المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: 1357 هـ – 1983 م
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)
الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة
الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م
التهذيب في اختصار المدونة
المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 372هـ)
الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي
الطبعة: الأولى، 1423 هـ – 2002 م
حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)
المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 1221هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هـ – 1995م
حاشية الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)
المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)
المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
الناشر: دار الفكر-بيروت
الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1418هـ
السيرة النبوية لابن هشام
المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
الطبعة: الثانية، 1375هـ – 1955 م
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ)
الناشر: دار العبيكان
الطبعة: الأولى، 1413 هـ – 1993 م
الشرح الكبير على متن المقنع
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ)
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)
المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)
الناشر: المكتبة العلمية
الطبعة: الأولى، 1350هـ
شرح مختصر خليل للخرشي
المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ)
الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
الناشر: دار المعرفة
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
فتاوى ابن الصلاح
المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ)
الناشر: مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت
الطبعة: الأولى، 1407
الفتاوى الفقهية الكبرى
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ)
جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوفى 982 هـ)
الناشر: المكتبة الإسلامية
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الفتاوى الكبرى لابن تيمية
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1408هـ – 1987م
فتح الباري لابن حجر
المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
فتح الباري لابن رجب (فتح الباري شرح صحيح البخاري)
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية.
الطبعة: الأولى، 1417 هـ – 1996 م
فتح القدير للكمال ابن الهمام
المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر
الطبعة: 1414هـ/1994م
الفروع وتصحيح الفروع (كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي)
المؤلف: محمد بن مفلح، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ)
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الأولى 1424 هـ – 2003 مـ
الفروق للقرافي (أنوار البروق في أنواء الفروق)
المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)
الناشر: عالم الكتب
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
القول المختار في شرح غاية الاختصار (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
المؤلف: محمد بن قاسم، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وابن الغرابيلي (المتوفى: 918هـ)
الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان
الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2005 م
كشاف القناع عن متن الإقناع
المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
لسان العرب
المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)
الناشر: دار صادر – بيروت
الطبعة: الثالثة – 1414 هـ
مجموع الفتاوى
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
عام النشر: 1416هـ/1995م
المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
المحلى بالآثار
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)
الناشر: دار الفكر – بيروت
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني
المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م
المدونة
المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425هـ – 2002م
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)
الناشر: المكتب الإسلامي
الطبعة: الثانية، 1415هـ – 1994م
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م
المغني لابن قدامة
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)
الناشر: مكتبة القاهرة
الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي
المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م
الوسيط في المذهب
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
الناشر: دار السلام – القاهرة
الطبعة: الأولى، 1417
[1] لسان العرب (3/ 204): “سَجَدَ يَسْجُدُ سجوداً وضع جبهته بالأَرض، وقوم سُجَّدٌ وسجود… والمسجَد والمسجِد: الذي يسجد فيه. وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجِد… وربما فتحه بعض العرب في الاسم، فقد روي مسكَن ومسكِن وسمع المسجِد والمسجَد … أَبو بكر: سجد إِذا انحنى وتطامن إِلى الأَرض. وأَسجَدَ الرجلُ: طأْطأَ رأْسه وانحنى، وكذلك البعير… وسجد: خضع … وكل من ذل وخضع لما أُمر به، فقد سجد؛ ومنه قوله تعالى: تتفيأُ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون.”
[2] متفق عليه
[3] رواه أحمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال لم يسمع شداد مولى عياض من بلال والله أعلم.
[4] فتح الباري لابن رجب (3/ 169)
[5] إعلام الساجد بأحكام المساجد (27-28)
[6] فتح الباري لابن رجب (2/ 194)
[7] البناية شرح الهداية (2/ 469)
[8] البناية شرح الهداية (2/ 469)
[9] فتح القدير (6/ 233)
[10] المغني لابن قدامة (5/ 405) وانظر إعلام الساجد (ص: 400)
[11] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 34)
[12] المدونة (3/ 434): “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ آجَرَ بَيْتَهُ مِنْ قَوْمٍ يُصَلُّونَ فِيهِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ أَكْرَى بَيْتَهُ كَمَنْ أَكْرَى مَسْجِدًا فَالْإِجَارَةُ فِيهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذَا شَيْئًا وَلَكِنَّ مَالِكًا كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَجْرًا عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَاجِرَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ مِمَّنْ يُصَلِّي فِيهِ رَمَضَانَ.”
[13] التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 541): “ابْنُ يُونُسَ: هَذَا [قول أشهب] صَوَابٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّمَا أَرَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِمْ الْبَيْتَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا أَسْلَمَهُ إلَيْهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ كَاَلَّذِي أَجَّرَ أَرْضَهُ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ يَبْنِيَهَا مُكْتَرِيهَا مَسْجِدًا.”
[14] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 34)
[15] المغني لابن قدامة (5/ 405) وانظر إعلام الساجد (ص: 400)
[16] البحر الرائق (5/ 204): “قَالَ الْخَصَّافُ لَوْ وَقَفَ دَارِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مُؤَبَّدًا وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَى فُلَانٍ مِنْهُ كَانَ بَاطِلًا وَفَصَّلَ هِلَالٌ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ بَعْدَ الْوَقْتِ فَيَبْطُلَ الْوَقْفُ أَوْ لَا فَلَا وَظَاهِرُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ اعْتِمَادُهُ”
[17] القول المختار في شرح غاية الاختصار (ص: 204) وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 245): “وَلَوْ قَالَ وَقَفْت هَذَا سَنَةً فَبَاطِلٌ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّ مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ كَقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً يَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا.”
[18] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (7/ 35): “قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَقَفْته سَنَةً: لَمْ يَصِحَّ). هَذَا الْمَذْهَبُ…وَقِيلَ يَصِحُّ وَيَلْغُو تَوْقِيتُهُ.”
[19] الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 273): “… انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كَمَا تَرَى فِي صِحَّة وَقْف الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا سَوَاء أَكَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ مُسْتَعَارَةً أَمْ لَا”
[20] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 273)، وانظر الخلاف في المذهب الحنفي حول هذه المسألة وترجيحهم عدم جواز وقف البناء دون الأرض في البحر الرائق (5/ 220)
[21] مجموع الفتاوى (31/ 8)
[22] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 87)
[23] التهذيب في اختصار المدونة (3/ 360) و التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 524)
[24] متفق عليه
[25] بدائع الصنائع 6/220.
[26] مجموع الفتاوى (31/ 8)
[27] دار الإفتاء المصرية، رقم الفتوى : 6183
[28] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 657)
[29] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 248): “نَعَمْ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الْمَوَاتِ تَكْفِي فِيهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إخْرَاجِ الْأَرْضِ الْمَقْصُودَةِ بِالذَّاتِ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى لَفْظٍ قَوِيٍّ يُخْرِجُهُ عَنْهُ.”
[30] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 248) : “(وَلَا يَصِحُّ) الْوَقْفُ مِنْ النَّاطِقِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ (إلَّا بِلَفْظٍ) … فَلَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَأَذِنَ فِي إقَامَةِ الصَّلَوَاتِ أَوْ الدَّفْنِ فِيهِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ”
[31] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 251): ” (وَ) الْأَصَحُّ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (أَنَّ قَوْلَهُ: جَعَلْتُ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا) مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ صَرِيحٌ فَحِينَئِذٍ (تَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا) .. لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إلَّا وَقْفًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْوَقْفَ أَوْ زَادَ لِلَّهِ صَارَ مَسْجِدًا قَطْعًا.”
[32] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 251): “وَقَوْلُهُ: [وقفته] لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ فِي الْمَسْجِدِيَّةِ فَإِنْ نَوَاهَا صَارَ مَسْجِدًا وَإِلَّا صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا.”
[33] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 251): “وَوَقَفْتُهُ لِلِاعْتِكَافِ صَرِيحٌ فِي الْمَسْجِدِيَّةِ”
[34] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 248): “… بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا.” وتفريقهم بين الاعتكاف والصلاة وجيه لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، والصلاة تصح في أي مكان.
[35] حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 362)
[36] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 255): “أَمَّا مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ [أي من ملك العبد لا إلى غيره] كَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَقَدْ وَقَفْتُ هَذَا مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعِتْقِ.”
[37] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 252): “… نَعَمْ إنْ أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً صَحَّ مُؤَبَّدًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ.”
[38] حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 581): “قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ.”
[39] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 84)
[40] فتح القدير (6/ 233): “(قَوْلُهُ وَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرِزَهُ بِطَرِيقِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا، وَعَنْهُمَا: لَا يَزُولُ إلَّا بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ.”
[41] فتح القدير (6/ 233): “وَقَوْلُنَا لَا يَتَعَيَّنُ الْمُتَوَلِّي يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُتَوَلٍّ جَعَلَهُ لَهُ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ أَحَدٌ. وَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ. وَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُتَوَلِّي أَيْضًا يَحْصُلُ تَمَامُ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ تَعَالَى لِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ.”
[42] فتح القدير (6/ 233): وفيه “وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا” وفيه (6/ 234): “وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ إنَّ كُلًّا مِنْ مُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَالْإِذْنِ كَمَا قَالَا مُوجِبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَصَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعُرْفِ.”
[43] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358): (أَمَّا لَوْ تَمَّتْ الْمَسْجِدِيَّةُ) أَيْ بِالْقَوْلِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ أَوْ بِالصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِمَا.”
[44] مطالب أولي النهى (4/ 278)
[45] شرح حدود ابن عرفة (417- 418)
[46] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 206)
[47] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358): “لَوْ بَنَى فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ تَمَّتْ الْمَسْجِدِيَّةُ) أَيْ بِالْقَوْلِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ أَوْ بِالصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِمَا … لَا بتركٍ.”
[48] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 356): “وَسُئِلَ فِي الْخَيْرِيَّةِ عَمَّنْ جَعَلَ بَيْتَ شَعْرٍ مَسْجِدًا فَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ”
[49] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 374)
[50] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 158): “(قَوْلُهُ: وَلَا إنْ دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ) أَيْ لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ عَنْهَا، وَمِنْ هَذَا إذَا خَرِبَ الْمَسْجِدُ لَا يُطْلَبُ لَهُ تَحِيَّةٌ كَمَا فِي ح، وَمُقْتَضَاهُ زَوَالُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِيَّةِ لَا أَصْلُ الْحَبْسِ تَأَمَّلْ.”
[51] حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 244): “وَكَمَنْ أَجَرَ أَرْضَهُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ وَقَفَهَا، حَتَّى لَوْ وَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ وَأُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ، فَيُمْنَعُ أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِيهَا وَمِنْ مُكْثِهَا حَالَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا فِيهَا وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ.”
[52] فتاوى ابن الصلاح (1/ 384)
[53] مطالب أولي النهى (4/ 278)
[54] كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 243)
[55] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 425): “وَإِذَا قَالَ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ: جَعَلْنَا هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا صَارَ مَسْجِدًا وَوَقْفًا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُكْمِلُوا عِمَارَتَهُ”
[56] كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 241): “(وَلَوْ جَعَلَ سَفَلَ بَيْتِهِ مَسْجِدًا، وَانْتَفَعَ بِعُلُوِّهِ) أَيْ الْبَيْتِ صَحَّ (أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ جَعَلَ عُلُوَّ بَيْتِهِ مَسْجِدًا وَانْتَفَعَ بِسَفَلِهِ صَحَّ (أَوْ) جَعَلَ (وَسَطَهُ) أَيْ الْبَيْتِ مَسْجِدًا وَانْتَفَعَ بِعُلُوِّهِ وَسَفَلِهِ (وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْتِطْرَاقًا) إلَى مَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا (صَحَّ) الْوَقْفُ (وَيَسْتَطْرِقُ) إلَيْه.”
[57] فتح القدير (6/ 234): “… وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلَيْنِ [الْوَجْهَيْنِ] لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ الْأَمَاكِنِ.”
[58] فتح القدير (6/ 234): “(قَوْلُهُ وَمِنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ … أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ) لَيْسَ لِلْمَسْجِدِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ بِمَسْجِدٍ (وَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ إذَا مَاتَ).”
[59] المحلى بالآثار (3/ 168): “وَلَا يَحِلُّ بِنَاءُ مَسْجِدٍ عَلَيْهِ بَيْتٌ مُتَمَلَّكٌ لَيْسَ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَلَا بِنَاءُ مَسْجِدٍ تَحْتَهُ بَيْتٌ مُتَمَلَّكٌ لَيْسَ مِنْهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَسْجِدًا، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ بَانِيهِ”
[60] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 420): “وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ جَعْلُ عُلُوِّ مَسْكَنِهِ مَسْجِدًا، وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ سُفْلِهِ مَسْجِدًا، وَيَسْكُنُ الْعُلُوَّ؛ لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ …” وفي الفروق للقرافي (4/ 16): “وَأَمَّا مَا تَحْتَ الْأَبْنِيَةِ الَّذِي هُوَ عَكْسُ الْأَهْوِيَةِ إلَى جِهَةِ السُّفْلِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْأَبْنِيَةِ”
[61] فتح القدير (6/ 234)
[62] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 465): “(قَوْلُهُ يَصِحُّ وَقْفُ السُّفْلِ دُونَ الْعُلْوِ) وَمِنْهُ الْخَلَاوَى وَالْبُيُوتُ الَّتِي تُوجَدُ فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ لِلْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ وَيَسْكُنُونَ فِيهَا بِزَوْجَاتِهِمْ.”
[63] فتح القدير (6/ 234)
[64] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358): “لَوْ بَنَى فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ تَمَّتْ الْمَسْجِدِيَّةُ) أَيْ بِالْقَوْلِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ أَوْ بِالصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِمَا … لَا يتركٍ.”
[65] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 465): “(قَوْلُهُ يَصِحُّ وَقْفُ السُّفْلِ دُونَ الْعُلْوِ) … فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَ مَا عَدَاهَا مَسْجِدًا جَازَ الْمُكْثُ فِيهَا مَعَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَالْجِمَاعِ فِيهَا وَإِلَّا حَرُمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَسْجِدِيَّةُ.”
[66] إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 283: “وفي فتاوى البغوي ما يقتضي منع مكوث الجنب فيه لأنه جعل ذلك هواء المسجد وهواء المسجد حكمه حكم المسجد”
[67] فتح القدير (6/ 234): ونصه: “… وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى عَكْسِ هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ، وَإِذَا كَانَ فَوْقَهُ مَسْكَنٌ أَوْ مُسْتَغَلٌّ يَتَعَذَّرُ تَعْظِيمُهُ.”
[68] المدونة (1/ 197)
[69] فتح القدير (6/ 234): ونصه: “… وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ [أبو حنيفة] أَنَّهُ قَالَ: إذَا جَعَلَ السُّفْلَ مَسْجِدًا وَعَلَى ظَهْرِهِ مَسْكَنٌ فَهُوَ مَسْجِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مِمَّا يَتَأَبَّدُ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي السُّفْلِ دُونَ الْعُلُوِّ.”
[70] انظر أيضًا: فتح القدير (6/ 234)
[71] المحلى بالآثار (3/ 168)
[72] المغني لابن قدامة (6/ 9)
[73] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358) و تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 465)
[74] فتح القدير (6/ 234)
[75] المغني لابن قدامة (3/ 196): “وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنْ اللُّبْثِ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا.” [أي منع الجنب].
[76] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 145): “وَلِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ تَبَعٌ لِلْمَسْجِدِ، وَحُكْمُ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، وَهَذَا إذَا كَانَ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ إمَامِهِ..”
[77] المجموع شرح المهذب (2/ 178): “حَائِطُ الْمَسْجِدِ مِنْ دَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ لَهُ حكم المسجد فِي وُجُوبِ صِيَانَتِهِ وَتَعْظِيمِ حُرُمَاتِهِ وَكَذَا سَطْحُهُ وَالْبِئْرُ الَّتِي فِيهِ وَكَذَا رَحْبَتُهُ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِي رَحْبَتِهِ وَسَطْحِهِ وَصِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِيهِمَا مُقْتَدِيًا بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ.”
[78] الفروع وتصحيح الفروع (5/ 139): “وظهر المسجد منه.”
[79] المدونة (1/ 300): “قَالَ: لَا يَأْكُلُ الْمُعْتَكِفُ وَلَا يَشْرَبُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ … فَقِيلَ لَهُ أَفَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لَا يَأْكُلُ الْمُعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا يُقَبِّلُ فَوْقَهُ [هكذا وجدتها فيما تيسر لي مراجعته إلكترونيًا، ولعلها يقيل من القيلولة].”
[80] البيان والتحصيل (17/ 102)
[81] البيان والتحصيل (1/ 292)
[82] التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 407)
[83] المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 353) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 365)
[84] المجموع شرح المهذب (6/ 509)
[85]المجموع شرح المهذب (4/ 303): “أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ عَدَّهَا الْأَكْثَرُونَ مِنْهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بينهما وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ أَمْ لَا وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إنْ انْفَصَلَتْ فَهِيَ كَمَسْجِدٍ آخَرَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِيهَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَرَحْبَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ الْمَبْنِيُّ لَهُ حَوْلَهُ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هِيَ مَا حَوَالَيْهِ”
[86] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 378)
[87] المدونة (1/ 300): “قَالَ: لَا يَأْكُلُ الْمُعْتَكِفُ وَلَا يَشْرَبُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَأْكُلُ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ أَفَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لَا يَأْكُلُ الْمُعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا يُقَبِّلُ فَوْقَهُ [هكذا وجدتها فيما تيسر لي مراجعته إلكترونيًا، ولعلها يقيل من القيلولة].” ولكن في شرح مختصر خليل للخرشي عند ذكر شروط الاعتكاف (2/ 267): “الْجَامِعُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ دَائِمًا لَا الصِّحَّةُ فِي الْجُمْلَةِ فَتَخْرُجُ رَحْبَتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِيهَا الْجُمُعَةُ دَائِمًا وَإِنَّمَا تَصِحُّ فِيهَا مَعَ ضِيقِ الْجَامِعِ وَاتِّصَالِ الصُّفُوفِ وَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ يَعْتَكِفُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ فَالْمُرَادُ بِالرَّحْبَةِ فِيهِ صَحْنُهُ.”
[88] المغني لابن قدامة (3/ 196): ” وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ مِنْهُ، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ إلَيْهَا، لِقَوْلِهِ فِي الْحَائِضِ: يُضْرَبُ لَهَا خِبَاءٌ فِي الرَّحْبَةِ. وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْمَسْجِدِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا. وَرَوَى عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُج إلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ، هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ. قَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ وَبَابٌ فَهِيَ كَالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ، وَتَابِعَةٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحُوطَةً، لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ. فَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَهُمَا عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ.”
[89] ذكره ابن مفلح في ” الفروع ” نقلا عن ابن بطة بإسناده، وقال “إسناده جيد”. وفيه عبد الرزاق ولم يخرجه في مصنفه ولا خرجه من تحمل عنه.
[90] فتح الباري لابن حجر (13/ 155): إلا أن ابن حجر قال معلقًا على تبويب البخاري: ” الرَّحَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هِيَ بِنَاءٌ يَكُونُ أَمَامَ بَابِ الْمَسْجِدِ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ هَذِهِ رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ وَوَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ فِيهَا الِاعْتِكَافُ وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمَسْجِدُ فَإِنْ كَانَتِ الرَّحَبَةُ مُنْفَصِلَةٌ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ.” وهو الراجح عند الشافعية.
[91] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358): “قُلْت: وَبِهِ حُكْمُ مَا يَصْنَعُهُ بَعْضُ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ مِنْ وَضْعِ جُذُوعٍ عَلَى جِدَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَلَوْ دَفَعَ الْأُجْرَةَ … وَقَدْ رُدَّ فِي الْفَتْحِ مَا بَحَثَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ إلَى نَفَقَةٍ تُؤَجَّرُ قِطْعَةٌ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ. قُلْت: وَبِهَذَا عُلِمَ أَيْضًا حُرْمَةُ إحْدَاثِ الْخَلَوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ كَاَلَّتِي فِي رِوَاقِ الْمَسْجِدِ الْأُمَوِيِّ، وَلَا سِيَّمَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَقْذِيرِ الْمَسْجِدِ بِسَبَبِ الطَّبْخِ وَالْغَسْلِ وَنَحْوِهِ.”
[92] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 281)
[93] فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (5/ 165) السؤال الأول من الفتوى رقم (16416): المفتون: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، بكر أبو زيد.
[94] البناية شرح الهداية (2/ 469)
[95] فتح الباري لابن رجب (2/ 194)
[96] البناية شرح الهداية (2/ 469)
[97] فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (5/ 169) الفتوى رقم (17864). المفتون: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، بكر أبو زيد.
[98] فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (5/ 171)
[99] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 374)
[100] المغني لابن قدامة (2/ 246)
[101] المجموع شرح المهذب (4/ 501)
[102] فتح القدير (2/ 393): “(قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ) … (قَوْلُهُ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا) أَيْ الْأَفْضَلُ ذَلِكَ، وَلَوْ اعْتَكَفَتْ فِي الْجَامِعِ أَوْ فِي مَسْجِدِ حَيِّهَا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ فِي حَقِّهَا جَازَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ.”
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 542): “(وَ) بِمُطْلَقِ (مَسْجِدٍ) مُبَاحٍ لَا بِمَسْجِدِ بَيْتٍ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ (إلَّا لِمَنْ فَرَضَهُ الْجُمُعَةَ).”
المجموع شرح المهذب (6/ 480): “لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ فِي مسجد بيت المزأة وَلَا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ”
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 364): “وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ.. إلَّا الْمَرْأَةَ لَهَا الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا مَسْجِدَ بَيْتِهَا.”
[103] رواه أبو داود وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.
[104] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358): “مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ خَرِبَ الْمَسْجِدُ أَوْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَ بَقَائِهِ عَامِرًا وَكَذَا لَوْ خَرِبَ وَلَيْسَ لَهُ مَا يُعْمَرُ بِهِ وَقَدْ اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي) فَلَا يَعُودُ مِيرَاثًا وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ وَنَقْلُ مَالِهِ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، سَوَاءٌ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهِ أَوْ لَا.”
[105] التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 662): “وَفِي الطُّرَرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْغَفُورِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ الْخَرِبَةِ؛ لِأَنَّهَا وَقْفٌ.”
[106] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 309): “وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِبَ كَشَجَرَةٍ جَفَّتْ وَمَسْجِدٍ انْهَدَمَ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ وَحُصُرِهِ الْمَوْقُوفَةِ الْبَالِيَةِ وَجُذُوعِهِ الْمُنْكَسِرَةِ إدَامَةً لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهِ…”
[107] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 358)
[108] المغني لابن قدامة (6/ 28)
[109] مطالب أولي النهى (4/ 278)
[110] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 378)
[111] الشرح الكبير على متن المقنع (6/ 244)
[112] الشرح الكبير على متن المقنع (6/ 244)
[113] مجموع الفتاوى (31/ 253)
[114] مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 770)
[115] متفق عليه
[116] المدونة (4/ 418)
[117] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 309)
[118] التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 662)
[119] شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 288)
[120] المعجم الكبير للطبراني (9/ 192)
[121] مجمع الزوائد (6/278)
[122] شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 288)
[123] بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 333)
[124] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 378)
[125] الشرح الكبير على متن المقنع (6/ 244)
[126] فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (5/ 196). المفتون: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، بكر أبو زيد.
[127] البحر الرائق (5/ 205): “ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَلَوْ وَقَفَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ صَحَّ وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ … وَفِي الْإِسْعَافِ لَوْ وَقَفَ الْمَرْهُونَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ صَحَّ وَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى دَفْعِ مَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَبْطَلَ الْوَقْفَ وَبَاعَهُ فِيمَا عَلَيْهِ.”
[128] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 77): “وَشَرْطُهُ [الوقف] أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَرْهُونٍ وَمُؤَجَّرٍ وَعَبْدٍ جَانٍ حَالَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ.”
[129] أسنى المطالب (2/ 161): “[فَصْلٌ لِلرَّاهِنِ انْتِفَاعٌ لَا يَنْقُصُ الرَّهْنَ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى وَاسْتِخْدَامٍ]… (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ) لِضَرَرِ الْمُرْتَهِنِ … شَمَلَ كَلَامُهُمْ مَا إذَا وَقَفَ الرَّاهِنُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ…”
[130] مطالب أولي النهى (4/ 278): “(وَ) لَا [َيصِحُّ] وَقْفُ (مَرْهُونٍ بِلَا إذْنِ [المرتهن])”
[131] البحر الرائق (5/ 205). وفيه: “ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَلَوْ وَقَفَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ صَحَّ وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ … وَفِي الْإِسْعَافِ لَوْ وَقَفَ الْمَرْهُونَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ صَحَّ وَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى دَفْعِ مَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَبْطَلَ الْوَقْفَ وَبَاعَهُ فِيمَا عَلَيْهِ.”
[132] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 352): “… وَوَجْهُهُ أَنَّ الرَّهْنَ حَبْسُ شَيْءٍ مَالِيٍّ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ … وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ وَالْوَقْفُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ وَلِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.”
[133] البيان والتحصيل (12/ 261): قال ابن رشد (الجد) في البيان والتحصيل: “قال عيسى وأصبغ: وسألناه: عن الرجل يحبس على ولده حبسا ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتابا، ومثلهم يحوز لهم أبوهم ثم يتعدى فيرهنها فيموت وهي رهن كما هي، قال: يبطل الرهن ويثبت الحبس ولا رهن، وقاله أصبغ، وقال: رهنه بمنزلة بيعه إياها، كما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.”
[134] الوسيط في المذهب (3/ 462): “فَلَا يجوز رهن الْمَوْقُوف وَأم الْوَلَد وكل مَا لَا يجوز بَيْعه.”
[135] المغني لابن قدامة (4/ 260): في المغني: “فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، كَأُمِّ الْوَلَدِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ.”
[136] الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 252): “وَإِذَا بَاعَ أَوْ رَهَنَ الْوَقْفَ هَلْ يُعْزَلُ وَيُفَسَّقُ … (فَأَجَابَ) … وَإِذَا تَعَدَّى النَّاظِرُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ انْعَزَلَ وَلَزِمَ الْحَاكِمَ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ.”
[137] رواه ابن ماجه.
[138] رواه ابن ماجه.
[139] فتاوى اللجنة الدائمة (13/354) رقم ( 42) . وفي فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 28، الصفحة رقم: 125(، سئل الشيخ رحمه الله عن رجل اشترى مكانًا بالرّبا، لتحويله مسجدًا، فهل تجوز الصلاة فيه، وكذلك بعضها يكون فيها أموال حرام، مثل قيمة الخمر هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ فأجاب: “الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيّبة، إذا تيسر لها أموال طيّبة وجب ذلك، وإلاّ فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمّر بأموال من الربا ولا من الزنا.”
[140] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 385)
[141] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 292)
[142] البيان والتحصيل (18/ 565)
[143] البيان والتحصيل (18/ 564)
[144] تفسير القرطبي (3/ 366)
[145] المجموع شرح المهذب (9/ 351)
[146] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: 40)
[147] الفروع (2/667)
[148] الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح .
[149] رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ومن قبله المنذري.
[150] السيرة النبوية لابن هشام – ص 194
[151] أبو داود
[152] المجموع شرح المهذب (9/ 351)
[153] المجموع شرح المهذب (9/ 351)
[154] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 523): “(شَرْطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ) دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْكَافِرُ، فَيَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا.”
[155] مجموع الفتاوى (17/ 499): “وَأَمَّا نَفْسُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ.”
[156] العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 117): “وَقْفُ الذِّمِّيِّ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ فَمَدْلُولُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ وَقْفَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ هُمْ حَتَّى لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا جَازَ وَقْفُهُمْ عَلَى مَسْجِدِ الْقُدْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ عِنْدَ هُمْ.”
[157] شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 82): “وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ وَقْفُ الْكَافِرِ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى رِبَاطٍ أَوْ قُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ الدِّينِيَّةِ وَلِذَلِكَ رَدَّ مَالِكٌ دِينَارَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَيْهَا حَيْثُ بَعَثَتْ بِهِ إلَى الْكَعْبَةِ ابْنُ عَرَفَةَ لَا يَصِحُّ الْحَبْسُ مِنْ كَافِرٍ فِي قُرْبَةٍ دِينِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ فَفِي رَدِّهِ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ رُدَّ.”
[158] انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 230)
[159] قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة المنعقد في شهر المحرم 1385 هـ ( مايو 1965م )
[160] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 40): “قَالَ فِي النَّوَادِرِ الْقَائِمُ بِالْحَبْسِ إذَا قَالَ أَعْمُرُهَا مِنْ مَالِي ثُمَّ قَالَ إنَّمَا عَمَّرْتهَا مِنْ الْغَلَّةِ جَازَ. قَالَ فَإِنْ قَالَ مِنْ الْغَلَّةِ أَنْفَقْت فَقَدْ أَنْفَذَ الْوَصِيَّةَ وَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي عُمْرَتُهَا حَلَفَ وَرَجَعَ بِذَلِكَ فِي الْغَلَّةِ وَلَا يَضُرُّهُ قَوْلُهُ أَعْمَرْتُهَا مِنْ مَالِي انْتَهَى وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لِلْقَائِمِ عَلَى الْحَبْسِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَيْهِ وَيَعْمُرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.”
[161] الفروع وتصحيح الفروع (7/ 357): “وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ، لِمَصْلَحَةٍ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ، وَيَتَوَجَّه فِي قَرْضِهِ مالا كولي.”
[162] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 289): “وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَكِنْ إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ مَالُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ صُدِّقَ فِيهِ مَا دَامَ نَاظِرًا لَا بَعْدَ عَزْلِهِ”
[163] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 439): “مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ الْوَاقِفِ … وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لَكِنَّهُ تُرِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ بُدٌّ تَجُوزُ بِأَمْرِ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَنْهُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَعَمُّ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ تَجُوزُ مُطْلَقًا لِلْعِمَارَةِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ… “
[164] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 439)
[165] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 147)
[166] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 147)
[167] يتوقف الباحث فيما لو أذن فيه بما هو من خصائص المسجد كالاعتكاف، وكانوا قد أقاموا فيه الصلوات الخمس، فإن ثبت الإجماع فيها، فهو كذلك، وإلا اشترطنا التصريح دون سائر الأفعال والكنايات لقلة العلم وشيوع الجهل.