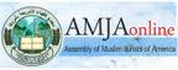لا مجال هنا لمناقشة حجية هذه القواعد ونطاق عملها. أما الحجية، فلا نزاع فيها عمليًا، ولكن النزاع في نطاق عملها. والذي نريد إثباته هنا هو أن لهذه القواعد عملًا في موضوعنا، فإن الدار، وإن لم يكن لها أثر في تحريم المحرمات على القول المختار، فإنها محل لواقع تسود فيه قوانين غير قوانين الإسلام، ويحتاج فيه المسلمون أن يكون لهم حضور في الصناعات المختلفة، وبعضها أكثر تعرضًا للحرام من بعض، والتطبيب والعمل في المجال الصحي عمومًا من تلك الصناعات التي يلجأ إليها المسلمون لأنها، في ظنهم، مساحة آمنة.
ماذا لو كانت أو صارت هناك ممارسات محرمة تفرض على الأطباء؟ هل يعتزلون التطبيب؟ قد يكون هذا حسنًا أحيانًا من آحاد الناس الذين يريدون السير على طريق بشر الحافي – رضي الله عنه – ولكن هل يمكن هذا للعامة؟ وإلى أي المهن يفرون؟ وما هي المهن التي تخلو من شبهات أو ممنوعات؟ يقول الإمام الجويني – رحمه الله: “ولو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد، فافهموا، ترشدوا.”[1] وهو يقدر أن ضبط الحاجة متعسر، فيقول: ” وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص.” [2]
ويقول الشاطبي: “وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة – الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.”[3]
أما قول الإمامين السيوطي وابن نجيم: ” الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة،” ففيه تفصيل، ولا وجه للمساواة بين الحاجة الخاصة والضرورة الخاصة، إلا أن يكون المقصود بالضرورة الخاصة أنها لا تعم جميع الأمة. قال الإمام الشافعي: “ومن احتاج إلى قسم شيء لم يحلل له بالحاجة ما لا يحل له في أصله وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس.”[4]
والتوسع في هذا الباب من غير ضابط مزلة أقدام لكثير من المعاصرين، وكأن الطوفي – رحمه الله – يخاطبنا بقوله: “لا يجوز للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها، ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدا من جنسها.”[5]
ويبين الشيخ الزرقا – رحمه الله – معنى الحاجة فيقول: “والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة موقتا كما تقدم.”[6]
إذا هو يثبت الحكم بها مستمرًا، ولكن هل ترفع، كالضرورة، كل محظور؟ في هذه المسألة خلاف طويل، وظاهر كلام السيوطي وابن نجيم أنها كذلك، ولكن لا يقول به أحد، وإن اختلفوا في نطاق تأثيرها. وقد حاول ضبطها كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ الزرقا – رحمه الله – فخصها بالأحوال الآتية:
- “يضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا للقياس
- ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به
- أو كان لم يرد فيه نص يجوزه أو تعامل، ولم يرد فيه نص يمنعه، ولم يكن له نظير جائز في الشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه نفع ومصلحة.”[7]
ومن أضبط ما قرأت عن مفهوم الحاجة ما ذكره الشيخ عبد الله بن بيه حيث قال: “وباختصار فإن الفرق بين الضرورة وبين الحاجة يتجلى في ثلاث مراتب: مرتبة المشقّة ومرتبة النهي ومرتبة الدليل، فإن الضرورة في المرتبة القصوى من المشقّة أو من الأهمية والحاجة في مرتبة متوسطة. والنهي الذي تختص الضرورة برفعه هو نهي قوي يقع في أعلى درجات النهي لأن مفسدته قوية أو لأنه يتضمن المفسدة فهو نهي المقاصد بينما تواجه الحاجة نهياً أدنى مرتبة من ذلك لأنه قد يكون نهي الوسائل. أما مرتبة الدليل فإن الدليل الذي ترفع حكمه الضرورة قد يكون نصاً صريحاً من كتاب أو سنّة أو سواهما. أما الدليل الذي تتطرق إليه الحاجة فهو في الغالب عموم ضعيف يخصص، أو قياس لا يطرد في محل الحاجة، أو قاعدة يستثنى منها “[8].
ولكن هذه الأمثلة لا تستوعب المعنى الذي أشار إليه الإمامان الجويني والشاطبي، ولا يظهر أنها تمام مقصود الإمامين السيوطي وابن نجيم.
دعنا نضرب مثالًا. هب (وإن تنزلًا) أن التعليم العالي في التخصصات الدقيقة، كالطب والهندسة وغيرها، لا يمكن تحصيله إلا بالاقتراض الربوي. هل يباح لذلك؟ اللهم نعم، فإن المنع منها يقضي بحرمان أكثر المسلمين من التعليم العالي بدرجاته المختلفة، وفي ذلك من الضرر على الناس ما فيه. ولما كانت التصورات تسبق التصديقات، فإن الذي لا يتصور الفرق بين التعليم بالإم آي تي وغيرها من الجامعات المتميزة والتعليم في الكليات المحلية ولا يتصور أهمية التعليم العالي والتخصصات الدقيقة ولا يتصور كون التعليم عماد نهضة الأمم وقوتها سيما في أزمنتنا هذه، فلن يرى مسيس الحاجة إلى تيسير أسبابه لأبناء المسلمين.
ثم دعنا نأخذ مثالًا آخر. هب أن الأطباء ألزموا بوصف أدوية للمرضى الراغبين فيما يسمونه “الموت الرحيم”، ولم يكن للأطباء بد من ذلك، هل نلزمهم بترك تلك المهنة؟ ماذا لو تركوها؟ هل هناك مهن تخلو من المحاذير، وهل تستوعب كل المسلمين؟ فإن قلت فليهاجروا، فهل تهاجر كل الأقليات المسلمة، وإلى أين؟ وهل تلك البلاد التي يهاجرون إليها لا محاذير فيها؟
إننا ندرك خطر التوسع في تنزيل الحاجات منزلة الضرورات، ولكن الحاجات العامة الماسة قد تنزل منزلة الضرورة أحيانًا، وتقدير ذلك يحتاج إلى رسوخ في العلم ومعرفة تفصيلية بالواقع، فينبغي في عصرنا أن يكون جل الاجتهاد في حكم هذه المسائل جماعيا في صورة مجامع فقهية وهيئات علمية تجمع بين العلماء بالشرع والخبراء بالواقع.
إن كانت الحاجة وعموم البلوى وعسر الاحتراز قد تبيح بعض المحرمات، فإنها بالأولى تسوغ الأخذ بما اعتبرناه قولًا مرجوحًا، فإن كان ثمة حرج بالغ في قضية بعينها، فيمكن للمفتي أن يأخذ بقول الأحناف في قضية الإعانة على الإثم، فمتى كان بين فعل المسلم ووقوع المعصية فعل فاعل مختار فيؤذن فيه، إلا أن يكون في الفعل الأول مباشرة للمعصية أو بيع ما تقع به عينها أو إعانة على ما فيه ضرر للغير، فعندها ينبغي أن يكون هناك مزيد من التحرز وأن يرد الأمر للهيئات العلمية الموثوقة.
التطبيق في المجال الطبي
وخلاصة القول أن الحاجة في المجال الطبي إن كانت حقيقية غير متوهمة فإنها قد يكون لها الآثار الآتية:
- ترجيح قول ضعيف لأحد المعتبرين من الفقهاء، إذا لم يكن ضعفه شديدًا.
- إباحة محظور تتوافر فيه الشروط الآتية:
- ألا يكون مما ثبت بنص خاص قطعي الثبوت والدلالة.
- أن يكون من منهيات الوسائل لا المقاصد.
- أن تكون المشقة المترتبة على ترك المحظور فوق المشقة المعتادة في التكليف وليست قريبة منها، أو تسبب حرجًا لعموم الناس ولو في قطر من الأقطار، فعندها قد تكون لتلك الحاجة قوة الضرورة في إباحة المحظور.
[1] غياث الأمم في التياث الظلم لعبد الملك بن عبد الله الجويني، (مكتبة إمام الحرمين)، ص 479.
[2] المصدر السابق
[3] الموافقات لأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، (القاهرة: دار ابن عفان)، 2/21..
[4] الأم، الشافعي، ج 3، ص 28.
[5] شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي ، (القاهرة: مؤسسة الرسالة)، 3/207.
[6] شرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا، (دمشق: دار القلم)، ص209.
[7] المصدر السابق، ص 210
[8] من مقالات له بعنوان “صناعة الفتوى وفقه الأقليات” على موقع الإسلام اليوم.