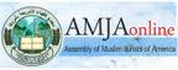المحتوى
أهمية ستر غير المجاهر ومن لا يضر إلا نفسه. 7
متى تحل الغيبة ومتى يحل التشهير ومن المسؤول عنه. 16
ما هي سبل الوقاية من هذه الخطوب والحد من آثارها عند وقوعها؟ 26
كيف تسلم أنت وكيف يسلم لك قلبك وظنك بالناس عمومًا والصالحين من عباد الله خصوصًا؟ 27
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف أنبيائه، نبينا محمد، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كل بني آدم خطاء. هذا قضاء الله على خلقه. لكن الأخطاء تتفاوت تفاوتًا عظيمًا في حجمها وآثارها، فهناك جرائم تزلزل المجتمع حتى إن كانت من مجهولين، وأحيانًا يحصل نفس القدر من الزلزلة عند وقوع ذوي الهيئات، لا سيما المعروفين بالعلم والصلاح، فيما هو أدنى من ذلك، فإن اجتمع الأمران: عظم الخطيئة ومكانة المخطئ في ظنون الناس، فإن الفاجعة تكون أعظم والخطب يكون أجل. ويبلغ الخطب ذروته عندما يكون الدين نفسه وسيلة يتوسل بها حملته إلى انتهاك الحرمات.
هذا، وإن رقة الدين في هذه الأزمنة وشدة الفتن قد تؤديان إلى المزيد من هذه الفواجع، مع ما سهلته وسائل التواصل الحديثة من سرعة انتشار أخبارها، فإذا بالخطيئة التي وقعت في أقاصي الأرض تلف أخبارها المعمورة بين غمضة عين وانتباهتها. يضاف إلى ذلك ما يعانيه المسلمون عمومًا من ضعف في المؤسسات التي يعول عليها في الحد من هذه المخاطر وحسن التعامل معها عند وقوعها والحد من آثارها المدمرة. وأخيرًا، فإن الأقليات المسلمة تواجه صعوبة أخرى، وهي عدم وجود قضاء شرعي والشك المبرر أحيانًا وغير المبرر غالبًا في نزاهة جهات التحقيق وعدالة القضاء الوضعي.
أناقش هنا حالة افتراضية لأسوأ خبر قد يصلك عن طريق وسائل التواصل عن تحرش معلم وقور أو داعية مشهور بطفلة أو طفل أو الاعتداء الجنسي عليهما.
وهذه هي الأسئلة التي نحتاج الإجابة عنها بهذا الصدد:
- ما هي أهمية حفظ القلب واللسان؟
- ما هي أهمية ستر غير المجاهر ومن لا يضر إلا نفسه؟
- ما هي أهمية التبين وما هي درجاته؟
- متى تحل الغيبة ومتى يحل التشهير؟ ومن المسؤول عن التشهير كعقوبة عند غياب القضاء الشرعي؟
- ما هو القسط في توزيع المسؤولية بين المجتمع المسلم والمؤسسات والأفراد؟
- ما هي سبل الوقاية من هذه الخطوب والحد من آثارها عند وقوعها؟
- كيف تسلم أنت وكيف يسلم لك قلبك وظنك بالناس عمومًا والصالحين من عباد الله خصوصًا؟
أهمية حفظ القلب واللسان
حفظ القلب
قال ربنا: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً” (الحجرات: 12)
النهي عن كثير من الظن هنا إنما هو لحماية القلب أولًا من سوء الظنون بالناس، فإن سوء الظن مفسدة للقلب مجلبة للشر، وسلامة الصدر من أشرف خصال الصالحين وأعظم المنجيات.
ولقد نهانا نبينا r عن عدد من الآفات التي تفسد القلوب وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس فقال: “إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.” (متفق عليه)
قال الإمام الغزالي – رحمه الله: “اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك. ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء. فأما الخواطر وحديث النفس، فهو معفو عنه، بل الشك أيضا معفو عنه، ولكن المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب.”[1]
ولقطع مادة الظن وزجر النفس عن سعيها إلى الاطلاع على معايب الغير قال إمامنا أحمد عن الرجل يسمع صوت الطبل أو مزمار لا يعرف مكانه: “ما عليك؛ ما غاب عنك، فلا تفتش.”[2]
فإن تبين للمرء عيب في أخيه أو اطلع على شيء من عوراته، فليحفظ قلبه عن أن يظن به غير ما تبين له منه، فإن من وقع في شيء من هذه المحرمات والقاذورات، فليس بالضرورة مقارفًا لغيرها، ولا يجوز الافتراء عليه بما ليس فيه.
بين حفظ القلب والحذر
وحفظ القلب عن سوء الظنون لا يعني أن يترك الإنسان الحذر والاحتراز، سيما ممن ظاهره القبح، وفي الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي العالية: “كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ، وَنَكِيلَ، وَنَعُدَّهَا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَعَوَّدُوا خُلُقَ سُوءٍ، أَوْ يَظُنَّ أَحَدُنَا ظَنَّ سُوءٍ.” فالحذر وحسن التدبير يمنع الشر ويردع من قد تسوله له نفسه وهو كذلك يمنع سوء الظن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: ” لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ” وهذا الاحتراز لا يلزم منه سوء الظن، وما روي من حديث ” احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ” لا يصح، بل هو ضعيف جدًا كما قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، فإن صح عن عمر – رضي الله عنه – “فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحا خشيت السراق.”[3]
حفظ اللسان
أما حفظ اللسان، فشأنه كذلك عظيم والحث عليه في الإسلام أكثر من أن يحتاج إلى تنبيهنا، ولكن نذكر طرفًا من ذلك لمزيد الاعتبار.
قال تعالى: “مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ” (ق: 18)
وفي ” صحيح مسلم ” عن أبي هريرة أن النبي r سئل عن الغيبة، فقال: “ذكرُك أخاكَ بما يكرهُ”، قال: أرأيت إنْ كان فيه ما أقولُ؟ فقال: “إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبته، وإنْ لم يكن فيه ما تقولُ، فقد بهتَّه.”
وذكر الأخ هنا للتبشيع، فإن غيبة المعصوم عمومًا لا تحل، قال العلامة ابن حجر في الزواجر: “وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء، لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله.”[4]
ولكن هناك استثناءات للنهي عن الغيبة نبينها لاحقًا، فحتى لا نسيء استعمالها لهوى في نفوسنا ينبغي أن نحفظ قلوبنا ونتهم نوايانا ونراقب أعمالنا، فإن الغيبة كما قال الإمام ابن النحاس هي ” الداء العضال والسم الذي هو أحلى في الألسن من الماء الزلال”[5] وهي كذلك لأن المرء لا يكاد ينفك عن حظ نفسه كلما ذكر غيره بسوء، فإن نفسه تشعر بالعلو على المذنب وقد يكون هذا الشعور وما يجلبه للنفس من نشوة هو الدافع الحقيقي لكلامه وإن زين له شيطانه أنه إنما يفعل ذلك لمصلحة الدين وعباد الله الصالحين. قال الإمام تقي الدين ابن تيمية – رحمه الله:
“ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك … فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان؛ لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم؛ وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد… ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به… ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر. والله المستعان.”[6]
اتهم نيتك
كيف إذًا نعلم إن كان باعث كلامنا عن الناس فيما يحل من استثناءات هو الغضب لله ورسوله وحراسة الدين وتحذير المسلمين ودفع شر الفاسقين المعتدين؟
إن وجدت من نفسك انشراحًا وخفة عند ذكر معايب الناس وكشف مثالبهم، فاعلم أنك على غير الجادة وأن وراء ما تقنع به نفسك من دواع داعي سوء من حظوظ النفس الخسيسة، فإنه وإن كان للمظلوم أن ينتصف من ظالمه، لكن غيره ممن يحذر الناس من عصاة الموحدين، بل وغير المحاربين من غيرهم إنما يفعل ذلك مضطرًا، فهو كأكل الميتة، والنفس لا تنشرح لذلك، بل تتعاطاه مع ألم وغصة ونفور. قال العلامة ابن حجر الهيتمي: ” وإن توقف [التحذير الواجب] على ذكر عيب ذكره، ولا تجوز الزيادة عليه أو عيبين اقتصر عليهما وهكذا؛ لأن ذلك كإباحة الميتة للمضطر فلا يجوز تناول شيء منها إلا بقدر الضرورة.”[7]
وهذا كلام للإمام النووي أختم به هذا المطلب لنفاسته. قال – رحمه الله: “اعلم أنه لكلّ مكلّف أن يحفظَ لسانَه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهرُ المصلحة فيه، ومتى استوى الكلامُ وتركُه في المصلحة، فالسنّة الإِمساك عنه، لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وروينا في ” صحيحي البخاري ومسلم ” عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال: ” من كان يؤمن باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أوْ لِيَصْمُتْ.”[8]
أهمية ستر غير المجاهر ومن لا يضر إلا نفسه
قال الله: “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.” (النور: 19)
قال العلماء هم من يحب انتشار أخبار الفاحشة، فما بالك بمن ينشرها؟
إن شيوع المعاصي والفواحش في المجتمع يؤدي إلى إلفها وعدم استنكارها، لذلك أمرنا بالتستر والستر، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r أنه قال: “كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.” (متفق عليه).
وقد أمرنا بالستر على العاصي الذي لم يعرف بالشر وأذية الناس، لأنه أدعى لتوبته، لذلك يقول رسول الله r: “مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.” (مسلم)
وقال الخلال في كتاب المجانبة: “وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة، ثم لم يكاشف بها، ولم يلق فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم، وعن المسلمين، والإمساك عن أعراضهم، وعن المسلمين أسلم.”[9]
أهمية التبين ودرجاته
من قواعد الشريعة: “الأصل براءة الذمة” وهي من أعظم مفاخر هذا الدين الحنيف الذي يقرر أن الإنسان يولد بريئًا من كل ما تنشغل به الذمة من جنايات أو حقوق للآخرين، ثم لا يثبت شيء منها بعد ذلك إلا ببينة.
قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا” (الحجرات: 6)
وقال: “لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ” (النور: 12)
وقال رسول الله r: ” كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ “(مسلم)
ولست أجد أحدًا أولى بهذا الوصف من مروجي الشائعات. والذين يشاركون كل ما يجدونه على مواقع التواصل من غير تثبت وروية لهم من هذا الوصف حظ وافر، فهم كذابون، وإن لم ينطقوا بكلمة واحدة أو يكتبوا حرفًا واحدًا، فبئست الصفقة. وكثير منهم لو ووجه بأدلة دامغة على جرم من يحب أنكرها، ولكنه لا يبالي بما ينقله عمن لا يعرفه، بله خصومه.
الموازنة بين التبين والحذر
لكن، بعد كلامنا عن أهمية التبين، فهل يمكن لأحد أن يطالب أحدًا بعدم اجتناب الفاسق والحذر منه حتى تثبت جريمته في محكمة شرعية؟ وهل يمكن أن نطالبه بعدم تحذير أهله وأولاده؟ وماذا عن جيرانه؟ وماذا عن سائر عباد الله الصالحين، بل وغير الصالحين؟ أليس دفع الضرر من قواعد الشريعة، أوليس مقدمًا عند العقلاء على رفعه؟ لكن، بماذا ندفعه؟ أليس من قواعد الشريعة أن الضرر لا يزال بمثله؟
المسألة تحتاج إلى حكمة وموازنة بين العدل وحسن الظن والحذر والتفطن وبين الحق الخاص والحق العام.
قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: “فالحدود لا تقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة؛ بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود: ” اعتبروا الناس بأخدانهم “. فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” احترسوا من الناس بسوء الظن “. فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن.”[10]
التبين اللازم للحذر إذًا غير التبين اللازم للعقوبة عمومًا والحدود خصوصًا.
التبين اللازم للتحذير
لكن ماذا عن التبين اللازم للتحذير؟ فهنا مسائل تحتاج إلى حسن فهم لأن هذه المسألة لم تناقش بشكل مفصل في كتب الفقه والآداب، منها:
- هل اتفق العلماء على أدلة الإثبات في القضاء؟
- هل التبين درجة واحدة أم درجات؟
- وما هو المقصود بالتبين إذًا لتحذير الأهل والأصحاب والجيران من الفاسدين ثم عموم الناس؟ وما هو التبين اللازم لإيقاف المتهم عن العمل في مؤسسات المسلمين أو فصله؟
بين البينات والقرائن
أتوسع في هذا المطلب قليلًا لأن هناك قصورًا في تصور كثير من العوام وبعض طلبة العلم عن أدلة الإثبات في القضاء الإسلامي.
اعلم أن الإسلام اعتنى عناية عظيمة بموضوع الإثبات وأدلته، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: “لو يُعطَى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ولكنَّ البَيِّنة على المُدَّعِي واليَمينَ على مَن أنْكَر.” [11]
والدليل في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني.[12] وهم عندما يذكرون الأدلة فإنهم في الغالب يشيرون إلى ما ثبت بالنص أو حكم الصحابة، وهذا لا يعني أن الإثبات منحصر فيها.
والقرينة في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية.[13] ووجه التسمية أنها أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًّا فتدل عليه.
ولقد اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا في طرق الإثبات في القضاء الإسلامي، فبعضهم حصرها فيما هو منصوص عليه أو مستنبط من الوحي، وبعضهم وسع دائرة الإثبات لتشمَلَ كل ما يَظهر به الحق ويُسفِر به طريق العدل. والحكم بالقرائن كان محَل خلاف بين الفقهاء لهذا السبب.
قال الإمام القَرَافِيّ في مسالك الحكم والقضاء عن أدلة الإثبات عند المالكية:
“الحِجاج التي يقضي بها الحاكم سبعَ عشرةَ حجةً الشاهدان، والشاهدان واليمين، والأربعة في الزنا، والشاهد واليمين والمرأتان، واليمين والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها بأن يتحالفا، ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما بيمينه والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقُمْط الحيطان[14]، وشواهدها، واليد. فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحاكم؛ وما عداه لا يقضي به عندنا وفيها شبهات واختلاف بين العلماء.”[15]
لاحظ في كلامه، أنه مع حصره لها، فإنها تتفاوت فيما بينها، وليس كلها منصوصًا، ومنها قرائن قطعًا، وبعضها مردود في غير مذهبه، وقد أشار في النهاية لكون غيرها محل خلاف بين أهل العلم.
ولعل الأقرب عند التقسيم أن يقال إن أوسع الناس في العمل بالقرائن ابن القَيِّم[16] ثم ابن تَيمِيَّة[17] وابن فَرْحُون[18] ثم بقية المالكية على تفاوت بينهم وابن الغَرْس[19] من الحنفية وبعض الحنابلة. والعمل بها في بعض الحدود مذهب المالكية[20] كما في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة[21] وهو كذلك رواية عن أحمد. ثم يأتي الشافعية ثم الحنفية على تفاوت بينهم أيضًا.
ولقد نقل البعض اتفاق الفقهاء على مبدأ العمل بالقرائن. قال العلامة علاء الدين الطَّرابُلُسِيّ الحنفي – رحمه الله: “قال بعض العلماء: على الناظر أن يلحظ الأَمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهو قوة التُّهَمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من الفقهاء.”[22]
والذي يظهر أنه وإن أنكر البعض العمل بالقرائن، فإن تتبع فتاواهم وأقضيتهم يظهر اتفاقهم على اعتبارها، حتى قال الشيخ محمود شلتوت – رحمه الله: “ومما ينبغي المسارعة إليه، أن الناظر في كتب الأئمة يجد أنهم مجمعون على مبدأ الأخذ بالقرائن في الحكم والقضاء، وأن أوسع المذاهب في الأخذ بها هو مذهب المالكية ثم الحنابلة ثم الشافعية ثم الحنفية، ولا يكاد مذهب من المذاهب الإسلامية يخلو من العمل بالقرائن حتى بالنسبة لمن أنكرها.”[23]
والعمل بالقرائن هو ما تدل عليه النصوص، منها:
- قولـه تعـالى: “وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ” (يوسف: 27). قال العلامة محمد الأمين الشِّنْقِيطِيّ – رحمه الله: “يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين.”[24]
- وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ﷺ قال: “بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جاء الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فقالت هذه لِصَاحِبَتِهَا إنما ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتْ الأُخْرَى إنما ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إلى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا على سُلَيْمَانَ بن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلام فَأَخْبَرَتَاهُ فقال ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فقالت الصُّغْرَى لا؛ يَرْحَمُكَ الله، هو ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.” (متفق عليه) والشاهد أنه استدل بشفقة إحداهما دون الأخرى على أمومتها.
- وعن زيـد بن خالـد الجهني أن رجـلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: “عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بها فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدِّهَا إليه.”(متفق عليه). فجعل ﷺ وصفه لها قرينة على ملكيته.
- وعن عبد الرحمن بن عوف أنه لما قتل مُعَاذُ بن عَمْرِو بن الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بن عَفْرَاء أبا جهل قال لهما رسول الله: “أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فقال كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أنا قَتَلْتُ. فقال هل مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قالا لا. فَنَظَرَ في السَّيْفَيْنِ فقال كِلاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بن الْجَمُوحِ.” (مسلم). والشاهد أنه حكم بالسلَب لمن كان سيفه أعمق في جسد أبي جهل بدلالة الدم الذي عليه.
- وحكم رسول الله ﷺ وأصحابه وليست إلا علامة.
وأخيرًا فإن ترك العمل بالقرائن يحرم المسلمين من أكثر منجزات العصر في تطوير وسائل التحقيق الجنائي وتتبع المجرمين وتحقيق العدالة.
إن أدلة الإثبات إذًا لا تقتصر على المنصوص منها، فالقرائن إن قويت أو تعددت، عمل بها، مع الاحتياط في الحدود وعدم التوسع في إثباتها. ولا نحتاج إلى التذكير بأن الحدود لها شأن خاص، فهي تدرأ بالشبهات، ولكن من سقط عنه الحد بالشبهة، فقد تثبت عليه العقوبة، وهذا مبثوث في كتب الفقه، بل وقد تسقط العقوبة فيضاعف الضمان عند كثير من الفقهاء. وقد يبرأ المرء أمام القضاء ويبقى الحذر منه لقوة التهمة، وفي الصحيحين “أن عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص، اختصما إلى النبي r في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة، فأقبضه، فإنه ابني، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي r شبها بينا بعتبة، فقال: “هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ”. فما رآها حتى لقي الله تعالى.” فالنبي حجب سودة عن “أخيها” الثابتة أخوته بحكم قضائي للشبه بينه وبين المدعى عليه بالزنا.
التحذير قبل اكتمال البينة القضائية
في الحديث السابق نرى كيف احتاط النبي لأهله، رغم أن البينة القضائية حكمت بأخوتها للمتخاصم فيه. لكن، هل يجوز ذلك في تحذير الناس عمومًا من غير بينة قضائية؟ الصحيح جوازه، من غير قطع أو قذف، إن قويت التهمة وغلب الظن بفسق المحذر منه وخيف من ضرره، لكن لا يجوز في المعاصي القاصرة على نفسه. إن بعض الناس يتسرع في القطع بالتهم وبناء الأحكام عليها قبل أي درجة من التبين، والبعض يثير احتمالات عقلية شديدة البعد لينفي التهمة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والعمل بغلبة الظن أمر مستقر في الأحكام الشرعية، وحتى اليقين الذي يتكلم عنه الفقهاء إنما هو الأمر الثابت المستقر لا ما يحيل العقل خلافه.
وفي كلام الإمامين الماوردي وأبي يعلى عن الفروق بين الأمراء والقضاة، قالوا عن الأمير: “وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهّرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك فقد وقع الفرق بين الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحق، لاختصاص الأمراء بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام. فأما بعد ثبوت جرائمهم، فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة”[25] وقد وافقهم على ذلك القرافي في الذخيرة[26] وما ذكروا أنه من صلاحيات الأمراء نناقش لاحقًا المعنيين به إذا عدموا.
وفي تفسير الإمام ابن القيم لقوله تعالى: “یـٰأیها ٱلذین ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا” (الحجرات ٦) يقول: “وهاهنا فائدة لطيفة. وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة. وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر.”[27]
ومثل ذلك قد يقال عن جهات التحقيق والمحاكم في الدول غير المسلمة. لا ينبغي أن نكذب التهم حتى بعد صدور الأحكام، بل ننظر في الأدلة والقرائن والأسباب والدواعي للكذب والافتراء، إن كان ثم. نعم، كل العقلاء يعرفون التورط التاريخي والمتكرر لأجهزة المخابرات في أكثر دول العالم في الكيد لخصومهم وتلفيق التهم لهم. لكن هذا لا يحمل العقلاء على الإنكار المبدئي وعدم النظر المتجرد في التهم وأدلتها، ثم إن هذه الأجهزة لا وقت عندها ولا داعي لتشويه الأغمار، بل وأكثر الناس مما لا يستشعرون خطرهم على “الأمن القومي.”
العمل بغلبة الظن
إذا كان التحذير جائزًا أو واجبًا قبل صدور الحكم، فما هو التبين المطلوب له؟
اعلم أن غلبة الظن معتبرة في غالب الأحكام، والشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، (٥٠٪)،[28] فمن ثم يكون بينه وبين اليقين بالإثبات (١٠٠٪) درجات تختصر فيما عرف بالظن، وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، وقد يقال غلبة الظن (من ٥١٪ إلى ٩٩٪). ويكون بين الشك واليقين بالنفي (٠٪) درجات كذلك، تختصر فيما عرف بالوهم، وهو الجانب المرجوح من أمرين جائزين (من ١٪ إلى ٤٩٪).
التبين اللازم لتحذير الغير
إن الصواب هنا أن التبين اللازم لتحذير المؤمنين من الفساق والمجرمين هو ما كان ظنًا غالبًا أقرب لليقين منه إلى الشك، ولا يشترط فيه ما يلزم به الحد. أما اشتراط أن تكون غلبة الظن مقاربة لليقين، فلأن الفقهاء، عند تعارض الظاهر والأصل يختلفون في العمل بالظاهر، وذلك باعتبار قوة الأصل والظاهر ومجال عملهما، فلا شك أننا ينبغي أن نشدد هنا ونشترط لغلبة الظن أن تقارب اليقين لقوة الأصل، وهو براءة الذمة وحرمة عرض المعصوم.
لكن هذا التحذير لا يعني جواز القذف من غير استيفاء البينة الشرعية. إن ثلاثة من الصحابة جلدوا في حد قذف لما تردد الرابع في الشهادة، فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يقطع بحصول جريمة كالزنا دون استيفاء دليل ثبوتها. لكن يكفي أن تقول إدارة مسجد اتهم أحد العاملين فيه بتهمة قوية: “صدرت تهمة كذا من جهة كذا، وليست عندنا القدرة على التحري التام، لكننا لا نملك مع ما بلغنا من مسوغاتها إلا إيقاف فلان عن العمل” أو نحو ذلك.
وآحاد المسلمين الذين لا يملكون القدرة على تحقيق غلبة الظن ليس لهم أن ينشروا هذه الأخبار دون اطمئنان نفوسهم إلى قوة التهمة والحاجة إلى التحذير من المتهمين، وليكونوا في ذلك تبعًا لعلمائهم والجهات المسؤولة التي يثقون فيها.
متى تحل الغيبة ومتى يحل التشهير ومن المسؤول عنه
قال تعالى: “لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ” (النساء: 148)
وروت فاطمة بنت قيس، أنها أتت النبي r، فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله r: ” أمَّا مُعَاوِيةُ فصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَه، وأمَّا أبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ”. (متفق عليه) قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: “وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع. … ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس.”[29]
وروي عنه r: “اذْكروا الْفَاسِق بِمَا فِيهِ يحذرهُ النَّاس” وهو ضعيف الإسناد غير أن معناه متفق عليه بضوابط فصلوها.
ومن قواعد الشريعة: “يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام” والتشهير بالفساق يردع غيرهم عن فعلهم ويحذر الناس منهم ومن أمثالهم.
إن التشهير بشاهدي الزور والسراق والقوادين والزناة والمحاربين مبثوث في كتب الفقه وإقامة الحدود علانية مقصود منها الردع والتحذير. وقال ابن كثير في قوله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} “هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة إذا كان الناس حضورًا.”[30]
الاستثناءات من حرمة الغيبة
لا يمكن أن تعتقل ألسنة الناس عن الشكوى من الظلمة والتحذير من المعتدين، لأن في ذلك من الضرر على المجتمع ما لا تقره شريعة العليم الحكيم. إذًا، فتحريم الغيبة ليس مطلقًا، بل له استثناءات كثيرة، ففي تهذيب الفروق:
“وتنحصر [الغيبة] التي لا تحرم للغرض الصحيح الشرعي في ستة أبواب نظمها الكمال بقوله
القدح ليس بغيبة في ستة … متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن … طلب الإعانة في إزالة منكر”[31]
ولذلك يقول العلامة ابن حجر الهيتمي: “الأصل في الغيبة الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها … تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة، وهم دعاة إليها ولو سرا فيجوز إجماعا بل يجب.”[32]
وفي تفسير قوله r: ”وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ” يقول الإمام النووي: “وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.”[33]
التشهير
والتشهير يقصد به الردع مع التحذير، وأمره أخطر من الغيبة، وهو عقوبة يتولاها أولو الأمر، وفي حاشية ابن عابدين بيان طريقتهم في التشهير بشاهد الزور. “قال أبو حنيفة في المشهور: يطاف به ويشهر، ولا يضرب.”[34]
وفي الحاوي: ” وإشهار أمره، أن ينادى عليه، إن كان من أهل مسجد على باب مسجده، وإن كان من سوق في سوقه وإن كان من قبيلة في قبيلته.”[35]
وقال الإمام أبو العباس ابن تيمية: “والقوادة التي تفسد النساء والرجال ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها.”[36] وهذا هو معتمد مذهب الحنابلة كما في الإقناع.[37]
وكانوا يشهرون بأمثال “الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس، فيراعي أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم، ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره لئلَّا يغتر به من لا يعرفه.”[38]
وكذلك مدمن الخمر لأن أذاه متعد، وفي المنتقى شرح الموطأ: “وهل يطاف بشارب الخمر؟ قال ابن حبيب: لا يطاف به ولا يسجن إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن يطاف به ويفضح ومثل ذلك روى أشهب عن مالك في العتبية ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذا الحد من الفسق والفجور فواجب أن يفضح لأن في ذلك ردعا له وإذلالا له فما هو فيه وإعلاما للناس بحاله فلا يغتر به أحد من أهل الفضل والتصاون في نكاح ولا غيره.”[39]
وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية: “الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك؛ كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده ويمثل به بحلق رأسه.”[40]
من المسؤول عن التشهير
كما تقدم، فإن التشهير عقوبة وهي من صلاحيات ولاة الأمور في بلاد المسلمين، ولكن كيف يمكن للمجتمعات المسلمة خارج ديار الإسلام حماية أنفسها من النصابين والمحتالين والفساق المعتدين والزنادقة الأفاكين؟ تنتقل هذه الصلاحية إلى جماعة المسلمين.
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله: “… وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين فيجب عليهم أن يلتمسوا واليًا مسلمًا منهم …”[41]
وقال العلامة الخرشي – رحمه الله – في شرح المختصر أن لزوجة المفقود أن ” ترفع أمرها إلى القاضي أو إلى الوالي … وإلا فلجماعة المسلمين أي فإن لم تجد المرأة أحدا ممن ذكر فإنها ترفع أمرها إلى جماعة المسلمين والواحد منهم كاف…”[42]
وقال الإمام الجويني – رحمه الله: “أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر… فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.”[43]
وقال الإمام أبو يعلى – رحمه الله: “ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت. فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد. وإن كان مفقودا صح.”[44]
لكن الجماعة لن تجتمع كلها حتى تقرر، وليس عندنا ولاة أو قضاة بالمعنى الكامل، فالواجب إذَا أن يولي المسلمون هذه الأمور للثقات من أهل العلم، وهيئات الفتوى ولجان التحكيم، ولو استطاعوا تكوين هيئات تعنى بتحري حالات الإساءة داخل المساجد والمنظمات الإسلامية بموازاة السلطات المحلية، فقد يكون في هذا خير عظيم وقطع لمادة البلبلة والاضطراب، و”للوسائل أحكام المقاصد.” ويمكن للمجتمع المسلم تحديد صلاحيات هذه الهيئات ورسم خطة عملها، مع مراعاة القوانين والأعراف السائدة، ولا عجب في ذلك، فإن هذه الولايات لم تأت لها حدود واضحة في الشرع، وفي ذلك يقول الإمام تقي الدين ابن تيمية: “عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر؛ وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال.”[45]
ومع عدم وجود هيئات مسؤولة يقوم أفراد الجماعة المسلمة المطلعون على مجريات الأمور بواجب تحذير المسلمين والنصح لهم من غير قطع بتهمة قبل أوانه ومن غير زيادة على القدر المطلوب لحصول الحذر وحماية أفراد المجتمع، فالضرورة تقدر بقدرها وما جاز لعذر بطل بزواله. كما ينبغي الحذر من الشماتة والسخرية وسائر أمراض القلوب التي تجد متنفسًا في هذه الفواجع من الكبر والعجب والحقد والحسد وغيرها، فمن شك في نيته، فليمسك لسانه وليحفظ قلبه، وليس إبداء الرأي في كل شأن من الشؤون واجبًا على أحد، وقد يكتفى من الأفراد بمشاركة منشور توضيحي أو تحذيري كتب بصياغة حسنة من جهة مسؤولة أو عالم عرف بسلامة نيته ورجحان عقله وحسن تدبيره.
توزيع المسؤولية
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: “كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.” (أخرجه أحمد والترمذي)
الغافلون وحدهم هم من يطمئنون إلى نواياهم. أما أهل اليقظة، فهم دائمًا متهمون لأنفسهم غير راضين عن تجردهم، وغير آمنين لحظوظ أنفسهم، وكلما عظمت الغفلة اشتدت جرأة الناس على الخوض فيما لا يحيطون به علمًا، فعندما تقع مثل هذه البلايا، تجد لسان حال كثير من الناس: أنا خير منه أو فئتي خير من فئته، ومنهم من يريد لوم المجتمع الذكوري ومنهم من يريد لوم “رجال الدين” ومنهم من يجدها فرصة ليظهر حقده على مؤسسة بعينها أو طائفة، فيذهبون مذاهب شتى في توزيع المسؤولية.
ونحن هنا نرجو أن يهدينا الله إلى القسط في بيان مسؤولية المجتمع والمؤسسات والأفراد، ولكن لنبدأ بذكر حكمة لأحد العارفين، ابن عطاء – رحمه الله – نحتاج استصحابها في مطلبنا هذا وغيره. قال – رحمه الله: “من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية فاطلاعه فتنة عليه وسبب لجر الوبال إليه.”[46]
أولًا المجتمع المسلم
نحن بداية، ومن منطلق عقائدي، نرفض أن يسوى بين الإسلام وغيره من الأديان في هذا الصدد. إن تساوت العوامل الأخرى، فالإسلام بتعاليمه وأحكامه يقي من هذه القاذورات، وابحث بنفسك عن خرائط توزيع مرض نقص المناعة في العالم، وستجد مصداق قولي هذا، وهو مع تخلف الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية في أكثر بلاد المسلمين عن غيرها.
لكن قد يقال إن المجتمع المسلم فيه شيء من الطغيان الذكوري وأن المسلمين ما زالوا يوقرون رجال الدين منهم أكثر من غيرهم، فلهم من المكانة ما ليس لغيرهم، مما قد يؤدي إلى سوء استعمال البعض لهذه العطايا الإلهية.
كل هذا قد يكون له من الحق نصيب، وسبب الأول، عندما لا يكون وهمًا، ليس الإسلام، بل سوء فهمه، فنسعى في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومقاومتها بما استطعنا، وننشر العلم بصحيح الإسلام ونعظم الشريعة ونوقر حملتها لينظروا في سبل تطبيقها وتحقيق مقاصدها في الواقع المتغير. والثاني لا يحتاج إلى تبرؤ، ولكن الإسلام أيضًا هو الذي أكد أن بني آدم خطاؤون، ولم يجز يومًا لأحد طاعة أحد في معصية الله، ويأتي مزيد بيان لهذا الأمر.
ثانيًا: المؤسسات
يجب على المؤسسات
- تعزيز الأخلاق والتزكية بين المعلمين والطلاب
- تعليم العامة التفكير النقدي المستقل وفهم حدود المسؤولية الشخصية وعدم التبعية المطلقة لأي شخص
- عدم المبالغة في حقوق المشايخ وتجنب إضفاء هالات شبه نبوية عليهم والتأكيد على أن العصمة للأنبياء وأن كل بين آدم خطاء، وأن المرء، وإن مشى على الماء أو طار في الهواء، فليس ذلك بشيء حتى يرى تمسكه بالشريعة وتعظيمه لحدود الله
- تطبيق إجراءات حذرة عند التوظيف وحسن اختيار المدرسين وقد رُوي: “مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ” ومعناه متفق على قبوله.
- مراعاة التعاليم الشرعية في أمور العلاقة بين الجنسين وترتيب مجالس العلم وسائر المناشط الدعوية والاجتماعية وغيرها، من غير إفراط أو تفريط
- الأخذ بأسباب الوقاية من الإساءة إلى أي من منتسبيها، سيما الأطفال منهم وتوفير بيئة آمنة لهم
- التعاطي الجاد مع الشكاوى ومواجهة أي انحرافات عند ظهورها بحسم وتجرد
بعد هذا، فلا ينبغي أن نلوم مؤسسة على اهتمامها بمهارات الحديث أو كاريزما المتحدثين، فإن وصول الدعوة لقطاعات أوسع مقصود حسن ومهم، وكان نبينا يحب أن يكون أكثر الناس تبعًا، ولم يكن اختيار مصعب الناشئ في النعمة لتعليم أهل المدينة إلا لمناسبته لهم.
ويجب على المجتمع أن يدرك أن الأخطاء قد تحدث رغم أفضل الجهود للوقاية منها، فلا سبيل لنا إلى الكشف عن بواطن الخلق، ومن خدعنا بالله انخدعنا له.
ثالثًا: الأفراد
أولًا: الأطفال
الأطفال دون التمييز غير مكلفين ولا ملومين إجماعًا، وهم كذلك إلى البلوغ عند جماهير أهل العلم، وعليه المعتمد في المذاهب الأربعة. الأطفال إذًا لا تنسب إليهم جريمة، وإن كنا نؤدبهم ونعلمهم ما ينفعهم، بل ونعاقبهم على الخطأ كذلك عند وقوعهم فيه، وقد قال رسول الله r: “مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ” وفي الصحيحين قالَ إبراهيم النخعي: “وكانُوا يَضْرِبُونَنا علَى الشَّهادَةِ والعَهْدِ ونَحْنُ صِغارٌ.”
ثانيًا: البالغون
طبعًا نحن نفرق بين ذات الخمسة عشر عامًا وذات الخمسين، لكن التكليف في الإسلام منوط بالبلوغ والعقل والقدرة، فكل بالغ عاقل مختار، فهو مكلف، بخلاف الصغير والمجنون أو المعتوه والمكره. وتحميلنا لكل الأطراف قدرًا من المسؤولية لا يعني أن هذا القدر لا يتفاوت تفاوتًا عظيمًا أحيانًا. لكن هناك دائمًا أسئلة تطرح في مثل هذه الأحوال والتي تحصل فيها تجاوزات أخلاقية يكون طرفاها رجل وامرأة أو أحد أطرافها شخصًا صاحب مكانة وتأثير.
هل المرأة مسؤولة، وإن كانت فتاة جاوزت البلوغ بقليل؟
الجواب أنها قطعًا مسؤولة مع العلم والاختيار. وهذا الذي ينبغي أن نربي بناتنا عليه ونتوقعه منهن. بعض الناس يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء إلا المسؤولية، فعندها يصورونها على أنها كائن ضعيف يخدع، فيرفعون عنها المسؤولية ويصورونها على أنها دومًا ضحية، وفي ذلك من التناقض ما فيه، وهو أيضًا يفسد المرأة ويحقرها في نفسها وفي نظر الناس. الإسلام يسعى لتكريم المرأة، مع إدراك الفروق بين الجنسين التي تدفع إلى مزيد من حمايتها ومن ذلك ولاية الأب وقوامة الزوج، ولكنه يسوي بينها وبين الرجل أمام الله، وفي الوظيفة الكبرى: العبادة والخلافة. قال الله تعالى: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.” (التوبة: 71)
وقال رسول الله: ” إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.” (أبو داود)
بل إن من لطائف التفسير أن بدأ الله بالسارق عند ذكر عقوبة السرقة قبل السارقة ولكنه بدأ بالزانية قبل الزاني، وذلك لأن السرقة أقبح من الرجل لقدرته على التكسب والزنا أقبح من المرأة لأن عندها من الوازع الطبعي عنه ما ليس عند الرجل.
مسؤولية المصاب بمرض نفسي
وهناك سؤال آخر عن مسؤولية الإنسان المصاب بمرض نفسي. إن مناط الأهلية هو العقل، فبه يستطيع المکلف أن يفهم خطاب الشارع، ويوجه إرادته إلى ما کلف به، فالمجنون والمعتوه الذي لا يفهم مراد الشرع منه غير مكلف، وكذلك المغلوب على إرادته. ومرد الحكم بذلك إلى الخبراء. والسفه والغفلة قد ينقصان الأهلية، ولكن لا يمنعانها، فربما خفف عليهم في الحكم، ومثله ما أثر على الإرادة من غير أن يسلبها بالكلية. أما غير هؤلاء، فهم مكلفون ولا ريب في أحكام الدنيا، وإن خفف عن بعضهم في أحكام الآخرة لما ابتلوا به أكثر من غيرهم من تشوهات عقلية ونفسية تؤثر بشكل ما على التصورات والإرادات.
لا يعنينا في التحذير من الضرر تمام أو نقص أهلية المحذر منه، بل يحذر من كل من خشي ضرره. وما يعنينا في كلامنا عن توزيع المسؤولية كجهات غير قضائية هو فهم الدرجات المتفاوتة من هذه الأمراض، وأنه لا يعفي الإنسان من المؤاخذة والعقوبة إلا ما منعه من الفهم أو التوجيه الصحيح للإرادة، وغيرهم يوجه إليهم اللوم بدرجات مختلفة، وتترك موازين الآخرة في يد الملك الديان.
عند عدم تساوي الطرفين
بقي سؤال أخير، وهو ماذا لو كان الفعل المحرم وقع بين طرفين غير متساويين، كأن يكون أحدهما شيخًا للآخر أو معلمًا؟ والجواب هو تحميل المسؤولية للطرفين، ولكن الحساب على قدر العطاء، ولا شك أن الأعلم والأسن أعظم مسؤولية، سيما إن كان له نفوذ روحي على المريد. وقد يتوسل بعض الناس بالدين إلى انتهاك الحرمات، مما يوقع كثيرًا منهم في الزندقة ويحجبهم عن التوبة وهؤلاء من أولى الناس بسوء الخاتمة. “إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ” (الأنفال: 58)
لكن ديننا لم يبرئ الضعفاء، والحوارات القرآنية الكثيرة بين الضعفاء والتابعين والمستكبرين والمتبوعين كلها تشير إلى ذلك. “قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.” (غافر: 48)
وفي مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله قال: “وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا…”
وفي المفهم:”هؤلاء القوم ضعفاء العقول، فلا يسعون في تحصيل مصلحة دنيوية، ولا فضيلة نفسية ولا دينية، بل يهملون أنفسهم إهمال الأنعام، ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال والحرام.”[47]
وفي الكبائر: “وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال إني رجل أخيط ثياب السلطان هل أنا من أعوان الظلمة فقال سفيان بل أنت من الظلمة أنفسهم ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط.”[48] وقد روي مثله عن ابن المبارك وأحمد، ومرادهم ليس التسوية في الإثم، بل التأكيد على المسؤولية الشخصية، حتى لا يعتذر أحد بضعفه، إن كان عالمًا بما يفعل مختارًا. ومن قواعد الشريعة: “يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًا.”[49]
وقد أكد النبي معنى المسؤولية الشخصية بما لا مزيد عليه فعن علي – رضي الله عنه: “بَعَثَ رَسُولُ اللهِ r سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ r أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ r مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ r فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.”
إن هذا الأمير لم يوله إلا رسول الله، فهل هناك سلطة دينية أعظم من ذلك؟ ورغم ذلك، قال “لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا”
ما هي سبل الوقاية من هذه الخطوب والحد من آثارها عند وقوعها؟
لا نستطيع استيعاب هذا المحور في هذا المقال الذي أردت منه وضع خارطة طريق للمسلم الذي تصله أخبار هذه الفضائح ليضبط تصوراته وتصرفاته ويخرج من الأزمة غانمًا أو على أدنى تقدير سالمًا. لكن سبق لنا في ثنايا الكلام ذكر بعض المعاني التي لو راعيناها كأفراد ومؤسسات ومجتمعات يرجى أن نحد من انتشار هذه الفواحش وشيوعها في المجتمع. وأرى أن من أهم القيم في هذا الشأن:
- تقوية الإيمان والإخلاص
- التربية على الفضائل والتحذير من الرذائل
- التمسك بالتعاليم الإسلامية في معاملاتنا وترتيب مؤسساتنا ومجتمعاتنا
- التأكيد على المسؤولية الشخصية والتفكير النقدي
- ترك المبالغة في حقوق وأقدار المشايخ والمعلمين والتأكيد على انهم غير معصومين
- الصدق والشفافية في التعامل مع الحقائق وعدم إنكارها محاباة للمعتدين أو خوفًا منهم أو من أشياعهم
- كذلك، فإن من مسؤولية الأفراد والمؤسسات، مع الحرص على البراءة من السوء، أن يحرصوا على تبرئة أنفسهم، فليس أحد أولى بحسن الظن من نبينا r، وهو مع ذلك يحرص ألا يجعل للشيطان سبيلًا إلى قلوب أصحابه، فعن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: “كَانَ النَّبِيُّ r مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي – وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ – فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ r أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ r: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ! فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا – أَوْ قَالَ: شَيْئًا.” (متفق عليه)
لا أعتقد أن أحدًا يخالف في هذه القيم، فكلنا نحسن التجريد، والإشكال الذي نعاني منه دومًا هو تحويل منظومتنا القيمية إلى أفعال وإجراءات في الواقع تحقق هذه القيم وتبلغنا مراداتنا منها، وهذا دور أهل العلم والخبرة من الصالحين ومريدي الخير.
كيف تسلم أنت وكيف يسلم لك قلبك وظنك بالناس عمومًا والصالحين من عباد الله خصوصًا؟
راقب نيتك وابك على خطيئتك وأقبل على شأنك، “فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه” و “من كثر كلامه كثر سقطه،” وطهر قلبك من آفاته، ومنها سوء الظنون وإرادة العنت للخلق، ثم لا تتجسس ولا تتحسس ولا تفتش عما غاب عنك، ثم لا تتسرع في الخوض في أمر قبل التبين، فمتى تبينت، فإن وجدت حزنًا وأسىً في قلبك على أحوال الناس وغصة في حلقك بذكر فضائحهم كالتي يجدها آكل الميتة المضطر، فيرجى أن يكون تحذيرك من العصاة والمفسدين خالصًا لوجه الله ولخير عباد الله، لكن احرص ألا تقطع بالفاحشة أو ترمي أحدًا بها دون اكتمال البينة، وإن كان عدم القطع لا يمنع من التحذير عند قوة التهمة وخوف الضرر.
وبعد ذلك، إياك أن تسوء ظنونك بالناس كلهم، سيما أهل الصلاح، فهناك فرق بين الحذر وسوء الظن، فسوء الظن بمن ظاهره العدالة محظور، والتساهل في ذلك يكر على قلب الإنسان فيفسده ويقسيه، ونختم كلامنا بهذه الفائدة من طبيب القلوب الإمام ابن القيم – رحمه الله، يقول:
“والفرق بين الاحتراز وسوء الظن: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافرا، فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق، وكل مكان يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه. فالمحترز كالمتسلح المتدرع الذي قد تأهب للقاء عدوه، وأعد له عدته، فهمته في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به، وكلما أساء به الظن أخذ في أنواع العدة والتأهب. وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبدا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض. يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرهم ويحذرون منه. فالأول يخالطهم ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم ويلحقه أذاهم. الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغض..” [50]
اللهم احفظ الإسلام وأهله، وجنبنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.
الأربعاء، 25 جمادى الأولى، 1446، 27 تشرين الثاني، 2024
[1] إحياء علوم الدين، الغزالي، ج ٣، ص ١٥٠، دار المعرفة، بيروت.
[2] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو يعلى، ص ١١٢، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
[3] الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، ج ١، ص ٤٥، عالم الكتب.
[4] الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج ٢، ص ٢٧، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
[5] تنبيه الغافلين، ابن النحاس، ص ١٧٢، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
[6] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ٢٨، ص ٢٣٧، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.
[7] الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج ٢، ص ٢٣، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.
[8] الأذكار، النووي، ص ٣٣٢، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ هـ.
[9] الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، ج ١، ص ٢٣٣، عالم الكتب.
[10] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ٢٨، ص ٣٧٢، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
[11] سنن البيهقي الكبرى، كتاب الدعوى والبينات.
[12] كشف المخدرات والرياض المزهرات، البعلي، ج ١، ص ١٢٣، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٣ هـ. التقرير والتحبير في علم الأصول، ابن أمير الحاج، ج ١، ص ٦٦، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧ هـ. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، الشوكاني، ج ١، ص ٢١، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ هـ.
[13] التعريفات، الجرجاني، ص ٢٢٣، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
[14] الحبال من الليف تشد بها البيوت فإن تنازع الجيران على حائط ينظر إلى معاقدها فمن كانت من جهته فالحائط له.
[15] الفروق، القرافي، ج ٤، ص ١٨٩، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.
[16] انظر كتابيه «إعْلام المُوَقِّعِين» و«الطُّرُق الحُكمِيَّة»..
[17] انظر المصدرين السابقين والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج ١٠، ص ٢٣٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت. الفروع، ابن مفلح، ج ٦، ص ٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٨ هـ. السياسة الشرعية، ابن تيمية، ص ١٣٦، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى.
[18] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ج ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ هـ. القسم الثاني في أنواع البينات.
[19] حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)، ابن عابدين، ج ٥، ص ٣٥٤، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١ هـ.
[20] شرح مختصر خليل، الخرشي، ج ٨، ص ١٠٩، دار الفكر، بيروت. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج ٤، ص ٣٥٣، دار الفكر، بيروت.
[21] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج ١٠، ص ٢٣٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت. الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح، ج ٦، ص ٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤١٨ هـ. السياسة الشرعية، ابن تيمية، ص ١٣٦، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى.
[22] معين الحكام، الطرابلسي، ص ١٦٦، دار الفكر، بيروت.
[23] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث: الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية للدكتور حسن بن محمد سفر، ج ٣، ص ٣٥٠.
[24] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، ج ٢، ص ٢١٥–٢١٦، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م.
[25] الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص ٢٦٠، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م. الأحكام السلطانية، الماوردي، ص ٣٢٤، دار الحديث، القاهرة.
[26] الذخيرة، القرافي، ج ١٠، ص ٤١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.
[27] التفسير القيم (تفسير القرآن الكريم)، ابن القيم، ص ٤٧٩، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
[28] هذا في اصطلاح الأصوليين، والفقهاء يطلقون الشك أحيانًا على ضد اليقين. في المغني لابن قدامة 1:263: “ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي، لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل.”
[29] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ٢٨، ص ٢٢٩، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
[30] تفسير ابن كثير، ج ٥، ص ٤٨٩، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣١ هـ.
[31] أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج ٤، ص ٢٣٠، عالم الكتب، ومعه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، للشيخ محمد بن علي بن حسين، وفيها اختصر الفروق وهذبه.
[32] الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج ٢، ص ٢٣، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.
[33] المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج ١٦، ص ١٣٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
[34] حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين، ج ٤، ص ٨٢، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
[35] الحاوي الكبير، الماوردي، ج ١٦، ص ٣٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.
[36] الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ج ٥، ص ٥٣٤، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
[37] الإقناع، ابن حنبل، ج ٤، ص ٢٧٣، دار المعرفة، بيروت.
[38] الأحكام السلطانية، الماوردي، ص ٣٧٠، دار الحديث، القاهرة.
[39] المنتقى شرح الموطإ، الباجي، ج ٣، ص ١٤٥، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٣٢ هـ.ـ
[40] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ٣٤، ص ٢١٦، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
[41] حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين، ج ٥، ص ٣٦٨–٣٦٩، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
[42] شرح مختصر خليل، الخرشي، ج ٤، ص ١٤٩، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الثانية، ١٣١٧ هـ.
[43] غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، ج ١، ص ٢٧٩، مكتبة إمام الحرمين، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ.
[44] الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص ٧٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
[45] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج ٢٨، ص ٦٨، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
[46] فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ج ١، ص ٤٧٤، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى.
[47] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، ج ٧، ص ١٦٦، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، ودار الكلم الطيب، دمشق – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م.
[48] الكبائر، الذهبي، ص ١١٢، دار الندوة الجديدة، بيروت.
[49] موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج ١٢، ص ٣٩١، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.
[50] الروح، ابن القيم، ج ٢، ص ٦٦٧، دار عطاءات العلم، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٤٠ هـ.