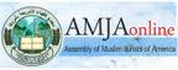مقدمة
بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن ربه فأتم البلاغ، وبين لنا شرائع ديننا في شتى مناحي الحياة، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد،
فهذه ورقة مقدمة إلى دورة مجمع فقهاء الشريعة الثامنة للأئمة، طلب مني أن أجيب فيها بشيء من الاختصار غير المخل عما يثار حول الشريعة الإسلامية وموقفها من ماهية التدين وقضية التجديد ومسألة الديمقراطية. وبين يدي مقالتي، أحب أن أشكر القائمين على المجمع لطرحهم تلك القضايا للمناقشة، وذلك لأن الحاجة الآن قد صارت ماسة لتحرير خطابات جماعية للمسلمين يفرزها الحوار الإسلامي الإسلامي قبل الحوار مع الآخر.
إنه في نفس الوقت الذي أظهرت فيه تسريبات ويكيليكس عن بعض محادثات الدبلوماسيين أن الناس كلهم لا يقولون كل ما يعتقدون، فإنها بينت أن المساحة بين ما يتهامس به هؤلاء وما يصرحون به ليست بذلك البعد، ولعل هذا لأن القوم حرروا خطابًا ينطلقون منه لخدمة كل مصالحهم من غير أن يكون معيبًا من الآخرين، على الأقل في منطوقه.
إننا لا ندعو إلى استنساخ خطاب أحد، ولكن ندعو إلى إدراك حقيقة مهمة، وهي أن العالم صار كحجرة صغيرة، فلم يعد خطاب الشيخ لطلبته قاصرًا علىهم، فإنه متى سجل يصير خطابًا إلى الدنيا. هذا لا يعني التفريط في تعليم شبابنا ما يحتاجونه ولا التفريط في ثوابتنا، ولكن دعوة إلى تحرير الفهم وضبط العبارة وعدم التجاوز فيها، وليس جنى النحل وقيء الزنابير إلا شيئًا واحدًا!
إن هناك مثلاً كثيرًا من علل تشريع تعدد الأزواج، لكن معرفة ثقافة المخاطبين، بل الأعراف المعاصرة عمومًا سيكون مهمًا لحسن عرضها وترتيبها.
ولقد قلت “أن الحاجة الآن قد صارت ماسة لتحرير خطابات” ولم أقل “خطاب” لتعذر توحيد خطاب المسلمين، بل الإسلاميين، فما زال الناس يختلفون. لكن اجتماع طوائف من المتقاربين فكريًا في مؤتمرات أو لقاءات لتحرير خطاب جامع لهم سيكون له أثر طيب على دقة الخطاب واعتداله، وسيقلل من النزوع إلى التطرف في أي اتجاه، ويقلل من حالة تعدد الخطابات بتعدد الدعاة، فكما لعبت المذاهب دورًا في التأكيد على تعددية الفقه والفكر، فإنها أسهمت في حمايتهما من تعددية بلا زمام ولا خطام. وما كان نهر النيل ليصل إلى غايته بشمال مصر لو كان له ألف فرع.
إن بعض الإسلاميين عند حديثه عن العلاقة مع الآخر يستحضر في ذهنه فيكتور أريغوني المتضامن الإيطالي مع القضية الفلسطينية أو راتشيل كوري المتضامنة الأمريكية والتي قضت تحت دبابة إسرائيلية، والبعض يستحضر صورة شارون أو كاهانا.
أنا لا أشك أن هناك ثوابت أتى بها الوحي لا تؤثر (أو ينبغي ألا تؤثر) عليها التجارب الشخصية، ولكن هناك مساحة مما يخضع للتأويل ومما يتأثر بالحالة النفسية للناظر. إن التئام مجموعات من الناس في أمثال هذه المؤتمرات سيؤدي إلى موازنة الرؤى المختلفة المتأثرة بتجارب ونفسيات متباينة.
وأنا إذ أتناول هذه المحاور الثلاثة، التدين والتجديد والديمقراطية، سأبدأ بالأعم فالأخص، فأجيب بما تيسر لي عن التدين ومعناه في الإسلام وما يخيف غير المتدينين منه وكيفية بيان حقيقته في ديننا لهم، ثم أعرج على قضية التجديد وموقف الشريعة من مفاهيمه المختلفة ومتى يكون التجديد تبديدًا ومتى يكون الثبوت جمودًا. وأختم كلامي ببيان الكيفية التي ينبغي – في تصوري – أن نعبر بها عن موقف الإسلام من الديمقراطية.
الشريعة والتدين
إنه وإن كانت للمتدينين بعض الخصائص الجامعة على اختلاف أديانهم، فإن التدين ليس شيئًا واحدًا، بل يختلف باختلاف الدين الذي يعتقده ويمارسه هذا المتدين أو ذاك، وكذلك يتفاوت الناس في فهمهم لأديانهم.
إن التدين في الإسلام ليس رهبنة في الصوامع ولا شقشقة في المنابر، ولكنه موافقة مراد الخالق في كل الأحوال وكل الأمكنة والأزمان، اعتقادًا وقولاً وعملاً. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “السَّاعِي على الأرمَلَةِ والمِسْكينِ كالمجاهِدِ في سَبيلِ الله وأحْسَبه قال وكالقائمِ لا يَفْتُر وكالصَّائم لا يُفْطِر.”
إن الفكر الحداثي المعاصر أراد أن يرسخ صورة نمطية للمتدين في أذهان الناس على أنه جاهل بأمر الدنيا، معرض عن إصلاحها، في سعي أعمى وراء رمزية أسطورية، مع جمود في الفكر والتصور، وديماجوجية في الخطاب، ورعونة تجاه المخالف يزيد من خطرها تعصبه للموافق.
إن الحقيقة أن التدين في الإسلام ليس في حقيقته النقية شيء مما يسعون لإلصاقه بأصل فكرة التدين عمومًا.
أما الجمود، فالإسلام لم يحاصر العقل البشري المبدع في شتى المجالات المعرفية، وتعاليمه في غير أبواب العبادات والآداب جاءت مُجمَلَة وتركت مساحة واسعة للناس لتدبير أمورهم. هذه المرونة كانت سببا في صلاح الشريعة للتطبيق في أمصار وأعصار شتى. وكذلك فإن الإسلام يقر بالاستفادة من كل حكمة، فلا بأس من النظر في شتى النظريات السياسية والاقتصادية والاستفادة من كل صالح فيها، ولكن مع الوعي الذي يعين على تمييز الطالح. قال رسول الله r: “لقد هَمَمْتُ أَنْ انهي عن الْغِيلَةِ حتى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلك فلا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.”[أ] ما أعظم هذا الرسول فهو أتم الناس عقلاً وأوسعهم علمًا وأصوبهم حكمًا، ثم ينظر في أحوال الأمم مستفيدًا من تجاربهم.
وأما الديماجوجية: فقد يأخذ البعض على بعض المسلمين أو الإسلاميين خطابهم الشعبوي التعبوي العاطفي غير العلمي والذي لا يراعي أمانة التحقيق، والإنصاف أن منا من يعتمد هذا النوع من الخطاب. أما مجرد اللوم على الخطاب العاطفي، فهذا من اللوم على المحاسن، فعبقرية الإسلام أنه يوازن بين المادة والروح والعاطفة والعقل. ولكن الخطاب العاطفي لا ينبغي أن يتغافل الحقائق أو يروج الأوهام. إن سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في مراعاة الحقيقة والحرص على التحقيق. إن الإسلام يدعو إلى تحري الحقيقة وعدم القول بغير علم. قال تعالى: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا”[الإسراء:36] إن بعض الدعاة، بل والفقهاء يتساهلون في قبول الحكايات المرسلة وآراء هذا الخبير أو ذاك، مع كون البحث العلمي الآن يجعل رأي الخبير من الأدلة الضعيفة، لكن ذلك أحد مظاهر البعد عن تعاليم الإسلام ومسالك الأئمة الأعلام لا العكس. إن الفقه قد سبق البحث العلمي بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل، فالقرآن والسنة مقدمان على غيرهما، والنص المجمع عليه مقدم على المختلف فيه، وعبارة النص مقدمة على دلالته (مفهوم الموافقة)، وتلك مقدمة على إشارته – عند غير الحنفية ([ب])- ثم تأتي دلالة الاقتضاء. ومفهوم المخالفة – عند من يعمل به – أنواع بعضها فوق بعض([ج]).
وأما زعمهم أن التدين والفقر متلازمان، وأن المتدين معرض بطبيعته عن عمارة الأرض وإصلاح شؤون أهلها، فهذا لا يصح إذا كان الدين المقصود هو الإسلام المنزل من رب الأرض والسماء. قال تعالى مخبراً عن نبيه صالح: “يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا“ [هود: 61]. قال ابن كثير – رحمه الله -: أي جعلكم عُمّاراً تعمرونها وتستغلونها.
إن صناعة النهضة أو الإعانة عليها من أفضل الأعمال، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال – صلى الله عليه وسلم:”الإيمَانُ بالله والجِهَادُ في سَبِيلِ الله”. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال:”أنْفَسُهَا عِندَ أهْلِهَا وأكْثَرُهَا ثَمَنَاً”. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ” تُعِينُ صَانِعَاً أو تَصْنَعُ لأخْرَق”[متفق عليه] إن الذي يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي إنما يعين الآلاف أو الملايين من الفلاحين على عملهم، وكذلك كل عمل يسهم في نهضة زراعية أو صناعية أو تجارية…الخ. وفي المسند عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إن قامَت السَّاعةُ وبِيدِ أحدِكم فَسِيلةٌ فإن اسْتَطاع ألا تقومَ حتى يغرِسَها فلْيفْعَل.”
وأما الرعونة مع المخالف والتعصب للموافق، فإن ذلك لا يصح عن الإسلام، وإن أكثر أسباب الاحتقان في بعض الخطاب الإسلامي المعاصر تجاه الغرب ليست نابعة من مبادئ عقدية، فلا هي بسبب تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، ولا هي كذلك بسبب البراءة من الكفر وأهله، فكلا الأمرين لا يستدعي الجهر بالسوء، بل إن الله يقول: “وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا” [البقرة: 83] قال عطاء: للناس كلهم، وقال ابن عباس – رضي الله عنه – “لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، لقلت: وفيك”. [صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد – رقم: 848]
إن الإحسان إلى الغير في الإسلام لا يقف عند الخطاب بل يتعدى ذلك إلى الفعل، قال تعالى: “يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.” [المائدة: 8] وقال: “لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.” [الممتحنة: 8]
أما الولاء للموافقين في الدين، فإنه وإن كان التاريخ شاهدًا على أن الإفراط فيه، كما في القبلية والوطنية وغيرهما، قد أدى بالفعل إلى حروب ونزاعات لا تخمد حتى تشب ثانية، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد خلص هذا الولاء العقدي من الشوائب التي تصيب معنى الولاء في العموم عندما قال: “انْصُر أخَاك ظَالماً أو مَظلُوماً”، فقال رجل: يا رسولَ اللهِ أنْصُرُه إذْ كان مظلوماً، أفَرأيتَ إذا كان ظالماً كيف أنْصُرُه؟ قال: “تَحْجِزُه أو تَمْنَعُه من الظُّلم، فإن ذلك نَصْرُه.” [أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه] ما أجمل تعليمه وما أحسنه! إنه ولاء لا يحمل صاحبه على بغي أو عدوان أو هضم حق أو مشايعة على باطل. بل لقد تنزلت من القرآن آيات تدافع عن يهودي اتهمه منتسب للإسلام بسرقة ظلمًا، فقال الله تعالى لرسوله: “إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.” [النساء: 105] ولقد ذكر الأستاذ سيد قطب – رحمه الله – في الظلال معنىً جميلاً، وهو أن الخائن هنا كان من الأنصار الذين آووا ونصروا، وكان تثبيت التهمة على اليهودي يبعد شبح الشقاق بين الأنصار، وذلك بنسبتها إلى أحد يهود المدينة الذين ما برحوا يكيدون للمسلمين بها ويؤلبون عليهم المشركين ويحرضون المنافقين. لقد جاءت هذه الآيات ليقول الله سبحانه للجماعة المسلمة إن العدل بين الناس، كل الناس، هو أس المنهج الرباني، فهو بذلك فوق كل الاعتبارات المصلحية.
الشريعة والتجديد
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الامة على رَأْسِ كل مِائَةِ سَنَةٍ من يُجَدِّدُ لها دِينَهَا.”[د] فلا يسوغ إذًا أن يُنكَر على من قال بتجديد الدين، كون القائل الأول بهذا المعنى هو رسول الله، ولكن يكون النقاش عن ماهية التجديد المقصود.
الأصل أن الدين لا تغير فيه، وأكثر التجديد المقصود هو تجديد إحياء أو تنقية، والأول بمعنى إحياء ما انطمس واندرس من السنن ونشرها بين الناس والثاني بمعنى تنقية الدين من البدع والمحدثات ومما علق به من أعراف الناس المخالفة للوحي. ولكن هناك نوع آخر من التجديد، وهو التجديد الاجتهادي، ومن أمثلته: منع أمير المؤمنين عمر المؤلفةَ قلوبهم من سهمهم، لما رأى عزة الدين وتمكين الله للمسلمين زمن خلافته المباركة، وأمر أمير المؤمنين عثمان بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها، وكان الأصل النهي عن التقاطِها، وذلك لما رأى فساد الذمم. وكان العمل مستقرا عند أكثر السلف على تحريم تعاطي الأجر على تعليم القرآن، ثم أذن فيه لما قل المتطوعون خوفًا من ضياع القرآن.
ولكن هل غير هؤلاء الأكابر الحكم الشرعي؟ كلا فحكم الله لا يتغير ألم يقل تعالى: “اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ” [التوبة:31] وبيَّن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعَدِيِّ بن حاتم – رضي الله عنه – أن ذلك كان باتباعهم إياهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال.[ه] ثم ألا يكون ذلك عين ما نهى عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: «من أحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس مِنْه فَهُو رَدٌّ»[و]
إذًا يمتنع أن يكونوا غيروا حكم الله، وإن استعمل بعض العلماء هذا المصطلح، فإنما عنوا الفتوى لا الحكم الشرعي. إن العمل الواحد قد يكون له حكمان بحسب ما يكتنفه من أحوال مختلفة. وإن للحكم الشرعي الواحد – كما قال الإمام الشاطبي – اقتضاء أصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على العمل مجردًا عن التوابع والإضافات، واقتضاء آخر بعد إضافة العوامل الخارجة عن العمل والمؤثرة فيه.
ولتوضيح ذلك، نأخذ كمثال أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والتي كان المنع منها موضع اتفاق الأحناف المتقدمين ثم أذن فيها المتأخرون، والسؤال، هل جرى المنع والإذن على شيء واحد؟ إنه ليبدو كذلك، ولكن مع التدقيق يظهر أنه لا يصح أن يسوى بين أخذ الأجرة على تعليم القرآن في زمان توافرت فيه الهمم على فعل ذلك قربة، وحصل المعلمون كفايتهم من بيت المال، وأخذها في زمان ليس للمعلمين فيه أرزاق تجري عليهم من بيت المال، فإن هم انصرفوا للتعليم ضاع عيالهم، وإن انصرفوا إلى تحصيل الرزق ضاع تلاميذهم.
فالحاصل أن الواقع المعين قد تناسبه أحكام مختلفة من وجوه، فيختار المجتهد أنسبها له. وقد يتنازعه أصلان أو حكمان فيلحقه الحاكم بأقربهما إليه في المعنى والمبنى، وإن كان اعتبار المعنى مقدمًا عند التعارض استحسانًا. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله: «إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فُرِض بقاء الدنيا إلى ما لانهاية، والتكليف كذلك، لم يُحتَج في الشرع إلى مزيد. ومعنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم بها…»[ز]فالأصلان في مثال أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن هما: الأول تجريد النية لله في القربات الذي رجح الحظر في الزمان الأول والثاني حفظ القرآن بتعليم الصغار إياه الذي رجح الإباحة في الزمان الثاني.
بقي أن هذا النوع من التجديد الاجتهادي، والذي لا يشمل أبواب العبادات ولا المقدرات في الشريعة كالحدود والكفارات، لا يصلح له إلا أفذاذ المجتهدين من العلماء في كل عصر، ولو ترك لغيرهم ممن هو دون رتبة الاجتهاد المطلق، لصار الدين في خطر وتعرض للتحريف. ولا نحتاج إلى ذكر جرم من فعل ذلك من غير العلماء أصلا، فإنه الطامة الكبرى وهو افتراء على الله – عز وجل – وقول عليه بغير علم. قال الله: “وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً”[الإسراء:36]
إن تجديد المضامين الذي عرضنا له باختصار هو أحد أنواع التجديد ولكن هناك أنواعًا أخرى يتفق عليها أكثر الناس، وهي تجديد القوالب والأساليب، وتجديدها يعني إعادة التعبير عن الذات بآليات معاصرة. والفرق بين القوالب والأساليب أن القوالب هي الأوعية التي تحمل الفكرة المراد تبليغها إلى عقل المخاطَب بغض النظر عن قبوله لها أو رفضه، والأساليب هي ما يعتمد من مسالك لإقناع العقل بها وشرح الصدر لها.
فإذا كان النجاح في مخاطبة إنسان ما يستلزم حصول ثلاث مراحل:
1- نقل الموضوع من المرسل إلى المستقبل.
2- استقباله وفهمه على مراد المرسل.
3- قبوله.
فالقوالب تعنى بالمرحلة الأولى والأساليب بالثالثة وهما يشتركان في الثانية.
القوالب إذًا هي وسائل التوصيل بغض النظر عن الأسلوب والمضمون، فهي وسائل إيصال الفكرة إلى المخاطَب وإفهامه إياها على النحو الذي أراده الداعي سواء اقتنع بها ذاك المخاطَب أم لم يقتنع أو انشرح صدره لها أم لم ينشرح. قال تعالى: “وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ” [القصص: 51]
فالدعوة قد تحمل إلى الناس عن طريق الاتصال الشخصي أو المكاتبة، وهي تشمل في زماننا الوسائل المطبوعة كالصحف والمجلات والمطويات والكتب وكذلك تصل الدعوة إلى قطاعات واسعة في أزمنتنا عبر الوسائل السمعية كالإذاعة والشريط والتسجيلات الرقمية، والوسائل المرئية، كالتلفزيون، على تنوع أشكال المعروض فيه. وهناك الإنترنت الذي يجمع المقروء والمسموع والمرئي.
ولقد استثمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل ما توفر له من هذه القوالب فقال وكتب وعلم وخطب ووعظ ورسم وقص القصص، بل حكاها، وضرب المثل، وشرح بالبيان العملي كما في “صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي” و “خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم”. فمن يزعم مثلا أن استخدام العروض التقديمية في دروس العلم له أصل في السنة فلن يعوزه الدليل، فعن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: “خَطَّ لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ في وَسَطِ الْخَطِّ خَطًّا وَخَطَّ خَارِجًا من الْخَطِّ خَطًّا وَحَوْلَ الذي في الْوَسَطِ خُطُوطًا فقال هذا بن آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الذي في الْوَسَطِ الْإِنْسَانُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ عُرُوضُهُ إن نَجَا من هذا يَنْهَشُهُ هذا وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ.” [سنن الترمذي]
أما الأساليب، فالمقصود بها ما يكون بعد تحديد الداء عند المخاطَبين من الحكمة في معالجته بتنويع البلاغ المتوازن ما بين الخطاب والمحاورة؛ والموعظة والتعليم؛ والترغيب والترهيب؛ والتنظير والتطبيق؛ والتقديم والتأخير؛ والإنذار والتبشير؛ والتدرج من غير تفريط؛ ودفع الشبهات وترسيخ الإيمان؛ ومخاطبة الروح وإقناع العقل؛ والعمل الفردي والجماعي والعمل العلمي والاجتماعي بل والاقتصادي والسياسي.
ورسول الله قد وصل الذروة في تنويع الأساليب فقد خاطب – صلى الله عليه وسلم – القلوب والعقول ورغب ورهب وقدم وأخر، وبشر وأنذر، كما بين لنا أن الأساليب تتنوع بتنوع المخاطب بل واختلاف المكان والزمان والحال، فكانت وصيته لمن استوصاه تارة “لا تَغْضَب” [البخاري] وتارة “اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ واتبع السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ الناس بِخُلُقٍ حَسَنٍ.” [مسند أحمد] وتارة “قل آمَنتُ بالله ثم اسْتَقِم” [مسلم] وتارة “لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا من ذِكْرِ اللَّهِ” [سنن الترمذي] ويسأل عن أفضل الأعمال فيختلف جوابه، فيقول لابن مسعود – رضي الله عنه –: “الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا… ثم بِرُّ الوَالِدَيْن… ثم الجِهَادُ في سَبِيل الله” [البخاري] ويقول للخثعمي: “الإيمَان باللهِ… ثم صِلَة الرَّحِم… ثم الأمْر بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَن المُنْكَر.“ [رواه أبو يعلى بإسناد جيد] ولآخر: “سُرورٌ تُدخِلُه على مُسلِمٍ أو تَكشِفُ عنه كُرْبةً أو تَقْضِي عنه دَيْنًا أو تَطرُدُ عَنهُ جُوعًا.” [في المعجم الكبير بسند حسن]. وعن ذلك المعنى يقول ابن القيم – رحمه الله -: “من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب بل هذا الطبيب وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم.“[ح] والفتوى أقرب للمضامين ولكن الكلام هنا ينطبق من باب الأولى على الأساليب، فإن الداعي الذي لا يختلف خطابه باختلاف المخاطبين وأحوالهم إنما هو كذاك الطبيب الذي لا يعرف إلا وصفة واحدة فهو يعالج بها كل مرضاه.
ولكن تغير الأساليب الذي نقصده إنما هو ما يكون لمصلحة الدين والمخاطَب، وليس هو التلون لمصلحة الداعي، والذي قد لا يختلف أحيانًا في الشكل عما ذكرنا، ولكنه في حقيقته عدوان على الشريعة بالهدم أو التبديل أو التشويه بحجة التجميل، والعبرة قبل سداد العمل بصلاح النية، وتجريدها أشد على السالكين من العمل نفسه، فالشرك فيها قد يكون أخفى من دبيب النمل، والسعيد من وفقه الله إلى كمال الإخلاص.
المطلوب إذًا إعادة المزاوجة بين النظرية والتطبيق، في ضوء اجتهاد يحافظ على الثوابت ويستوعب المتغيرات، كذلك الذي كان في أيام الخلافة الراشدة، والذي مكن الأمة من استيعاب الثقافات الفارسية والرومية والنبطية والكردية والقبطية والبربرية وغيرها مما أدى إلى فعل حضاري وعمراني وثقافي لم يشهد العالم له مثيلا في تاريخه، وذلك من غير أن يصاب جوهر الدين بشيء من التحريف، ولما انحسر هذا الاجتهاد الواعي، وذلك تحديدًا في منتصف الدولة العباسية، بدأت الهوة بين النظرية والممارسة في الخطاب الديني تتسع حتى انقسم المجتمع إلى مترفين غير عابئين بالدين، وصوفيين فر كثير منهم من معترك الحياة إلى روحانيات ورهبنة – وبعضهم إلى الخرافة – ليجدوا فيها ما يملأ عليهم جوانب النفس التواقة إلى الحق، وعلماء منعزلين منكبين على خدمة النصوص والتراث، وعامة تاهوا لما ضل السراة، وقليل من العلماء الربانيين الذين لا يخلو منهم بفضل الله زمان، والذين بقوا يجاهدون في سبيل إحياء ما اندثر من معالم الحق في حياة الخلق.
الشريعة والديمقراطية
إن أي منهج فكري مستعار ستكون له حمولته الأيديولوجية، والتي ترتبط بالبيئة المنتجة له، ولن يخلو من شوبات عقدية. لذا، تحتاج هذه المناهج إلى بيان حقيقتها والموافق منها لمرجعيتنا الإسلامية والمخالف. ولعل الكلام عن موقف الشريعة من الديمقراطية لا بد أن يبدأ من تعريف الديمقراطية، وهي لغويًا، كلمة مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تعني لغة ‘حكم الشعب’ أو ‘حكم الشعب لنفسه’.[ط] ولكن ألحقت بها معان أخرى كالحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ونحن نناقش هنا موقف الإسلام من أصل المصطلح، وكذلك ما ألحق به من تلك المعاني المذكورة.
الشريعة وموقفها من حكم الأغلبية
إذا كانت الديمقراطية تعني في أصلها حكم الشعب لنفسه، والذي هو حكم الأغلبية، فنحن نقر بذلك أصالة، ولكونه السبيل الوحيد إلى الأمن والاستقرار ومنع الفتنة. وإن كان في تراثنا التسليم لإمارة الغلبة من أجل هذه المصالح، فلحكم الأغلبية أرشد منها وأوفق. إن عقد الإمامة لم يثبت لعمر t بعهد أبي بكر t ولكن بقبول المسلمين بعد ذلك وبيعتهم، كما ذكر الإمام ابن تيمية – رحمه الله. وعمر جعل الأمر في ستة وجعل معهم ابن عمر ليرجح بينهم إذا اختلفوا، وفيه مراعاة لمعنى الأغلبية العددية.[ي]
الشريعة وموقفها من الثيوقراطية
في بدايات حديثنا عن الديمقراطية ينبغي التأكيد على أنه لا ثيوقراطية في الإسلام. إن المرجعية الإسلامية ليست مرجعية الإسلاميين، بل الإسلام. إن كلمة أبي بكر في خطبته الأولى “وإن أسأت فقوموني” تكفي لبيان أنه ليس ثمة ثيوقراطية في الحكم الإسلامي. إن الأمور المجمع عليها قليلة والمختلف فيها كثيرة، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في أمور العامة والقضاء، فأهل الحل والعقد أو المجالس المنتخبة ستستمع إلى أقوال العلماء وتختار منها الأظهر والأصلح. كما إن أكثر المسائل التي يناط فيها الحكم بالموازنة بين المصالح والمفاسد سيحسم نتيجتها قول الخبراء بتلك الموازنات. إن المتقرر عند أهل السنة أنه ليس يخرج عن دائرة النقاش والأخذ والرد إلا نصٌ محكمٌ صحيحٌ أو إجماعٌ ثابتٌ صريحٌ أو بدائه العقلِ وأوائلُ الحسِّ التي لا يختلف عليها ذوو الحِجا.
الشريعة وموقفها من الحرية
أما الحرية والتي أريد للديمقراطية أن ترتبط في أذهان الناس بها، وإن كانت الأخيرة لم تمنع شتى أنواع الاستعباد والاستعمار التي مارستها دول ديمقراطية على أمم وشعوب مختلفة، فإن اضطراب خطابنا بشأنها قد يحدث نفورًا منا عند قطاعات واسعة من الناس. إن الدعاة الذين يرشح من خطابهم التوجس من الحرية وآثارها قد ينطلقون أحيانًا من مقدمات صحيحة، ومنها أن الإنسان عبد لله تعالى، فهو من هذه الجهة ليس حرًا، بل عبد محاسب بما يفعل ويقول بل ويضمر – ما لم يكن هاجسًا يدافعه. قال تعالى: “لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ” [البقرة – 284]
ومقام العبودية لله هو أشرف المقامات، وينبغي أن يكون ذلك معلومًا لكل مسلم، كما ينبغي أن يعلم أن التحرر الحقيقي من سلطان المخلوقين لا يتم إلا بتمام العبودية للخالق، وهذا ما جاء به دين الإسلام، كما قال ربعي – رضي الله عنه -: “الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.” فإن من لا تكتمل عبوديته لله لا تتحرر نفسه من سلطان الرؤساء والسادة وشهوة المطعم والمنكح وشدة الرغبة في الجاه والمال…الخ. بل الحرية ثمرة لترديد اللسان والقلب لشهادة التوحيد، قال الحكيم الترمذي: “وجوهر التهليل الوله بآلهيته؛ وطعمه الامتلاء والغنى؛ وريحه البصر؛ وثمرته الحرية، والخروج من الرق، والاعتزاز بالله.”
ولكن الحرية التي تهفو إليها نفوس المسلمين خصوصًا ليست التحرر من العبودية لله، ولكن من قهر البشر، وهذا عين ما جاء به الإسلام، والآيات والأحاديث الدالة على فضل العتق بل والآمرة به، كما في بعض الكفارات، خير دليل على ذلك، حتى عبر الفقهاء عن حرص الإسلام على تحرير العبيد بتشوف الشارع إلى الحرية، يقول ابن القيم: ” “وَأَمَّا الشَّارِعُ فإنه مُتَشَوِّفٌ إلَى تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ.” . وليست الحرية فقط هي ما كان ضد الرق، بل هي ما كان ضد الظلم والقهر كذلك، وإن كان يسيرًا، ولقد قال عمر – رضي الله عنه – لعمرو بن العاص لما ضرب ابنه قبطيًا من أهل مصر في خصومة على سباق كان بينهما: “مُذْ كَمْ تَعَبَّدتُم النَّاسَ وقَد وَلَدَتْهُم أمَّهَاتُهُم أحْرَارًا” إن روعة العدالة الإسلامية مهدت الطريق أمام نفوس المصريين لاعتناق الإسلام الذي أنقذهم من بطش وعسف الرومان، ومن قبلهم الفراعنة، الذين حكموا بسلطان الألوهية المزعومة.
إن الناس قد يحسنون التعامل مع الحرية وقد يسيئون، فما هي إلا ابتلاء كباقي الأحوال التي تعرض للناس في دنياهم، وقد يسقط الناس في اختبار السراء كما قد يسقطون في اختبار الضراء بل وأشد. ولكن التهويل من مخاطرها والكلام مثلا عن إمكان أن تؤدي إلى تشريع زواج المثليين في بلد كمصر، بينما لم يشرع هذا سوى في ولايتين من خمسين ولاية أمريكية، وما زال الجدل فيهما محتدمًا بهذا الصدد، أقول إن هذا قد يؤدي إلى سلبية في التعامل مع نعمة تستوجب الشكر، فقد كان صلح الحديبية فتحًا يستوجب الشكر كونه هيأ الأجواء الآمنة لقوافل الدعوة أن تسعى بحرية في أنحاء الجزيرة. إن هذا الدين عليه نور من الله، فلو ترك الفكر يواجه الفكر لانتصر هذا الدين لا محالة، فظهور الحجة والبرهان له في كل الأزمان. يقول جوته، شاعر وأديب الألمانية الأهم في تاريخ تلك اللغة: ” كلما قرأنا القرآن جذبنا، أعجبنا، بهرنا…”
أما إشكالية حرية التعبير، فتلك مكفولة بضوابطها في الإسلام، ولكن ألا ينبغي أن يكون لها سقف؟ ألا يجرمون في بعض بلاد أوروبا إنكار المحرقة النازية؟ أليست هناك قيم لكل مجتمع يسعى لحمايتها؟ من الذي قال إن الطعن في ذات الله من حرية التعبير المحمودة، وماذا يبقى بعد ذلك؟ هلا احتكمنا إلى الشعوب المسلمة فيما إذا كانت تعتبر العيب في ذات الله أو تجريح الأنبياء من تلك الحرية المطلوبة؟ أم الشعوب ساعتها لا قول لها؟ أولا تكون الديمقراطية إذًا عبثًا إن كانت يهدم بعضها بعضًا، بل تهدم فروعها أصلها.
بقي أن الديمقراطية تجعل التشريع للشعب والإسلام يجعله لله، ولكن من حيث التطبيق، فإن الشعب المسلم هو الذي سيختار حكم الله.
إن الإسلام هو مرجعية هذه الأمة، وإنها لم ولن تعرف مرجعية أخرى تلتقي حولها وتخضع لها فتوحد صفوفها وتضبط إيقاعها لتقودها إلى النهضة. إن لكل حضارة مرجعية مقدسة، وهذه قد تكون روحية أو فكرية أو مادية كتقديس اللذات البدنية (الهيدونية). إن الإسلام كان وما زال اختيار الجماهير الكاسحة في بلاد المسلمين، فلا جرم أنه إن ترك الخيار للشعوب، فلن يكون ثمة خوف على الإسلام من الحرية، بل تكون التربة الصالحة التي تضرب فيها شجرة الدين بجذورها فتستقر لتتطاول فروعها الباسقة فتتشابك وتبسط ظلالها الوارفة على واقع الحياة حتى ينعم بربيع أيامها الناس، كل الناس.
إنه لا بأس أن نضمن في خطابنا عن الحرية معنى العبودية لله، بل ونؤكد أنه من تمام الحرية المنشودة، أما أن نصدر خطابنا بذم الحرية أو يكون ذلك الظاهر من حديثنا عنها، فهذا لعمري ظلم للشريعة وعدوان عليها.
الشريعة وموقفها من كرامة الفرد وحقوقه
إن كانت الديمقراطية تعلي من شأن الفرد وتؤكد حقه في تقرير مصيره، فإن الإسلام كرم الفرد وحفظ له حقوقه كما لم يفعل دين أو منهج فكري آخر، ولكن قد يرشح من كلام بعض الدعاة نوع من ازدراء (العوام) وهذا المنحى خطأ مركب، فهو ناتج عن سوء فهم للنصوص وعدم استيعاب للواقع وما فيه من تغيرات عالمية رفعت من قيمة الفرد، وجعلت عوام اليوم غير عوام الأمس، وإن اشتركوا في أشياء. اليوم، هؤلاء الناس (العوام) يقرؤون ويكتبون ويستمعون إلى الإذاعات ويشاهدون الفضائيات ويطالعون الصحف والمجلات وبعضهم يقرأ الكتب والموسوعات وكثير يرتاد مواقع الشبكة العنكبوتية، أفيجوز أن يعاملوا كمن لم يكن لهم نصيب من ذلك؟ إن هؤلاء العوام أيضًا صارت قدرتهم على الفعل والتأثير في المجتمع أعظم بكثير من أقرانهم قبل خمسين سنة ولا أقول خمسمائة.
إن كتب التراث بها كثير من ذكر العوام والخواص، وإنه لا يختلف اثنان أن ثمة عوام وخواص، ولكن المقصود بالعامي في اصطلاح العلماء في كل علم أو فن أو سلوك هو من لم يكن من أهل هذا العلم أو الفن، وهذا لا يعرف فقط بين علماء الدين، ولكن بين العلماء في كل تخصص. إن الفقيه قد يكون عاميًا في الحديث، والمفسر قد يكون عاميًا في الفقه. إذًا كلمة عامي ليست سبة، ولا تعني تنقصًا من كرامة الموصوفين بها.
إن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا من جميع فئات المجتمع وكان منهم العالم وغير ذلك والقارئ وغير ذلك، ولكن كانت أقدار الجميع محفوظة في هذا المجتمع الأسوة. إن سيد التابعين هو أويس بن عامر القرني – رحمه الله – وقد أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عمر – رضي الله عنه – أن يسأله الدعاء إذا لقيه ولم يكن أويس – رحمه الله – ممن يعرف بالعلم أو يشار إليه بالبنان في عصر التابعين، بل لم يكن يعرفه أحد إلا قليل ممن حوله، ولولا ما كان من إخبار رسول الله عنه، لما بقي له بين الناس ذكر. إنه قد يكون من بين هؤلاء العوام من يرجح في الميزان على ألف ممن يذيع صيتهم وتملأ الآفاق أخبارهم من النخب بل والدعاة أنفسهم.
بقي أن هناك من هؤلاء العوام همجًا رعاعًا، وهؤلاء إنما استحقوا هذا الوصف لا لضعف علمهم أو فقرهم، بل لضعف إيمانهم وسوء أدبهم، فلا يمكن وصف قوي الإيمان الخلوق بشيء من هذا، وليست قلة العلم كذلك هي سبب ذلك الوصف، ولا حتى في وصية علي لكميل التي قسم الناس فيها إلى عالم ومتعلم وهمج، بل هم كذلك لإعراضهم عن العلم وردهم للحق، فالقسمة ثلاثية لا ثنائية. إن هؤلاء واقع لا مراء فيه في كل أمة، ولعل المصطلح الشائع والمقابل للهمج، في الدلالة العرفية بالإنجليزية هو (Mobs).
والخلاصة أنه إن كانت الديمقراطية تعني حكم الأغلبية وسيادة القانون والمساواة بين الناس أمامه، فنحن مع ذلك؛ وإن كانت تعني الحفاظ على كرامة الآدميين، فنعما هي؛ وإن كانت تعني الحرية، فحيهلا، ولكن بضوابطها كما يتفق على ذلك عقلاء الناس.
إن هجوم بعض الدعاة على الديمقراطية أمر مؤسف لأنهم سيظن بهم أنهم يدعون إلى الطغيان، فإن الناس لم يروا آلية غيرها تمنع منه. الحق أن نفصل، وأن نوقف الناس على ما نتحفظ عليه مما يجعله أصحاب هذا المسلك من أركانه أو شروطه. يمكن أن نقول مثلاً إن إجماع مجلس الشعب، بل وكل المجالس، على حل الخمر لن يجعلها حلالا، وفي هذا المثال بيان المقصود بعبارة لا تستهجن ويفهمها العام والخاص ولا يجد مسلم مدفعًا لها.
ولكن في نفس الوقت، لماذا لا نسمي هذا النظام الذي يقر بحكم الأغلبية وسيادة القانون وحفظ الحقوق نظامًا شوريًا وحكمًا رشيدًا؟ ليتفكر العقلاء في بلاد المسلمين في ذلك، فإن تسمية نظامنا بالديمقراطية يجعلنا أسرى في التطبيق لمن يراهم العالم أحق بها وأهلها، وساعتها لن تكون الانتخابات الشفافة التي تأتي بمن يسمون إسلاميين مثلاً ديمقراطية، بل وربما فرضوا علينا قيمًا خارجة عن مرجعيتنا الإسلامية ومنظومتنا الثقافية بزعم أننا لا نكون ديمقراطيين بدونها، فنبقى نلهث وراء القوم، ولن نرضيهم.
ومن جهة أخرى لا بد من دراسة مثالب الممارسات الديمقراطية بالغرب لتفاديها؟ أليس المال يصنع الإعلام والإعلام يشكل وعي الجماهير التي تذهب بالملايين لتختار أحد رجلين أو رجال لا تعرف عنهم سوى ما ينقله الإعلام إليها؟ إن الأوفق هو النظام البرلماني التصعيدي، فإن انتخاب رجل من القرية أو الضاحية يعرفه أهلها غير انتخابهم لصور رجال ترسمها ريشة أصحاب النفوذ والمال. إن هذا الأمر قد خف بعد ثورة المعلومات التي كسرت احتكار الإعلام ولكنه باق إلى حد ما. ثم أليست الديمقراطية هي التي مكنت أصحاب النفوذ واللوبيات من السيطرة على مجريات الأمور في بلد كالولايات المتحدة؟ ألم نكتوِ نحن المسلمين ببعض هذه اللوبيات كلوبي صناع السلاح واللوبي الصهيوني؟[ك] إن هناك من يصرخ في الغرب للنظر في التجربة الديمقراطية وتصحيح مسارها، فأرجو ألا نكتفي نحن بالنقل والمتابعة للتجربة القائمة حذو القذة بالقذة. كيف يرضى العقلاء بنقل تجارب بشرية بحلوها ومرها كما نسب إلى بعض المستغربين من أبناء المسلمين؟
ثم إن الديمقراطية في الحقيقة أقرب إلى الآلية منها إلى المرجعية. إن المرجعية في الغرب هي الليبرالية، وتنازعها المرجعية الدينية المسيحية، والتي يتصاعد دورها في هذه الأيام سيما في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجناح المتصهين منها. إنه لا بد من مرتكز تدور الديمقراطية في فلكه، وإلا فالانجراف في كل اتجاه ممكن جدًا في تلك الممارسة. إننا ينبغي أن ندفع في بلادنا المسلمة باتجاه حكم شوري تكون الشورى فيه ملزمة إلا في صلاحيات مقررة للرؤساء كما هو الحال في كل العالم. وهذا الحكم مرجعيته إسلامية.
يبقى أننا مهما أحسنا في عرض بضاعتنا، فلا ننتظر أن يقتنع كل الناس بحجتنا، بل سيبقى توجس بعضهم من الشريعة وأهلها نابعًا من شدة جهالتهم أو خوفهم مما قد يحدثه تطبيقها من عودة الروح لهذا الجسد المريض، والذي قد ينتفض بعدها ليسترد حقوقه المسلوبة ويدفع يد البغي والعدوان عنه وعن أرضه وماله وعرضه. هؤلاء قد لا يجدي معهم شيء، وقد تبقى غصصهم في حلوقهم وتستمر حملتهم على الشريعة حسدًا من عند أنفسهم، وساعتها يقال “فَٱصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ.” [الأعراف: 87]
قال أبي بن حمام المري: تمنى لي الموت المعجل خالدٌ … ولا خير فيمن ليس يعرف حاسده
وصلى الله على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين
[أ] مسلم عن عن جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ
([ب]) فهم يقدمون إشارة النص على دلالته، لأن الإشارة مأخوذة من النظم فكانت من المنطوق المقدم على المفهوم. والجمهور على تقديم دلالة النص لأنها تفهم لغة منه، أما الإشارة فلا يدركها كل أحد لأنها تفهم من اللوازم البعيدة. انظر «أصول البَزْدَوِيّ» (1/120).
([ج]) انظر «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لمصطفى الخِنّ (ص127).
[د] أخرجه ابو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه. «سنن أبي داود دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» (4/109).
[ه] «سنن البيهقي الكبرى، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 1414 هـ » كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي (10/116).
[و] «صحيح البخاري، بيروت: دار ابن كثير واليمامة، 1407 هـ. – الثالثة» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2/959)، «صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي» كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات (3/1343).
[ز] «المُوافقات للشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز. – بيروت: دار المعرفة.» (2/217)
[ح] إعلام الموقعين عن رب العالمين، 3 /78: دار الجيل – بيروت – 1973.
[ط] ديمقراطية. (2011, أغسطس 30). ويكيبيديا, . 21:33, سبتمبر 21, 2011.
[ي] انظر كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري فإنه نفيس ومهم.
[ك] انظر (بالإنجليزية) كتاب: The Best Democracy Money Can Buy, Publisher: Pluto Press | 2002