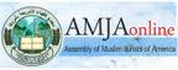الحمد لله رب العالمين،
قسَّم الإمام تقي الدين ابن تيمية التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولم نسمع أن أحدًا من معاصريه أو ممن بعدهم أنكر عليه هذا التقسيم، على الرغم من أن له خصومًا من أكابر أهل العلم، وكانوا لا يألون جهدًا في الرد عليه فيما ظنوه خطأً منه. فعجيب أن يكونوا غفلوا عن ذلك الأمر العظيم، وتنبه له بعض المعاصرين ممن هم أقل علمًا وفهمًا ودينًا.
فإن كان التقسيم مذمومًا لكونه حادثًا لم يقل به الصحابة، فمن من الصحابة قسَّم التوحيد إلى: وحدانية الذات، والصفات، والأفعال، كما فعل علماء الأشاعرة؟ نحن نؤمن بالتقسيمين، فالتقاسيم لا يُشترط فيها التوقيف، كما هو متقرر. وقد يُقسَّم الشيء الواحد بعدة تقسيمات باعتبار اختلاف المَقسَم أو الجهة المعتبرة. وهناك تقسيم عقلي، وتقسيم استقرائي. وتقسيم الإمام تقي الدين استقرائي صحيح، شهد له كبار علماء الأشاعرة والماتريدية، كما سنبيِّن.
فإن كان الإشكال في تطبيق بعض الناس له، فليُحرَّر إذًا محل النزاع، وأنه ليس في صحة التقسيم، بل في سوء استعماله، إن ثبت ذلك. وهل توصَّل الإمام ابن تيمية بتقسيمه إلى تكفير المسلمين؟ ألا يُقِرّ بعض من أنكر عليه هذا التقسيم بأنه بعيد عن ذلك؟ وهل كفَّر المعتزلة منكري الصفات، مع جعله توحيد الأسماء والصفات قسمًا ثالثًا؟ وهل كفَّر البكري، الذي خالفه في حكم الاستغاثة بعد أن أقام الحجة عليه؟ وهل الاستغاثة كلّها كفر أكبر عنده؟ أم أنه جعل بعضها ذريعة إلى الشرك؟ ومعلوم أن الذريعة إلى الشيء ليست هي الشيء نفسه. أليس هو القائل: “والذي نختاره أن لا نكفِّر أحدًا من أهل القبلة”؟[1] وهناك ما لا يُحصى من عباراته التي تدل على أنه من أبعد الناس عن التكفير بغير حق. فإن أغلظ في العبارة أحيانًا انتصارًا لحق يراه، أفلا يُحمَل المجمل من كلام العلماء على المفصَّل؟ وهل كان أوّل من شدّد في العبارة؟ أولم يسبقه إلى ذلك كبار العلماء من جيل الصحابة فمن بعدهم؟ وهل داعش أولى به من تلاميذه وأجيال من كبار العلماء تأثروا به وأفادوا منه؟ وهل السفاح ابن تومرت أولى بالإمام الغزالي لدعواه الطلب عليه من ابن العربي وغيره من الأكابر؟ وهل التكفير ظاهرة جديدة في أمتنا؟ وهل المسؤولية الأكبر عنه تقع على كاهل الموروث الديني أم على الاحتقان السياسي والاجتماعي؟
أما من زعم أن التقسيم خطأ، فدعنا نناقشهم بكتاب الله وسنة رسوله، والعقل، وتقريرات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، من الموافقين والمخالفين، بل من علماء الأشاعرة والماتريدية الذين يعظِّمهم المشَنِّعون على هذا التقسيم.
أولًا: من كتاب الله:
قال الله تعالى عن المشركين: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: 87]، وهنا يُقرّون بأن الخلق لله وحده.
وقال: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]، وهنا يُقرّون بأنه مع كونه متفرِّدًا بالخلق، فهو كذلك متفرِّد بالملك وبالتدبير.
وقال: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس: 18]، وقال: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: 3]، فهنا يُبيِّنون أن عبادتهم لتلك الآلهة لا تعدو أن تكون استشفاعًا إلى الله بهم، ولم يجادلوا في أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم، بل زعموا أنهم إن عبدوهم شفعوا لهم عند الله. وهل بدأ الشرك في الأمم إلا بذلك؟
وهل هذا فهمنا وحدنا؟ هذا إمام المفسِّرين قاطبة، الطبري، يقول: “ولكنّ الله جلّ ثناؤه قد أخبرَ في كتابه عنها أنها كانت تُقر بوحدانيته، غير أنها كانت تُشرك في عبادته ما كانت تُشرك فيه، فقال جل ثناؤه: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: 87]، وقال: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ…﴾.” [2] ونقل عن ابن عباس: “وإنما عَنى تعالى ذكره بقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا ربّ لكم يرزقكم غيره.” [3]
وقال الطبري كذلك في إثبات أن من المشركين من لم يعتقد في الأصنام أنها تنفع وتضر:
“وقوله: ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾، يقول: أو تنفعكم هذه الأصنام، فيرزقونكم شيئًا على عبادتكم لها، أو يضرّونكم، فيعاقبونكم على ترككم عبادتها، بأن يسلبوكم أموالكم، أو يهلكوكم، أو يهلكوا أولادكم. ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾.
وفي الكلام متروكٌ، استُغني بدلالة ما ذُكر عمّا تُرِك، وذلك جوابهم لإبراهيم عن سؤاله إياهم: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ [الشعراء: 72–73].
فكان جوابهم له: لا، لا يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا ينفعوننا، ولا يضرّوننا. ويدلّ على أنهم بذلك أجابوه قولهم: ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾، وذلك رجوع عن مجحود، كقول القائل: ما كان كذا، بل كذا وكذا.” [4]
والآلوسي يؤكِّد هذا المعنى فيقول:
“وقد يُقال: إنهم أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الربوبية، وبالجملة الثانية إلى توحيد الألوهية، وهما أمران متغايران، وعبدة الأوثان لا يقولون بهذا، ويقولون بالأول: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: 25، الزمر: 38]، وحكى سبحانه عنهم أنهم يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وصح أنهم يقولون أيضًا: “لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك.”” [5]
فإذا كان بعض المشركين قد أشركوا في الربوبية أو في بعض أركانها، أو اعتقدوا النفع والضر في آلهتهم استقلالًا أو تبعًا، فهل يلزم أن الشرك فيهم كان لونًا واحدًا؟ وهل ينقض ذلك دلالة هذه الآيات وفهم أهل العلم لها أن منهم من أقر بالربوبية ولم ينفعه ذلك من غير إفراد الله بالعبادة؟ أوليس الله يحتج عليهما بالتلازم بينهما في طول القرآن وعرضه؟
ومن سنة رسول الله:
ما أكثر ما سمّى رسول الله ﷺ أنواعًا من المحرّمات شركًا، وبغض النظر عن كونها من الشرك الأكبر أو الأصغر، فالعبرة أنها تجرح التوحيد. فأي نوعَيهِ تجرح؟ لا يظهر في أكثر هذه الأخبار إنكارُ الربوبية، فانظر فيها إن شئت وتأمّلها.
ومن العقل:
إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية. لذلك جاز عند الانفراد التعبير بـ “الرب” عن “الإله” والعكس، وهو كثير في القرآن؛ فالربّ الحق هو الإله الحق، والعكس صحيح.
وقد قال الإمام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية:
“ويُحقّق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية؛ وإن كانت الإلهية تتضمّن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختصّ بمعناه عند الاقتران، كما في قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾، ﴿إِلَٰهِ النَّاسِ﴾، وفي قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. فجمع بين الاسمين: اسم الإله، واسم الرب؛ فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يُعبد، والربّ هو الذي يُربي عبده فيُدبّره.” [6]
لكن هل التلازم العقلي بين توحيد الألوهية والربوبية يعني أنهما لا ينفصمان في الممارسة؟ كلا؛ فكثير من المشركين، كما بيّن القرآن، أقرّوا بتفرّده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، ومع ذلك عبدوا غيره، والقرآن من أوّله إلى آخره يحتجّ عليهم بهذا التلازم. لكن منهم من تابع الآباء ومنهم من منعه من الإيمان الحرص على جاهه ودنياه ومنهم من منعه الكبر وغير ذلك من المهلكات كثير.
قال الله: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 14].
إنه لا يعلمهم بأنه فاطر السماوات والأرض والرزاق الذي يطعمهم، بل يحتج عليهم بذلك.
ودَعْ عنك الخلاف في مسمّى العبادة، فماذا لو قال إنسان: “أنا أعبد هذا الولي أو الجني ليقرّبني إلى الله الواحد”؟ أنقول: إنه مؤمن، لإثباته تفرد الله بالخلق والملك والتدبير؟
وهل إبليس شكّ في ربوبية الله؟
ومن كلام العلماء:
قال العلّامة البَيْجُوري:
«﴿الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ﴾ يشير إلى تقرير توحيد الربوبية، المترتِّب عليه توحيد الألوهية، المُقتضي من الخلق تحقيق العبودية. وهو ما يجب على العبد أوّلًا من معرفة الله سبحانه وتعالى. والخلاصة: أنّه يلزم من توحيد المعبوديّة [أي الألوهية] توحيد الربوبية، دون العكس في القضيّة، لقوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، وقوله حكاية عنهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.”[7]
ما الفرق بين هذا وما يقرِّره الإمام تقي الدين؟
وقال العلّامة محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي:
“التوحيد توحيدان: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. فصاحب توحيد الربوبية يشهد قيومية الرب، فرق عرشه، يدبّر أمر عباده وحده، فلا خالق، ولا رازق، ولا معطي، ولا مانع، ولا محيي، ولا مميت، ولا مدبّر لأمر المملكة ظاهرًا وباطنًا غيره. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه، ولا يقع حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. وأما توحيد الإلهية، فهو أن يجمع همّته وقلبه، وعزمه وإرادته، وحركاته، على أداء حقه، والقيام بعبوديته.” [8]
ما الفرق بين هذا وما يقرِّره الإمام تقي الدين؟
وقال العلّامة ملا علي القاري الحنفي:
“والحاصل: أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية، دون العكس في القضية، لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: 38]. بل غالب سور القرآن وآياته متضمّنة لنوعي التوحيد، بل القرآن من أوّله إلى آخره في بيانهما.”[9]
ما الفرق بين هذا وما يقرِّره الإمام تقي الدين؟
وقال العلّامة عبد الفتّاح أبو غدة:
“هذا تقسيم اصطلاحي، استقاه العلماء ممّا جاء في الكتاب والسنّة، في مواضع لا تُحصى، ممّا ردّ الله تعالى به على المشركين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. وفي سورة الفاتحة، التي يقرؤها المسلم في صلاته مرّات كلّ يوم، دليل على ذلك:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.” [10]
ما الفرق بين هذا وما يقرِّره الإمام تقي الدين؟
وهل زعم الإمام تقي الدين ابن تيمية أن مشركي العرب كانوا لونًا واحدًا؟ ألم يُبيِّن أنواع شركهم في رسالته: ” قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق”؟
وهل زعم أنهم حققوا توحيد الربوبية؟ أم غاية ما ذكره أنهم مُقِرُّون بها؟
وهل قال إن المرء قد يخلص له أحد نوعي التوحيد دون الآخر؟
انظر – عفا الله عني وعنك – إلى كلامه الرائق في فهم معاني القرآن وإشاراته، في إثبات نوعَي التوحيد: العلمي والعملي. قال – قدّس الله سرّه :
“فدلّ على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فهذا تفصيل لقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهذا يدلّ على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يُعبد أحد سواه.
فقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة، والخوف، والرجاء، والأمر، والنهي.
وقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إشارة إلى ما اقتضته الربوبية: من التوكل، والتفويض، والتسليم؛ لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضًا معنى الربوبية والإصلاح. والمالك: هو الذي يتصرّف في ملكه كما يشاء.
فإذا ظهر للعبد من سرّ الربوبية أن الملك والتدبير كلّه بيد الله تعالى، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فلا يرى نفعًا ولا ضرًّا، ولا حركة ولا سكونًا، ولا قبضًا ولا بسطًا، ولا خفضًا ولا رفعًا، إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه، وقابضه وباسطه، ورافعه وخافضه.
فهذا الشهود هو سرّ الكلمات الكونيّات، وهو علم صفة الربوبية.
وأما الأول، فهو علم صفة الإلهية، وهو كشف سرّ الكلمات التكليفيّات؛ فالتحقيق بالأمر والنهي، والمحبة، والخوف، والرجاء، يكون عن كشف علم الإلهية.
والتحقيق بالتوكل، والتفويض، والتسليم، يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.
فإذا تحقّق العبد لهذا المشهد، ووفّقه الله لذلك، بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول، فهو الفقيه في عبوديته؛ فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين…
ومن غاب بهذا المشهد عن المشهد الأول، ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كلّ نفس بما كسبت، وتصرفه فيها، وحكمه عليها؛ فرأى الأشياء كلّها منه، صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القادرة، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطّل الأمر والنهي والنبوات، مرق من الإسلام مروق السهم من الرمية.
وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه، وغيّب عقله لقوّة سلطانه الوارد، وضعف قوة البصيرة عن أن يجمع بين المشهدين؛ فهذا معذور منقوص، إلا من جمع بين المشهدين: الأمر الشرعي، ومشهد الأمر الكوني.” [11]
فهل لاحظت – عفا الله عني وعنك – اعتذاره عمّن غلبه شهود الربوبية عن مراعاة بعض حقوق الألوهية؟
وانظر – عفا الله عني وعنك – إلى إدراكه الدقيق لكل ما يتعلّق به المشركون من وجوه الشرك وأقسامه. قال – رحمه الله :
“وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: 22]، ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: 23].
فنَفى عما سواه كلَّ ما يتعلّق به المشركون: فنفى أن يكون لغيره ملك، أو قِسْطٌ من الملك، أو أن يكون عونًا لله. ولم يبقَ إلا الشفاعة، فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أَذِن له الرب، كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255].”[12]
فأصول الشرك هي اعتقاد أحد هذه الأمور الأربعة: الملك، أو الشركة فيه، أو المعاونة عليه، أو الشفاعة بغير إذن.
فمن وقع في صرف شيء من حقوق الألوهية لغير الله، مع أن قلبه فارغ من هذه الأربعة، فقد أتى عظيمة من العظائم، واقتحم بابًا من أعظم أبواب الشرّ وذرائع الشرك، يوشك أن يُوقعه في الشرك الأكبر، فينزلق فيه متى وقع في قلبه شيء من هذه الأربعة، التي سمّاها في الرد على المنطقيين: “الأقسام الممكنة” للمشرك الذي يدعو غير الله، ويرجوه، ويخافه،[13] وسمّاها في الجواب الصحيح: “جميع وجوه الشرك.” [14]
لكن بقيت بقيّة:
لماذا يُكفِّر العلماءُ الواقعَ في أمورٍ كثيرةٍ أخرى، كسبِّ الله تعالى ورسوله ﷺ، وإنكارِ المعلومِ من الدين بالضرورة، والسجودِ للصنم، واعتقادِ حلولِ الله في مخلوقاته، أو الشكِّ في البعث أو إنكاره، أو إنكارِ علمه بالجزئيات، إلى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في أبواب الردّة؟
وهل هؤلاء يُسلَّم لهم توحيدهم؟!
وماذا لو قال إنسان: أنا أُقِرّ بتفرُّد الله بالخلق، والملك، والتدبير، والنفع، والضر، وأنه لا نِدَّ له، ولا ظهير، ولا شفيع إلا بإذنه، ولكنّي أعبد هذا الولي ليُقرّبني إلى الله؟!
ولماذا كفر إبليس، مع اعتقاده بربوبية الله؟
وهل حقًّا لا يكون الكفر إلا بخللٍ في هذه الأصول الأربعة للشرك؟ فمن اعتقد في ربوبية الله، فلا سبيل إلى تكفيره؟!
يُجيب الإمام الرازي – رحمه الله – فيقول:
“أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كُفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهًا للعالَم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تُقرّبهم إلى الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام.” [15]
لاحظ قوله: “سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهًا للعالَم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تُقرّبهم إلى الله تعالى.”
وليس لنا بعد إجماع الأنبياء مقال!
فالحقّ الذي لا مرية فيه: أن المرء لا يسلم توحيده بمجرد براءته من اعتقاد أصول الشرك الأربعة، حتى يُقِرَّ بالإلهية، واستحقاق الله وحده للعبادة، التي هي تمام الذل (والطاعة منه) مع تمام الحب. ومن طاعته: تصديق رسوله ﷺ وما جاء به، وتعظيمهما، وانقياد القلب في الجملة لذلك كلّه.
وأما إبليس، فلم يكن موحّدًا بعد ردّه أمر الله تعالى.
وأما من عبد غير الله، فليس بموحّد، “سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهًا للعالَم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تُقرّبهم إلى الله تعالى.”
ونحن لا نرى كفر كل من استغاث بغير الله، إلا لأن أكثرهم – ولا سيما من أهل السنّة – يُنكرون أصول الشرك، ويُقِرُّون بانفراد الله بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة. ولكن لهم تسويغات باطلة نجيب عليها في مقالٍ آخر، إن شاء الله.
بقي أن يُقال: إن من غُلاة الصارفين لأنواع العبادات لغير الله، والمستغيثين بهم فيما لا يقدر عليه سواه، ولا تُعلم قدرتهم عليه حِسًّا ولا وحيًا—منهم من هو واقعٌ بالفعل في شيء من شرك الربوبية.
يا أحبابي، ما الذي يغيظ بعضنا من لفت الانتباه إلى أهمية إفراد الله بالعبادة، وتحفيز الهمم إلى ذلك؟ وكيف نُصدِّق من يلهج بفناء الشهود، ثم ينصِب بين الله وعباده الوسائط؟ إن غلا بعضُنا في التكفير، فصوِّبوا الغلو، لكن “لا يجرمنّكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا.”
يا إخواني من جميع المذاهب والخلفيات السُّنِّيَّة، إن العصبية لم تُفسد علينا عقولنا وتصوراتنا فحسب، حتى صرنا في مؤخرة الأمم، بل أفسدت أخلاقنا وديننا. ﴿اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَى﴾.
وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
[1] درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م، ١: ٩٥.
[2] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، بدون تاريخ، ١: ٣٧١.
[3] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، بدون تاريخ، ١: ٣٧٠.
[4] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، بدون تاريخ، ١٩: ٣٦٢.
[5] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، ٨: ٢٠٩.
[6] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ١٠: ٢٨٣.
[7] شرح جوهرة التوحيد، الباجوري، تحقيق محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان، راجعه عبد الكريم الرفاعي، ص: ٩٧.
[8] تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٩: ٢٧٦.
[9] شرح الفقه الأكبر، علي القاري، تحقيق علي محمد دندل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م، ص: ٢٢.
[10] كلمات في كشف أباطيل وافتراءات، عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ، ص: ٣٧.
[11] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ١: ٩٠.
[12] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ٧: ٧٧.
[13] الرد على المنطقيين، ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، ص: ٥٢٩.
[14] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، دار العاصمة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م، ٣: ١٥٤.
[15] مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠ هـ، ١٤: ٣٥٠.